الدكتور محمد أمحدوك (°)
الملخّص:
يمثّلُ المنجزُالشّعريُّ الأمازيغيّ أفقاً مفتوحاً على نسيج التّاريخ والحياة الجماعيّة للمغاربة، ويشكّل عبر تجلّياته المختلفة احتفاءً بالطّبيعة والارتباط العضويّ بنواميسها وطقوسها الكُبرى. ويجسّدُ التّعدّد الّذي يسم مصطلحيّته فسيفساء البيئة الأمازيغيّة بخصوبتها وعذوبتها… ولذلك فإنّه يتوغّل في متعة التّعبير وتمجيد أسباب الحياة ومعانقة أشيائها ورُموزها.
غير أنّ أهمّ ما يلفتُ انتباه الباحث اللّسانيّ، وهو يروم إنجاز بحثٍ علميٍّ في مُصطلحيّة الشّعر الأمازيغيّ المغربيّ، هو ندرة الدّراسات والأبحاث الّتي تناولت هذا المستوى؛ إذ انكفأت في أغلبها عن دراسة هذا الجانب، ولم تعالجه بشكلٍ مستفيضٍ أو كافٍ، يستجلي مفارقاته، ويحدّد تمفصلاته الكبرى، رغم الأهمّية الكبيرة والمكانة الأساس الّتي يحتلّها في مختلف الدّراسات اللّغويّة والأدبيّة الأمازيغيّة الحديثة… فلم يتمّ التّدقيق، لأسبابٍ لسانيّةٍ وجغرافيّةٍ وإيديولوجيّةٍ، في الكثير من المصطلحات الّتي قد تبدو، للوهلة الأولى، دالّةً على المعنى ذاته.
والحال أنّ هناك اختلافاتٌ لهجيّةٌ ودلاليّةٌ وتقنيّةٌ شاسعةٌ بينها. ويتعلّق الأمرُ، هنا، بمفاهيم مثل: “تَامْدْيَازْتْ”، و”إِزْلِي”، و”تَايْفَّارْتْ”، و”تَامَاوَايْتْ”… إذ غالباً ما يقتصر البحث على المفهوم الأوّل دون تحديد المصطلحات المجاورة له، ولا إبراز أوجه الاختلاف والائتلاف بينها. فيواجهُ الباحث في اللّسان الأمازيغيّ عامّةً، وفي المصطلح الشّعريّ خاصّةً، فوضىً مصطلحيّةً وخلطاً مفاهيميّاً كبيراً. ممّا يزيد من صعوبة البحث في هذا الموضوع، ويحدّ من علميّة النّتائج الّتي يتوصّل إليها. ومن ثمّ تأتي هذه الورقة لتسلّط الضّوء على بعض مقوّمات البنية المصطلحيّة للشعر الأمازيغيّ، ومعالجة بعض القضايا الدّلاليّة والتّداوليّة المرتبطة بها لهجيّاً وجغرافيّاً وإثنولوجيّاً…
الكلمات المفاتيح: المصطلحيّة – الشّعر الأمازيغيّ المغربيّ – الثّراء المعجميّ – الفوضَى المصطلحيّة – التّعدّد اللّهجيّ.
تقديم:
يعدّ الشّعر أقوى الأجناس الأدبيّة وأعرقها في تاريخ الفكر الأمازيغيّ، وأقدمَ الفنونِ الأدبيّة وأكثر وسائل التّعبير انتشاراً وتداولاً في المجتمع الأمازيغيّ (مولودي، 2006، صفحة 71). فهو ديوان الأمازيغيّين (إِيمَازِيغْنْ) الّذي يعبّر عن همومهم، ويترجم أحاسيسهم، ويصوّر أنماط عيشهم. وفيه يصوغُ الشّعراء (“إِنْشَّادْنْ”، أو “إِمْدْيَازْنْ”، أو “إِمَارِيرْنْ”) عواطفهم وانطباعاتهم وأفكارهم وتصوّراتهم للحياة في قالبٍ فنّيٍّ يجمع بين جزالة الكلمة، ورصانة المعنى، وعمق الدّلالة، وبلاغة الأداء، وجماليّة اللّحن. ومن ثمّة تتمتّع الإنجازات الشّعريّة الأمازيغيّة في المغرب بثراءٍ كبيرٍ من حيثُ اتّساع مجال ممارستها وتنوّع وسائل أدائها، إنْ على مستوى توظيف اللّغة أو استثمار عناصر التّخييل أو التّصوير.
ومن هذا المنطلق، كان للشّعر الأمازيغيّ في المغرب وزنُهُ وقيمتُهُ التّاريخيّةُ الكبيرةُ عبر العصور؛ إذ ازدهر ولقي عنايةً كبيرةً من المغاربة قبل دخولهم الإسلام؛ حيثُ “ثبتَ أنّهم كانوا ينظمون الملاحم على عهد الرّومان، ويسجّلون فيها بطولاتهم ويمتدحون بما عندهم من أمجادٍ” (الجراري ع.، 1971، صفحة 137). وقد استمرّ هذا الازدهار حتّى بعد مجيء الإسلام؛ حيث عثر محمد المختار السّوسيّ على ملحمةٍ تصف فتح إفريقيّة، وتشيد بشهامة القائد عبد اللّه بن جعفر (السّوسيّ، 1959، صفحة 120).
وحتّى بعد قرونٍ من انتشار الدّين الإسلاميّ في المغرب، كان للشّعر الأمازيغيّ دورٌ وتأثيرٌ كبيرٌ على النّفوس؛ وقد ذكر ابن خلدون أنّه احتلّ في عصره مقام الصّدارة حتّى في أزمنة الحروب: “يتقدّم الشّاعر عندهم أمام الصّفوف ويتغنّى فيحرّك بغنائه الجبال الرّواسي، ويبعث على الاستماتة…” (ابن خلدون، 1965، صفحة 258). واكتسى خلال مرحلة الاستعمار طابع الإثارة والحماسة لاسترجاع الأرض من المستعمر، بينما عالج بعد الاستقلال جلّ القضايا الثّقافيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة…
ورغم الحضور الّذي تحظى به هذه الثّروة الشّعريّة الأمازيغيّة في الذّاكرة المغربيّة، واشتغال مجموعةٍ من الشّعراء على بعضها في إنتاجاتهم الإبداعيّة، وإقدام العديد من الباحثين على استثمارها مصطلحاً وإيقاعاً ودلالةً في بحوثهم الأكاديميّة، إلّا أنّها ما تزالُ أحوج إلى تضافُر الجهود لتدوينها ودراستها دراسةً علميّةً رصينةً، باعتبارها جزءاً لا يتجزّأ من تاريخ المغرب؛ إذ يمكن من خلالها فهم الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسّياسيّة والثّقافيّة لساكنة هذا المجال الجغرافيّ.
كما يطرح الوضع الرّاهن للقصيد الأمازيغيّ ضرورة البحث في الشّعر القديم، وذلك عبر اختراق مجاهل الأصقاع للتّنقيب عن هذا التّراث النّفيس، وتهيئة الأسباب الّتي تضعه في المكانة السّامقة الّتي يستحقّها. في الوقت الذي أضحتْ تعرف فيه السّاحة الأدبيّة الأمازيغيّة ديناميّةً كبيرةً تجلّت معالمها في تنامي الوعي بأهمّية الفعل الإبداعيّ الشّعريّ بالأمازيغيّة، والرّغبة في تحقيق نوعٍ من التّراكم لتثبيت أسسه ومبادئه، وتجاوز وصمة الشّفويّة المرتبطة به وبالأدب الأمازيغيّ عامّةً.
ومن ثمّة تحاول هذه الدّراسة الوقوف على بعض الملامح الأساسيّة المميّزة للبنية المصطلحيّة للشّعر الأمازيغيّ المغربيّ من خلال استقصاء صنوفه الكبرى في جانبين من التّنوّعات اللّهجيّة الأكثر انتشاراً في المغرب: الأطلسيّة والسّوسيّة، والإجابة عن الإشكاليّة: “أَ التَّعَدُّدُ الَّذِي يَسِمُ مُصْطَلَحِيَّةَ الشِّعْرِ الْأَمَازِيغِيِّ الْمَغْرِبيِّ ثَرَاءٌ مُعْجَمِيٌّ أَمْ فَوْضَى مُصْطَلَحِيَّةٌ؟”، فضلاً عن الأسئلة الفرعيّة الآتية:
-
ما مقوّمات البنية المصطلحيّة للشّعر الأمازيغيّ؟
-
كيف يتحدّد مفهوم الشّعر الأمازيغيّ الحديث؟
-
ما أنماط القول الشّعريّ الأمازيغيّ بالأطلس والسّوس؟
-
اَلْمُوَجِّهَاتُ الْمَفْهُومِيَّةُ لِلدِّرَاسَةِ
لَمّا كانت “المُصطلحَات مَفاتيح العُلوم” (السّكاكي، 2000، صفحة 150)، سنحَاول بدايةً تَحديد المفاهيم المحوريّة الّتي تتأسّس عليها بنية هذه الدّراسة، وهي “المصْطلح” و”علم المصْطلح”، باعتبارهما الفنارين اللّذين يمكن الاسترشاد بهما في غياهبها، و”الشّعر الأمازيغيّ التّقليديّ”، بكلّ الغموضِ الّذي يلفّه، والّذي يعود، في جانبٍ كبيرٍ منه، إلى الخَلْط بين مصطلحاتٍ كثيرةٍ تحيل عليه، باعتبارها دوالّ مدلولٍ واحدٍ، مثل: “أَمَارْݣ” و”أَوَالْ” و”تَامْدْيَازْتْ”… ممّا يفترض توضيحها وتحديدها دلاليّاً ومُصطلحيًّا، واستيفاء جميع معالمِها وتفاصيلها، كما بسطتها بعض المعجمات والدّراسات المتخصّصة.
-
مَفْهُوما الْمُصْطَلَحِ – عِلْم الْمُصْطَلَحِ
لا مِرْيَةَ أنّ إنتاجيّة المصطلح في أيّ فترةٍ من فترات حياة اللّغة هو علامةٌ صحّيّةٌ جليّةٌ لأنّها دليلٌ على أنّ تلك اللّغة واقعةٌ في خضمّ احتكاك الحضارات، تواجه بقدمٍ راسخةٍ حوار الثّقافات في أعمق مدلولاته، كما أنّها أيضاً إفرازٌ للمعرفة السّائدة وأداةٌ لها في الوقت نفسه. إذْ لا يمكن أن يتحدّث عن العلوم والفنون والآداب بغير أنساقها المصطلحيّة. فما المقصود بالمصطلح؟ وما خصائصه؟ وما علم المصطلح؟ وما وظائفه بالنّسبة للّغة الأمازيغيّة؟
-
اَلْمُصْطَلَحُ لُغَةً وَاصْطِلَاحاً
المصطلح في اللّغة مصدرٌ ميميٌّ من الثّلاثيّ المزيد (اصطلح)، وأصله من الفعل الثّلاثيّ (صلح)، بمعنى “تَوَافَقَ”. وقد يكونُ أقدم من استخدم هذا الفعل في المجال العلميّ هو بشر بن المعتمر (ت. 210ه) في سياق حديثه عن بلاغة المتكلّمين واختصاصهم ببعض الألفاظ الّتي لا يعرفها غيرهم، وذلك في صحيفته الشّهيرة الّتي رواها الجاحظ، حيث يقول: “ولأنّ كبار المتكلّمين ورؤساء النّظّارين كانوا فوق أكثر الخطباء، وأبلغ من كثير من البلغاء، وهم تخيّروا تلك الألفاظ لتلك المعاني، وهم اشتقّوا لها من كلام العرب تلك الأسماء، وهم اصطلحوا على تسمية ما لم يكن له في لغة العرب اسم (…) ولذلك قالوا: العرض والجوهر…” (الجاحظ، 1977، الصفحات 138 – 139)
والمصطلح من النّاحية الاصطلاحيّة “عبارةٌ عن اتّفاق قومٍ على تسمية الشّيء باسمٍ ما ينقل عن موضعه الأوّل، وإخراج اللّفظ من معنىً لغويٍّ إلى آخر لمناسبة بينهما. وقيل: الاصطلاح: استعمال لفظٍ معيّنٍ بين قومٍ معيّنين” (الجرجاني، 1998، الصفحات 44 – 45). ويعرفه علماء المصطلح الحديث بأنّه مفهومٌ مفردٌ أو عبارةٌ مركّبةٌ استقرّ معناها، وحدّد استخدامها بوضوحٍ تامٍّ، وهو تعبيرٌ خاصٌّ ضيّقٌ في دلالته المتخصّصة، يتّفق عليه علماء علمٍ من العلوم أو فنٍّ من الفنون، وواضحٌ إلى أكبر درجةٍ ممكنةٍ، ويرد دائماً في سياق النّظام الخاصّ بمصطلحات علمٍ محدّدٍ (فهمي ، 2003، صفحة 18).
ولمّا كانت الكلمة هي عماد اللّغة العامّة، يستخدمها النّاس للتّعبير عن أشياء وأحداثٍ وانفعالاتٍ، وتتميّز بالتّعدّد الدّلاليّ والارتباط بالسّياقات المختلفة، كان المصطلح هو عماد اللّغة الخاصّة، يستخدمه الباحثون ليدلّ عندهم على أقسامٍ أو أصنافٍ أو حقولٍ. والمصطلح، رغم أنّه خرج من رحم الكلمة، وبقي بينهما حبلٌ سُرّيٌّ هو المعنى اللّغويّ، إلّا أنّه اتّخذ شخصيّةً مستقلّةً عنها، وأصبحت له ميزات تخصّه دون اللّفظ اللّغويّ العامّ؛ ومن ثمّة فالتّعميم، والتّعدّد الدّلاليّ، والإيحائيّة في الكلمة يقابلها على التّوالي الخصوصيّة، والأحاديّة الدّلاليّة، والذّاتيّة في المصطلح (ابن مراد، 1997، صفحة 32). وهذه السّمات من المباحث الّتي تدرسها “المصطلحيّة” (Terminologie).
وانطلاقاً من الأهمّية الواضحة الّتي أضحى يكتسيها هذا المفهوم، غدت دراسة المصطلحات ضرورةً ملحّةً، ومن أكثر المباحث اللّغويّة رواجاً في ساحة البحث اللّسانيّ الحديث، لا سيّما من زاوية رصد خصائصه ومميّزاته الشّكليّة والمضمونيّة. وقد تمّ في هذا السّياق تحديد حزمةٍ من الخصائص يُفترض في المصطلح أن يختصّ بها، كأن يكون:
-
لفظاً لا عبارةً ليسهل تداوله؛
-
محدِّداً للمعنى تحديداً تامّاً، ومبتعِداً عن الألفاظ الّتي لها معانٍ مشابهة في اللّغة العامّة؛
-
معروفاً، لذا يتلافى المصطلح الغريب المتشابه؛
-
مكتفياً بأدنى علاقةٍ تربطه مع المعنى اللّغويّ للكلمة؛
-
مبتعداً عن التّرادف المصطلحيّ؛
-
مهتمّاً بالمعنى قبل اللّفظ؛
-
متجنبّاً للألفاظ الّتي ينفر الطّبع منها لثقلها أو لفُحشها(قلعة جي و قنيبي، 1985م، الصفحات 22 – 23).
-
منتمياً إلى حقلٍ مفهوميٍّ قابل للضّبط.
-
عِلْمُ الْمُصْطَلَحِ واَلصِّنَاعَةُ الْمُصْطَلَحِيَّةُ
-
يقصد بعلم المصطلح أو المصطلحيّة Terminologie)) “العلم الّذي يدرس المصطلحات، ويبحث في طرق صياغتها، واستعمالاتها، ودلالاتها، وتطوّر أنساقها، وعلاقاتها بالعالم المدرك أو المحسوس” (Gouadec, 1990, p. 15). ومن ثمّة فإنّ موضوعه هو المصطلح من حيث مكوّناته، ونشأته ضمن نسيج اللّغة، فضلاً عن المفهوم من حيث تعريفه وخصائصه والعلاقة بينه وبين الشّيء المخصوص، وكيفيّة تخصيص المصطلح للمفهوم. وقد أجمل علي القاسمي ذلك حين عرّف المصطلحيّة (أو علم المصطلح) بأنّها العلم الّذي يبحث في العلاقة بين المفاهيم العلميّة والألفاظ اللّغويّة الّتي تعبّر عنها” (القاسمي ع.، 2008، صفحة 269).
وقد تولّد من صُلب المصطلحيّة جنينٌ يتمثّل في “الصّناعة المصطلحيّة” (Terminographie)، وهو «نشاطٌ علميٌّ يقوم بجرد المصطلحات، وبناء المعطيات المصطلحيّة، وتدبيرها، ونشرها» (Gouadec, 1990, p. 04).. كما يبحث في مناهج تقييس المصطلحات وتكنيزها، جمعاً وضمّاً، في المعجم المتخصّص كما هو الشّأن في المعجم العامّ([1]). وبالّسبة للّغة الأمازيغيّة، فقد وجدت نفسها في المغرب، على حين غرّةٍ، في سياقٍ استثنائيٍّ ألزمها ركوب تحدّي مواكبة الدّينامية السّريعة الّتي تعرفها حركيّة المصطلحات في العالم يوماً بعد يومٍ، حتّى تجد لها موطئ قدمٍ بين اللّغات الحيّة العالميّة. ولذلك ينتظر من المصطلحيّة أن تقوم بأدوارٍ رئيسةٍ في هذا الاتّجاه.
-
وَظِيفِيَّةُ الْمُصْطَلَحِيَّةُ الْأَمَازِيغِيَّةُ
يقوم علم المصطلح (Terminologie) في اللّغة الأمازيغيّة بوظائف عديدةٍ في مجالات مختلفةٍ، حيث يهتمّ بالموضوعات التّراثيّة، ويكشفَ عن أنساقها المفهوميّة من أجل تهيئة مجالها للاستثمار المعجميّ والمصطلحيّ. ونفصّل فيما يلي بعض الوظائف الّتي يمكن أن ينهض بها هذا العلم في مجاله، وهي وظائف تصبُّ في إرساء دعائم “اللّغة الجديدة”، والدعوة إلى عدم تركها عرضةً للابتذال والإسفاف، ومن بينها:
-
تأطير الطّرائق الّتي تسمّى بها المفاهيم والأشياء لحظة إبداعها أو اكتشافها، وتنظيم القول في المسافة الفاصلة بين اللّغات العامّة والخاصّة، والإسهام في الوقوف على المرجعيّات الّتي تحكّمتْ في المفاهيم لحظة تشكّلها.
-
الحدّ من الفوضى الّتي تضرب الموضوعات المصطلحيّة الحديثة، مثل: كثرة المترادفات، والاكتفاء بالتّمزيغ الصّوتيّ، والإبقاء على الصّورة الأجنبيّة للمصطلح… والعمل على ابتداع المصطلحات وفق شروطها في التّوليد والتّنميط والتّقييس استناداً إلى مقوّمات النّسق الصّرف- الصّوتيّ الأمازيغيّ، و”لو أنّ التّشويش الطّارئ على المصطلحات مرحلةٌ طبيعيّةٌ لا بدّ منها للانتقال من الاستهلاك إلى الإنتاج ومن الإتباع إلى الإبداع”(صاري، 2009، صفحة 140). ومن ثمّ فإنّ الانتقال لا يتمّ تلقائيّاً بل إتيمولوجيّاً وكرونولوجيّاً، فقد تمرّ قرونٌ على المصطلح ليستقرّ على الصّورة المؤثّلة الّتي تجعله في انسجامٍ مع المطالب الأكاديميّة والتّقنيّة، والمجال التّداوليّ الّذي يحتضنه، وهو ما يستنتج بالمراقبة والتّتبّع لتاريخ المصطلحات، وما تتعرّض له بالمراجعة والتّهذيب عبر التّاريخ (عبد العزيز، 2012، صفحة 144).
-
تتبّع المستجدّات المصطلحيّة بالدّراسة والتّقويم لتمزيغ اللّغة الفنّيّة والعلميّة والتّقنيّة، أي إضفاء الطّابع الأمازيغيّ على هذه اللّغة وإجراؤها حسب العادة والوضع الّذي دأب عليه الأمازيغ في تواصلهم وتخاطبهم وبيانهم للمعاني والدّلالات، وتوحيد الأمازيغ على قواعد موحّدة في الاستعمال، وتفادي ما يبعدهم عن التّواصل، فضلاً عن تجويد لغة الاصطلاح الجديد وترسيخها حتى تصير جزءا طبيعيّاً من ثقافة اللّغة الأمازيغيّة العامّة.
-
المساهمة في الدّيناميّة اللّكسيكوغرافيّة الّتي تعرفها اللّغة الأمازيغيّة في المغرب عبر تنظيم اللّغة العلميّة وتهيئتها بصناعة معجماتٍ متخصّصةٍ حسب طبيعة المتلقّين والمهتمّين وسائر المتخاطبين. لا سيّما أنّ هذه اللّغة لا تزالُ عالةً على الأعمال المعجميّة الكلاسيكيّة، ذات البعد اللّهجيّ والكولونياليّ، وتتضمّن موادّاً قاموسيّةً مرتبطةً بمعطياتٍ زَمكانيّةٍ وعقليّةٍ معيّنةٍ.
-
تحديد مقوّمات المصطلحات الأمازيغيّة في مجالاتها الأكاديميّة الخاصّة استنادا إلى معايير الشّيوع، والانتشار، والاقتصاد، والمواءمة، والإنتاجيّة؛ حيث يتطلّب مبدأ الشّيوع اختيار المصطلحات القصيرة والمعبّرة، ويقتضي مبدأ المواءمة مطابقة المصطلح للمفهوم لفظاً ومعنىً وبشكلٍ مباشرٍ، بينما يفرض مبدأ الإنتاجيّة على المصطلحات المولّدة أن تكون قابلةً لأن تشتقّ منها صيغٌ أخرى (صاري، 2009، صفحة 136).
-
تهيئة بنية اللّغة الأمازيغيّة علميّاً وتقنيّاً بالتّركيز على أبعادها النّسقيّة وتشّكلاتها التّنظيميّة وخصائصها التّركيبيّة والأسلوبيّة والتّعبيريّة، وضمان تأثيلها مبنىً ومعنىً إلى أن تترسّخ في مجالها وتتّضح في دلالتها التّواصليّة، وإبعاد مختلف الأشكال الالتباسيّة المحتملة (عبد العزيز، 2012، صفحة 143).
-
تأثيل المصطلحات الأمازيغيّة لتوضيحها وإزالة إبهامها أو التباسها من خلال الاستعانة بمصطلحات تتّفق مع نسقها اللّسانيّ ومجالها الاستعماليّ. خاصّةً أنّ العديد من المصطلحات تبقى عائمة الدّلالة إذا لم تقرن بترجمتها الأجنبيّة، وذلك عبر استثمار “القوّة التّداوليّة الأصليّة للّفظ في بلورة مدلوله الاصطلاحيّ، استشكالاً واستدلالاً”(عبد الرّحمان، 2006، صفحة 27).
ولكي يقوم هذا العلم بدوره كاملاً ينبغي أن يشمل التّمزيغ سائر المجالات العلميّة والتّقنيّة والفنّيّة، ليتمكّن من ترسيخ مبادئه ومعاييره التّوليديّة والتّنميطيّة والتّقييسيّة في شموليّةٍ، وتحقّق الانسجام التّعبيريّ في اللّغة العلميّة تفاعلاً وتناغُماً واطّراداً عبر تطبيق الآليّات المنهجيّة المعتمدة في هذا الإطار (عبد العزيز، 2012، صفحة 148). لا سيّما في ارتباطه بالفنّ الشّعريّ، القديم والحديث، بكلّ أبعاده الشّكليّة والمضمونيّة، قديمه وحديثه.
-
مَفْهُومُ الشِّعْرِ الْأَمَازِيغِيِّ بَيْنَ الْحَدَاثَةِ وَالتَّقْلِيدِ
لمّا كانت علاقة الشّعر بالمجتمع علاقةً جدليّةً تفرضُها مقوّمات النّشأة والتّطوّر داخل الوسَط الّذي ينتمي إليه الشّاعر، فقد فرضت التّحوّلات المجتمعيّة المستجدّة ظهور نوعٍ جديدٍ من الالتزام بالأوضاع الاجتماعيّة والسّياسيّة وانصهار الشّاعر في مجتمعه وانشغاله بقضاياه الّتي تعدّ جزءاً من يوميّاته الطّبيعيّة؛ ولو أنّ هذا المفهوم البسيط للالتزام قديمٌ قدمَ الأدبِ ذاته.
ولذلك، كان الشّاعرُ الأمازيغيّ الحديثُ، بحكم موقعه الاجتماعيّ والأدبيّ، مدعوّاً إلى متابعة هذه الصّيرورة ومعايشتها وتأريخها. ولعلّ أبرز ما حرّكه، إضافةً إلى وعيه بأهمّية الكتابة لحفظ الأدب الأمازيغيّ وتطويره، التّأكيد على إمكانيّة كتابة الأمازيغيّة، فضلاً عن تجاوُز التّقاليد الشّفويّة المتراكمة؛ إذ تشكّل كتابتها، في حدّ ذاتها، تحديثاً لها، ولهذا يُعَدُّ شعرُهُ في نصوصٍ كثيرةٍ تدويناً، بما هو نقلٌ للشّفويّ وتسجيلٌ كتابيٌّ له، أكثر ممّا هو كتابةٌ، بوصفها نمطاً إنتاجيّاً أدبيّاً لا يعتمد العفويّة والارتجاليّة والتّلقّي المباشر، بل يستدعي التّوقّف والتّأمّل والنّقد.
و يعرفُ هذا النّوعُ من الشّعر باصطلاحاتٍ كثيرةٍ، من بينها: “أَمَارْݣ اتْرَارْ”، و”تَامْدْيَازْتْ تَامَايْنُوتْ”، و”إِزْلَانْ يتْرَارْنْ”، و”أَسْفْرُو اَتْرَارْ”… وقد ظهر مع شعراء أمازيغ تأثّروا بالثّقافات الغربيّة من فرنسيّة وإسبانيّة وإيطاليّة وإنجليزيّة… بعد دراستهم لآدابها واطّلاعهم على قيمها الحضاريّة، وتأثّرهم بمذاهبها الفكريّة والفلسفيّة ومدارسها الشّعريّة من واقعيّة وانطباعيّة ورمزيّة… (أرجدال م.، 2016، الصفحات 53 – 55).
وإذا كان “أَمْدْيَازْ الكْلَاسيكيّ”، الّذي كان يسمّى “بُوغَانِيم” (صاحب القصبة) بالأطلس المتوسّط، يجوب القبائلَ ناظماً الشّعر، معرّفاً به وبقبيلته. وكانت قصيدتهُ “تَامْدْيَازْتْ” تتمفصلُ إلى أربعة مفاصل كُبرى متمايزةٍ ومتكاملةٍ:
-
اَلْمُقَدِّمَة: تحمل بعداً دينيّاً يمهّد به الشّاعر للموضوع من خلال: المناجاة، وطلب التّوفيق، والتّغنّي بقدرة اللّه وصفاته…؛
-
حُسْنُ التّخَلّص: مرحلةٌ تستغرق بيتاً واحداً أو أكثر يحرص فيها الشّاعر على الدّخول لجوهر الموضوع بشكلٍ سلسٍ وغير مباشرٍ.
-
اَلْمَتْنُ: هو الموضوع الأساس للقصيدة، ويتراوح غرضه بين المدح والهجاء والغَزَل والوصف والإخبار والحكمة وفن النّقائض… ويمثّل الجزء الهيكليّ والجوهريّ الّذي يبسط فيه الشّاعر قوله. وغالبا ما يتكوّن من مقاطع “إِڴــضْمَانْ (ج. أَڴــطُّومْ)”، تتضمّنُ لازمةً شعريّةً “تَالَّاسْتْ”، يردّدها المنشدون “إِرْدَّادْنْ” أو “إِمَالَّاسْنْ”.
-
الْخَاتمةُ (القفْلَة): نهايةٌ شبيهةٌ بالمقدّمة الدّينيّة، تكون غالباً امتداداً للمتن بحُكْمٍ أو استدراكٍ لما لم يُقله الشّاعر أو إحالةٍ إلى أمورٍ أخرى لم تختمر بعد لتكون موضوع إنتاجٍ شعريٍّ لاحقٍ.
فإنّ “أَمْدْيَاز الحديث” أو “أَنْضَّام” أو “أَنْشَّاد” لم يعد ذلك الشّاعر الجوّال بين مختلف ربوع الوطن، بقدر ما بات ملازماً للمجال الجغرافيّ الّذي ينتمي إليه، مستقرّاً بين أهله ومتفاعلاً معهم. ومن ثمّ بات الشّعر الأمازيغيّ الحديث يحيل على كلّ ما أنتَجه “أَمْدْيَازْ” من كلماتٍ ذات حمولاتٍ ومعانٍ رمزيّةٍ في لحظةٍ معيّنةٍ، وكتبه ليقرأه غيره، ويستفيد من تجربته الحياتيّة وخبرته الأدبيّة، ولعلّ أبرز ما تميّزَ بهِ انتقاله من الشّفاهَة إلى الكتَابة.
وقد انطلقت أغلبُ النّصوص الحداثيّة من تقليد القديم ومحاكاته، واجترار موضوعاتٍ اجتماعيّةٍ وتصوّراتٍ “كليشيهاتيّةٍ” كونيّةٍ ترى في الماضي أنموذجاً أخلاقيّاً مفقودًا وفي الحاضر انحطاطاً وتردّياً كبيراً، وهو ما ترتّب عنه جمود القارئ وعدم شعوره بالتّغيّر الجذريّ أو القطيعة بين ما كتب في بعض هذه القصائد، وما ألفته الأذن لدى الشّعراء الكلاسيكيّين، لا سيّما أنّ الاختلاف ليس واضحاً تماماً إلّا على مستوى بعض المضامين كمعالجة جوانب من القضايا الإنسانيّة والثّقافيّة، وفي مقدّمتها القضيّة الأمازيغيّة الّتي بات الوعي المرتبط بها يندرج في إطار خطابٍ حقوقيٍّ ونسقٍ فكريٍّ حداثيٍّ (أوسوس، 2010، صفحة 42).
ولذلك اشتغلت القصيدة الأمازيغيّة الحديثة على توظيف العقل للحدّ من جموح الخيال، فانفتحت على ما تقدّمه القصيدةُ المعاصرةُ من مساحاتٍ أخرى للتّعبير والتّناول، وما تتيحه من تكسيرٍ للأوزان، ولكن ليس بطريقةٍ فجّةٍ مبتذلةٍ.
ومهما كانت طبيعة الموضوعات الّتي عالجها القصيد الأمازيغي، التّقليديّ والحديث، فإنّ مصطلحيّته موشومةٌ بنوعٍ من التّعدّد، لذا يواجهُ الباحث في اللّسان الأمازيغيّ عامّةً، وفي المصطلح الشّعريّ خاصّةً، فوضىً مصطلحيّةً عارمةً وخلطاً مفاهيميّاً كبيراً. ممّا يزيد من صعوبة البحث في هذا الموضوع، ويحدّ من علميّة النّتائج الّتي يتوصّل إليها.
-
مُصْطَلَحِيَّةُ اَلشِّعْرِ الْأَمَازِيغِيِّ: فَوْضَى مُصْطَلَحِيَّةٌ أَمْ ثَرَاءٌ مُعْجَمِيٌّ؟
يَعرفُ مفهومُ الشّعرِ الأمازيغيِّ تعدّداً مصطلحيّاً كبيراً يصعبُ معه الوقوف على ماهيته وخصائص بنيته وأنماطه. ويرجع ذلك إلى اختلاف وتباين المصطلحات الّتي تحيل عليه من منطقةٍ جغرافيّةٍ إلى أخرى؛ لا سيّما أنّ مسلسل معيرة اللّغة الأمازيغيّة وتوحيدها في المغرب لا يزال في أولى حلقاته، ولم يستقرّ أواره بعد. أضف إلى ذلك الالتباس الّذي رافق مفهوم الحداثة الشّعريّة الأمازيغيّة، من حيث السّمات الشّكليّة والمضمونيّة المميّزة للنّمط الجديد وحدود اللّحظة الزّمنيّة الّتي وقع فيها الانتقال إليه.
-
اَلْاِصْطِلَاحَاتُ الْمُتَدَاوَلَةُ لِلشِّعْرِ الْأَمَازِيغِيِّ الْمَغْرِبِيِّ
يُعرف الشّعر في اللّغة الأمازيغيّة بالمغرب بمصطلحاتٍ عديدةٍ، منها:
-
أَمَارْݣْ (amarg): تعني في اللّغة الأمازيغيّة “الشّوق”، وهو ثالثُ القواتلِ فيها بعدَ العطش والجوع؛ فكما يمكنُ القول: “إِنْغَا-تْ فَادْ” (قَتَلَهُ الْعَطَشُ)، أو “إِنْغَا-تْ لَازْ” (قَتَلَهُ الجُوعُ)، يقول اللّسان الأمازيغيّ أيضاً: “إِنْغَا – تْ ومَارْݣ” (قَتَلَهُ الشَّوْقُ). وعلى هذا الأساس، فإنّ تسمية الشّعر في بعض مناطق تامازغا (البلدان الّتي تتكلّم ساكنتها إحدى التّنوّعات اللّسانيّة الأمازيغيّة) ب”أَمَارْݣْ” تعود إلى تغليب حمولة الشّوق على باقي الحمولات الّتي يحفل بها الشّعر الأمازيغيّ، سواء من حيث التّيمات أو الشّكل.
-
وبذلك تنحو هذه التّسمية نحو تعيين الكلّ بواسطة الجزء. وتعني “أَمَارْݣْ” أيضاً الكلام المبارك المُهْدَى، فهي مشتقّة من “أَرْݣْ”، ومنها “تَارَّاݣـْتْ”: الهديّة، و”تَامَارَاݣـتْ” (ج. تِيمْرَاݣْ): ملهمة الحبّ (امرأة غاية في الجمال). ولا يقصد به غالباً الشّعر بمضمونه التّقنويّ (الصّنعة)، بقدر ما يحيل على الشّعر باعتباره انفعالاً وجدانيّاً.
وبالعودةِ إلى المعجم الأمازيغيّ العربيّ، تتّخذُ “أَمَارْݣْ” معنى الشّعر الّذي يُتَغَنّى به (شفيق م.، 1991، صفحة 608). بينما تردُ “أَمَارْݣْ” أو “أَمَارْيْ” (ج. إِيمُورَايْ) في المعجم الأمازيغيّ-الفرنسيّ للأطلس المتوسّط بمعنى: الحبّ، والحزن، والكآبة، والهمّ، والحنين، والشّوق، والرّغبة العارمة في رؤية الوالدين أو الأصدقاء أو البلد، يقول الشّاعر:
كُولّْ مِيدّْنْ دَا-دْ شِيبْنْ، دَا-دْ مّْتْنْ (النّاسُ كُلُّهُمْ سَيَشِيبُونَ وَسَيَمُوتُونَ)
غَاسْ شْمّْ أَلِيخْرَى دْ وْمَارْيْ، أُورْ تّيلِيمْ شِّيبْ أُورْ تّْمْتَاتْمْ (إِلَّا أَنْتما أَيُّهَا الْمَوْتُ وَالشَّوْقُ لَا تَعْرِفَانِ صُعُوداً لِلشّيبِ وَلَا تَمُوتَانِ)
أَدْ – يْ – يْنْغِينْ يمُورَايْ نْ وَادَّا نَرَى (سَتَقْتُلُنِي أَشْوَاقُ مَنْ أُحِبُّهُ)
إِنْغَايِي وَانْسَا ݣْ سِّيخْ يْ وْحْبِيبْ ينُو سْ يغَالّْنْ (وَقَدْ آلَمَنِي الْمَوْضِعُ الَّذِي فَرَشْتُهُ لِلْحَبِيبِ بَيْنَ ذِرَاعايَ) (Taifi, 1990, p. 430)
-
تَامْدْيَازْتْ (tamdyazt): تطلقُ على الشّعر عامّةً، والقصيدة منه خاصّةً، وعلى المرأة الشّاعرة (ج. الشّواعر). وهي كلمةٌ مشتقّةٌ من الفعل “دِيْزْ”، الّذي انقرض في الكثير من التّنوّعات اللّغويّة الأمازيغيّة، وإن كان بعضها يحتفظُ بكلمة “أَمْدَازْ”، الّتي تعني الفرح الجماعيّ الكبير. و”أَمْدْيَا” هو المثال؛ يقول اللّسان الأمازيغيّ: “سْ – وْمْدْيَا”، بمعنى: “على سبيل المثال”. ومن ثمّ يغدو الشّعرُ الأمازيغيّ إبداعاً للتّشبيهات والكنايات والاستعارات. كما يتضمّن مفهوم “تَامْدْيَازْتْ” الفعل “إِدْݣْـزْ” الّذي يعني الرّقص والغناء والتّقليد والتّعميم.
ورغم شيوع هذا الفنّ الشّعريّ في معظم جهات المغرب بتحقيقاتٍ لفظيّةٍ مختلفةٍ: “تَامْلْيَازْتْ”، و”تَامْدْيَازْتْ”، و”تَامَلْـݣَـازْتْ”… فإنّ الأساس الدّلاليّ يظلّ واحداً. ومن النّاحية التّداوليّة، يتّجه هذا المصطلح نحو التّعميم في تدليله على عموم الشّعر الأمازيغيّ بمختلف الْجهات، ولو أنّ منبته أطلسيٌّ متوسّطيٌّ. ويتميّز كلاسيكيّاً بطولٍ نسبيٍّ واستساغة جميع أنواع الخطاب: السّرد، والوصف، والحجاج، والإخبار، والجدّ، والهزل، والوعظ، والحكم… كما تُسمَّى “تَامْدْيَازْتْ” أيضاً ب”الشِّعْر الْمسْتَرْسَل”، لأنّ فيها استرسالاً في النّظم، وتوالياً للمقاطع كتتابعِ “الغرْزَات” في السّجّاد الأمازيغيّ المزركشِ.
-
أَوَالْ (awal): يطلق على الكلام عموماً، وعلى الشّعر خصوصاً، إذا اقترن بفعل الكسر “رْزْ” (زاي مفخمة) كقولنا: “أَرْ يرْزّا اوَالْ / دَا – يْرْزَّا اوَالْ” (زاي مفخمة)، بمعنى: “يَكْسِرُ / يَنْحَتُ الْكَلَامَ”. علما أنّ النّحت عموماً يرتبط بالصّلابة والكسر؛ إذ ما أصعب أن يتصدّى المرء للصّخر فيسوّيه وللحجر الصّلب فيقوّمه. لا سيّما أنّ الحجر ذاته يعتبرُ في العديد من الثّقافات مصدراً للحياة ومولد الكائنات العلويّة (سيرنج، 1992، صفحة 367). ويقترن “أَوَالْ”، في سياقاتٍ أخرى، بفعل “بِّي” (قَطَعَ)، في مثل قولنا: “دَا – يْتْبِّي اوَالْ” (يَقْطَعُ الْكَلَام)، والقطع يستلزم التّركيز والجهد والطّاقة (لصناعة الكلام).
-
لّْغَا (llva): المقصود به هو “القول”، ولكن ليس القول المطلق غير المحدّد، بل طبقة من الكلام الرّاقي الّذي يغلب عليه الجانب الفنّيّ والشّعريّ. يقول الشّاعر الأمازيغيّ:
لّْغَا يْرَا مَا يْتْنِي -دْ يْتْقْوّامْنْ (الأحقُّ بِالشِّعْرِ مَنْ يُجِيدُهُ)
آبُو يْلْفُوسْ يْنْغَاشْ وْيَادْ يُوعْرْ غِيْفْشْ (أَيُّهَا الْعَيِيُّ هَا قَدْ بَانَ عَجْزُكَ) (المسعودي و ذكيّ، 1999، صفحة 13)
وفي المعجم الأمازيغيّ – العربيّ: “قال الشّعرَ: “ئِرِيرْ”، “ئِسِّيوِي”، “ئِنْكْضْ اوَالْ”: قرض الشّعر. والشّعر: أَسَاوِي، وتَاسَاوِيتْ. والشّاعر: أَمَارِيرْ[2] / أَمْسَّاوِي / أَنْكّاضْ. والشّاعر المتغنّى بشعره: أَمْدْݣـازْ / أَمْدْيَازْ أو أَزْرُوفْ (ج. إِزْرُوفْنْ) (زاي مفخمة)، والشّعرور: الشّاعر الضّعيف جدّا”: “ݣَـارْ امَارِيرْ / ݣَـارْ امْدْيَازْ” (شفيق م.، 1991، صفحة 608). والقصيدة من الشّعر: تَايْفَّارْتْ / تِيفَّارِينْ، تَاسَاوِيتْ / تِيسِيوَايْ، أَمْطَّانْ / ئِمْطَّانْنْ، تَامْدْيَازْتْ / تِيمْدْيَازِينْ، أَسْفْرُو / إِسْفْرَا؛ بَيْدَ أنَّ “تَامْدْيَازْتْ”، في موضعٍ آخرَ، هي القصيدَةُ المغنَّاةُ و”أَسْفْرُو” هو القصيدَة الفَلْسَفَيّة (شفيق م.، 1991، صفحة 313).
وبالنّسبة للمعجم العامّ للّغة الأمازيغيّة (أمازيغيّ – فرنسيّ – عربيّ)، فقد احتفظ للشّعر الأمازيغيّ باصطلاحاتٍ أخرى عديدةٍ:
-
تَانْشَّادْتْ: القصيدة، والشّاعرة؛
-
تَامْدْيَازْتْ: القصيدة والطّويلة المغنّاة، والشّعر، والشّاعرة؛
-
تَايْفَّارْتْ: ضرب من القصائد الشّعريّة؛
-
أَرْغِّيضْ: القصيدة الشّعريّة القصيرة يُتغنّى بها في الحفلات؛
-
تَانْضَّامْتْ: الشّعر، القصيد (poésie, poème) (عامر و آخرون، 2017، الصفحات 568 – 179 – 608 – 554 – 571).
وبالإضافة إلى كلّ هذه الأسماء، تشيعُ مصطلحاتٌ وصيغٌ تعبيريّةٌ كثيرةٌ في كلّ ربوع تَامَازْغَا، مثل: “تَانْضَّامْتْ”، و”تَامَاوَايْتْ”، و”إِزْلِي”، و”تِيزْلِيتْ”، و”تَاقْسِّيسْتْ”، و”تِيمْزُوزَّارْ”، و”ئِنْعْبَارْ”، و”تِيمْنَاضِينْ” أو “تِيمْلَاضِينْ” و”تَاݣـزِيمْتْ” في الجنوب المغربيّ، فضلاَ عن: “بَاهْبِي” المتعلّق بالأعراسِ في أمازيغيّة الجنُوب الشّرقيّ المغربيّ، و”أَهْلّْلْ” ذِي البُعْدِ الروّحيّ الدّينيّ القوميّ. يتّضح، ممّا سبق، إذن مدى التّعدّد الكبير الّذي تعرفه البنية المصطلحيّة للشّعر الأمازيغيّ المغربيّ،
غير أنّ مصطلح “تَامْدْيَازْتْ” الّذي اقتبسه كتّاب وشعراء الحركة الثّقافيّة الأمازيغيّة بالمغرب من الأصناف الشّعريّة بالأطلس المتوسّط، فأطلقوه على الشّعر المكتوب لتعميم المصطلح وتوحيده، يبقى أكثرها شيوعاً وتداولاً في المغرب؛ بينما ينحصرُ مصطلح “أَمَارْݣ” في الشّعر الأمازيغيّ الغنائيّ بالجنوب، ومصطلح “إزلانْ” أو “إِزْرَانْ” في شعر الدّيوان بالرّيف، والأمرُ ذاته يعرفه مصطلح “أَسْفْرُو” في باقي مناطق “تَامَازْغَا”.
ومهما تعدّدت المصطلحات، يبقى الشّعرُ الأمازيغيّ الصّيغة التّعبيرية المتفرّدة الّتي ظهرت في حياة الإنسان الأمازيغيّ، حيثُ ظلّ مرتبطاً بالسّيرورة التّاريخيّة والحضاريّة للثّقافة الأمازيغيّة (مجاهد، 2004، صفحة 80). وهو غنائيٌّ في جوهره، لأنّ الشّاعر لا يؤدّي مَهمّته كاملةً إلّا في محفلٍ جماهيريٍّ، يتكاملُ فيه دورا المرسل والمتلقّي، وفق طقوسٍ معيّنةٍ يفرضُها مقام الرّقصة الجماعيّة (أحواش، أحيدوس…) (مجاهد، 1991، صفحة 15). غير أنّ هذه الخصيصة (التّعّدد) تزيد من حدّة “الفوضى” المصطلحيّة والتّداخل بين مختلف الأشكال الفنّيّة والإبداعيّة، في ظلّ انتشار أنماطٍ كثيرةٍ من التّعبيرات اللّسانيّة، وحتّى نتبيّن ملامح هذا الوضع الخاصّ، ندرس حزمةً من المفاهيم والمصطلحات الشعريّة من خلال ما يتداول جنوب ووسط المغرب.
-
فِي أَنْمَاطِ الْقَوْلِ الشِّعْرِيِّ الْأَمَازِيغِيِّ الْأَطْلَسِيِّ
يتميّز الشّعرُ الأمازيغيّ بالأطلس المتوسّط بتعدّد أنماطه وتنوّع أشكاله حسب بنية المتن الإبداعيّ، ومناسبة إلقائه، وطبيعة موضوعه… وهو ما يؤكّد الثّراء والغنى الّذي يتمتّع به هذا المنجز الأدبيّ على مستوى توظيف اللّغة أو استثمار عناصر التّخييل أو التّصوير… ورغم ذلك يمكن وضع إطارٍ عامٍّ لحركة انتشار السّلالات الشّعريّة في هذه الجهة الأطلسيّة.
ونستعيرُ هنا لفظ “السُّلالات” لأنّهُ، في تقديرنا، الأبلغ والأقدر على احتضان الأبعاد الدّلاليّة للنّتاج الشّعريّ الأمازيغيّ بالمنطقة؛ إذ لا يتأتّى تحديدُ أيّ نوعٍ من هذه الأنواع الشّعريّة القائمة خارج الوشائج البنائيّة أو الموضوعاتيّة أو علاقات القرابة الّتي تصله بالأنواع الأخرى الّتي تنأى عنه بالمغايرة، لا سيّما أنّ تحته تسلسلاً وقواسم مشتركةً تقع على هذا المستوى أو ذاك في مواقع أقرب للفعل المتسلسل أو الأداء المتعاقب، وهو ما يسمح بالقول إنّ بناء الأنواع الشّعريّة بالأطلس المتوسّط يقوم على عناصر وقواسم مشتركةٍ تبدو معها كتلةً متداخلةً ومترابطةً لا تقبل الانفصال أو التّجزئة… (مولودي، 2018، الصفحات 35 – 36)
ويمكنُ تقسيمُ هذه السّلالات الشّعريّة وفق التّوزيع الاصطلاحيّ التّاليّ: “أَفْرَّادِي”، و”إِيزْلِي”، و”تَامَاوَايْتْ”، و”تَايْفَّارْتْ”. ويضُمُّ هذا التّوزيعُ ثنائيّةً تقابليّةً واضحةً: اصطلاحان منهما يحملان دلالاتٍ تحمل على “القوّة الذّكوريّة” (أَفْرَّادِي وإِيزْلِي)، واثنان يحيلان على “القوّة الأنثويّة” (تَامَاوَايْتْ وتَايْفَّارْتْ)، وهو مَا يؤشّر لسياق تصادمٍ أو تقابلٍ أو تكاملٍ يحافظ على وجوده بما يسمّى “تطابُق الأضداد” أو تعالقها (مولودي، 2018، الصفحات 35 – 36). فضلاً عن أنماطٍ شعريّةٍ محلّيةٍ أخرى مطبوعةٍ ببعدٍ دينيٍّ أو مناسبتيٍّ موسميٍّ أو ثقافيٍّ، مثل: “أَهْلّْلْ”، و”تَامْنَاضْتْ”، و”تَاغُونِي”…
-
“أَفْرَّادِي” (ج. إفْرَّادِييْنْ): نمطٌ شعريٌّ معروفٌ عند السّاكنة المحيطة بسهل “ملويّة” بالأطلس الكبير الشّرقيّ وجنوب الأطلس المتوسّط. ويبدو أنّ أصله اللّغويّ مشتقٌّ من لفظٍ عربيٍّ تمّ تمزيغُه (تكييفُه مع اللّسان الأمازيغيّ)، ليحيلَ على الدّلالة العدديّة (الفرد أو المفرد)، ولو أنّ بعض أصوله المعنويّة توجدُ في الثّقافة الأمازيغيّة؛ حيث يرتبط مثلاً بِ “إِفْرْدْ”، وهو دالٌّ لغويٌّ يطلقُ على ولد المعز (الجدي) “إيغْدْ” أو “إِغْجْدْ”، الّذي يستطيع بعد ولادته تحقيق نوعٍ من الاعتماد على الذّات، فيمتلك القدرة على الرّعي استناداً إلى إمكاناته الذّاتيّة وكفاياته الخاصّة، وهو حال هذا النّمط الشّعريّ الأطلسيّ الّذي يستمرّ وجوده في الذّاكرة المحليّة بعد ولادته في استقلالٍ تامٍّ عن باقي أجزاء القصيدة الّتي قد ترد معه.
-
ويوجد أيضاً طائرٌ في المجال الأطلسيّ يطلق عليه “إِفْرْدْ / ج. إِفْرْدِيوْنْ أو إِفْرْدْنْ” (الدّيك الحبشيّ)، يُستعارُ اسمُه في التّداول الشّعبيّ الأمازيغيّ للدّلالة على السُّرعة والخفّة، وهما خصيصتان لصيقتان أيضاً ب”أَفْرَّادِي”؛ حيثُ يُنظَمُ غالباً في بيتٍ شعريٍّ واحدٍ، ويتّسمُ بالاختزال وتكثيف المعنى، يرتبطُ بمناسبةٍ معيّنةٍ أو بواقعةٍ محدّدةٍ، فيُلقى بتلقائيّةٍ وعفويّةٍ نادرتين، إلى حدّ يمكنُ القولُ معه إنّهُ يعادلُ القصيدة التّامّة في قيمته الجماليّة والأدبيّة.
ويعتبر “أَفْرّادِي” من الزّاوية الاصطلاحيّة شكلاً شعريّاً غنائيّاً يتألّف عادةً من جزأين مُتساويين إيقاعيّا؛ إذ يقوم على بيتٍ من شطرٍ واحدٍ أو شطرين أو على بيتين مزدوجين لا يستقيمُ المعنى إلّا بهما، ويتمّ الوقوف عند نهاية أوّلهما قبل استئناف دورة الإيقاع الّتي تنتهي بنهاية الشّطر، ويكون فيه المعنى تامّاً، بحيث يتكامل أو يتعانق الشّطران ليجسّدا معاً هذا المعنى ويؤسّسانه.
ويسهلُ قرضُهُ عندما يكون الشّاعر وسط احتفاليّة الأعراس، ولذلك يرتبط كثيراً في المنطقة بفنّ “أَحِيدُوسْ”. ويعتمد غالباً على الرّمز والإيحاء وعمقِ المعاني، ولا يستوعبه إلّا من خبر الكلمة الموزونة المعبّرة. كما يتعلّقُ بشكلٍ كبيرٍ بظاهرة النّقائض؛ إذ تأتي “إفرّادِييْنْ” في الغالب لتردَّ على “إفرّادِييْنْ” آخرين. وقد يكون هذا النّمط الإبداعيّ أصل باقي الفنون الشّعريّة الأطلسيّة الأخرى وأصل الشّعر الشّعبيّ المغربيّ المعروف ب”الْمْفْرّْدْ” الّذي عرّفه عبّاس الجراري بقوله: “ميزانٌ قديمٌ لعلّ قصائد الملحون كانت تنشد عليه في القديم” (الجراري، 1978، صفحة 40).
-
“إِزْلِي” (ج. إِزْلَانْ): مصطلحٌ يحيلُ على المقطعِ الشّعريّ المغنّى، سواء كان قصيدةً واحدةً أو مقطوعاتٍ شعريّةً قصيرةً، كما هو الحال في نمط “تِيقْسِّيسِينْ”، يقوله الشّاعر ويردّده الآخرون تبعاً لإيقاعه على شكل أهازيج. وهو نمطٌ قد تقابله في اللّغة العربيّة تسمية “البيت الشّعريّ”، كما يعتمد على تجميعٍ ارتجاليٍّ لأبياتٍ متعدّدةٍ قد لا تكون بينها روابطُ عضويّةٌ، ولذلك كثيراً ما يتعذّر على المنشد أن يعيد “النّصّ” نفسه بذات الأبيات وذات التّرتيب (أزروال، 2004). وتكاد أغلب الإبداعات الشّعريّة المتعلّقة به تنسب للمجهول، رغم أنّ مبدعه فردٌ واحدٌ، إلّا أنّ الذّاكرة لا تحتفظُ إلّا بالملفوظ، فيقول اللّسان الأمازيغيّ: “إِنَّا بُو يْزْلِي” (قال صاحب البيت الشّعريّ “الشّاعر”)، وكأنّ الأمر يتعلّق بِتَبَنٍّ جماعيٍّ للإبداعات الشّعريّة، تُنْسَجُ من خلاله ذائقةٌ نوعيّةٌ تعبّر عن الاتّفاق الجماعيّ الضّمنيّ حول المعايير النّقديّة الّتي تجعل من أحد “إِزْلَانْ” رائعاً والآخر أقلّ روعةً.
ويعتبر “إِزْلِي” أكثرَ المفاهيم انتشاراً في الدّراسات والأبحاث الّتي اهتمّتْ بالشّعر الأمازيغيّ، حيث غطّى على باقي الفنون الأخرى واستغرقها، وهو ما خلّف نوعاً من الاضطراب في التّحديدات الّتي وضعت له، فَهو:
-
“أبياتٌ متفرّقةٌ تخضعُ للوزن ولا تهتمُّ بالقافية” (أمرير، 1987، صفحة 98).
-
“عبارةٌ عن قطعٍ غنائيّةٍ قصيرةٍ لقصر أبياتها يغنّيها أَمْدْيَازْ متفرّقةً على جملٍ موزونةٍ ومشطّرةٍ دون تقفيةٍ” (شفيق م.، 2000، صفحة 25).
-
“يتكوّن من بيتين اثنين ولازمة” (بن عبد الجليل، 1978، صفحة 55).
-
“شعرٌ مصحوبٌ بالعزف يردّده إردّادن بعد المغنّي أو في حلقات أحيدوس بالأطلس المتوسّط، ويتكوّن إِزْلِي من بيتين أو أربعةٍ فقط” (مجاهد، 1989، صفحة مادة أمارك).
-
عبارةٌ عن مقطعٍ شعريٍّ قصيرٍ ذي إيقاعٍ موزونٍ مجزّإٍ إلى شطرين، يقابله في القصيدة العربيّة البيت الّذي يتكوّن من صدرٍ وعجزٍ”(أمصحو، 2013، صفحة 25).
يتّسم “إِزْلِي”، إذنْ، بكونه أبياتاً (أبياتاً متفرّقةً، أو أبياتاً شعريّةً، أو أبياتاً متعدّدةً…)، ونمطاً من القصائد (قصيدة قصيرة، أو قصيدة مختزلة…)، ومقطعاً شعريّاً (مقطعاً شعريّاً قصيراً، أو قطعاً غنائيّةً قصيرةً…)، وشعراً (مقطعاً شعريّاً، أو شعراً مصحوباً بالعزف…)، وأغنيةً (عبارة عن قطعٍ غنائيّةٍ، أو شعرٍ يردّده المعيدون بعد المغنّي…). ومن ثمّة فهو بنيةٌ مشتركةٌ بين أشكالٍ شعريّةٍ وغنائيّةٍ أمازيغيّةٍ متعدّدةٍ، وأقرب للتّدليل محلّياً على مفهوم “الأغنية”.
ويأخذ مصطلح “إِزْلِي” في لغة “القبائل” الجزائريّة معنىً آخر يرتبط كثيراً بالغناء، فهو: “قصيدةٌ قصيرةٌ سداسيّةٌ غالباً تُتداول في أوساطٍ نسويّةٍ… ولكن قبل أن يستقرّ المصطلح على هذه الدّلالة كان يعني على الأرجح الشّعر المغنّى أو المؤدّى وفق طبع الغناء الشّعبيّ المحلّيّ” (بوحبيب، 2013، صفحة 338). وتذهبُ تسعديت ياسين إلى القول إنّ “إِزْلِي” كلمةٌ جذرها «زَلْ» بمعنى غنّى أو أنشدَ، وهو فنٌّ شعريٌّ شفويٌ أمازيغيٌّ، و”إِيْزَلانْ” هي قصائدُ شعرٍ غزليّةٌ قصيرةٌ مصحوبةٌ بالموسيقى تنشدها في الأعراس غالباً النّسوة وأحيانا الشّباب في بلاد القبائل وبلاد الطّوارق، وهي أيضاً إنشادٌ يرافق المرأة في كلّ أعمالها (Tassadit, 1990, pp. 15 – 30).
-
“تَامَاوَايْتْ” (ج. تِيمَاوَايِينْ): وتسمّى أيضاً “لْمَايْتْ (ج. لْمَايَاتْ)”، مصطلحٌ شعريٌّ أمازيغيٌّ أطلسيٌّ، جاء على وزن الصّفة المشبّهة باسم الفاعل من الفعل (يِيوِي) بمعنى “أَخَذَ”، و”الأَخْذُ” في التّداوُل الأمازيغيّ يستعملُ مجازاً للتّدليل على التّنقّل في المكان: “يِيوِي ابْرِيدْ” (أَخَذَ الطّريقَ). وبهذا يكون المقصود من “تَامَاوَايْتْ” ذلك الشّعر المختصر الّذي يرافق المسافر (بشكلٍ عامٍّ)، و”يأخذ” به الطّريق. وتحيلُ دلالتهُ المعجميّة إلى “الرّفيقة” أو “المرافِقة” أو “أغنية المسيرة” الّتي تصاحب المسافر عبر الجبال والوهاد، والرّاعي في المجالات الرّعويّة الفسيحة، وكلّ إنسانٍ منفردٍ عن القوم، يشعر بالوجد والفقد والشّوق، وتشجيه الوحشة، فيُطلقُ العنان لحنجرته عبر التّموّجات الصّوتيّة الرّنّانة، ويصدحُ متغنّياً بفقرةٍ من نظمه أو نظم غيره، مادّاً لكلّ نغمةٍ أكثر ما يمكن المدّ، فتردّد الجبال والغابات صَداها، وتوصلها إلى صاحبها الّذي يردّ عليها بعد ذلك. فهي إذنْ عبارةٌ عن محاورةٍ شعريّةٍ مرتجلةٍ ورسالةٍ مشفّرةٍ بين طرفين، يتحاورُ كثيراً عبرها فتيان قريةٍ وفتياتها في المواسم أو الأعراس.
وتأخذ “تَامَاوَايْتْ” في الدّلالة الاصطلاحيّة بعداً تشكيليّاً شعريّاً يتميّز بخصائص إيقاعيّةٍ وموسيقيّةٍ ودلاليّةٍ معيّنةٍ، فتأتي في شكل أبياتٍ مستقلّةٍ من شطرين إلى ثلاثة أشطرٍ أو “بيتٍ شعريٍّ واحدٍ يغنّيه من وهبه اللّه صوتاً مؤثّراً، وقد يُغنّى هذا النّوع لتسلية النّفس في الوحدة والعمل” (أمرير، 1987، صفحة 87). وتقع من حيث لفظُها بين الشّعر والنّثر، لأنّ الشّاعر الأمازيغيّ حرٌّ في التّقفية أو عدم التّقفية، غير ملزمٍ بإتيان الرّويّ (شفيق م.، 2000، صفحة 99)، فتنشدُ بشكلٍ فرديٍّ، تتمازج فيه العاطفةُ بالتّناوب بين مشاعر الفرح والمعاناة. ويدور غالباً موضوعُها حول تيمةٍ عاطفيّةٍ، أو قضيّةٍ من القضايا المتعلّقة بالحياة اليوميّة، يرخي فيها الشّاعر أو المغنّي العنان لتأمّل الطّبيعة عبر صوتٍ طويل النّفس، تظهر فيه براعته وحسنُ صوته… ولعلّ أهمّ ما يميّز “تَامَاوَايْتْ” أنّها تردّد بشكلٍ عفويٍّ وبصوتٍ عالٍ جدّا يُسمع دويّه في الجبال. ولذلك فهي أقربُ صوتيّاً ودلاليّاً من مفهوم “الموال” العربيّ، باعتباره نوعاً من الغناء يرتكز على مقطعٍ واحدٍ يردّد مراراً. وفي مقابل “أَفْرَّادِي” المرتبطِ بالطّقس الجماعيّ، تحتفظ “تَامَاوَايْتْ” بكينونتها الإبداعيّة الفرديّة على مستوى طبيعة الأداء. ولعلّ من أشهر الأسماء الّتي أدّت هذا اللّون الشّعريّ المتميّز بالمنطقة “يامنة ن عزيز”، و”حمّو واليزيد”، و”بنّاصر وخويا”، و”الشّريفة كْرسيت”…
-
“تَايْفَّارْتْ” (ج. تِيفّارِينْ): تطلقُ في اللّغة على القيد أو الغلّ أو العقال الّذي تُربط به قوائم الدّابّة. وباعتبار النّظم الّذي يشبه الحلقة المتسلسلة، تطلق كنايةً على الأبيات المترابطة معنىً ومتناً. وفي الاصطلاح هي نمطٌ شعريٌّ يعادل مدلول القصيدة، ويأخذ شكل متتالياتٍ من الأبيات، ذات خصائص شكليّةٍ وبنائيّةٍ متعلّقةٍ بقيودٍ ومواصفاتٍ خاصّةٍ تستحثّ قدرات الشّاعر وإمكاناته ومهاراته، مثل: الوحدة الموضوعيّة، والالتزام بالإيقاع المحدّد، وتوظيف الصّور والأخيِلة… وقد تتّخذ طابعاً حواريّاً، فيشترك في إلقائها أكثر من شاعرٍ. كما أنّ أوزانها كثيرةٌ ومجالات الإبداع فيها متعدّدةٌ بتعدّد الشّعراء والأغراض.
وشعر “تَايْفَّارْتْ” جنسٌ أدبيٌّ قديمٌ في منطقة “فَازَازْ” (الأطلس المتوسّط)، حيث يرجع أصلهُ إلى جذور الحضارة الأمازيغيّة الّتي تعود إلى أزيد من ثلاثةٍ وثلاثين قرناً، ينشده الشّاعر وهو يقف وسط الجمهور، ومعه “إِرْدَّادْنْ” (الْمُرَدِّدُونَ) يعيدون البيت الشّعريّ الأخير من القصيدة.
وتُتداولُ أيضاً في منطقة الأطلس المتوسّط أنماطٌ شعريّةٌ أخرى كثيرةٌ، غير أنّها أقلّ انتشاراً من أنماط القول السّابقة، ولعلّ من أهمّها:
-
“أَهْلّْلْ”: اصطلاحٌ ممزّغٌ من العربيّة، أصله: “هَلَّلَ”، بمعنى: هتف، وعبّر عن الفرحة، وسبّح، وقال لا إله إلّا اللّه، ومنها “لْمْهْلّْلْ”، وهو الشّخص المسؤول عن عمليّة الذّكر في المسجد قبل آذان الفجر. ويحيلُ دلاليّاً على قصيدةٍ ذات أبعادٍ روحيّةٍ ودينيّةٍ وقيميّةٍ تتشكّل من ثلاثة مقاطع رئيسةٍ: المطلع، والقلب أو الموضوع الأساس، والخاتمة، ولا تزال متداولةً في المنطقة. كما أنّ لها آثارٌ في الجنوب الشّرقيّ المغربيّ المعروف ب”أَسَامّْرْ”.
-
“تَامْنَاضْتْ” (ج. تِيمْنَاضِينْ): يعرفُ هذا النّمطُ كثيراً بصيغته الجمعيّة “تِيمْنَاضِينْ”، وهو من بين الإيقاعات الشّعريّة الفيّاضة، بالنّظر إلى طبيعته الرّومانسيّة والانسيابيّة، حيث يعكس حال النّفس وما تعانيه من غربةٍ وشوقٍ وحبٍّ… بيد أنّه قد يوظّف أيضاً في فنّ “النّقائض”، فيخال المتلقّي نفسه أمام عراكٍ مفتوحٍ بالنّار والحجر. وتدلّ التّسمية “تَامْنَاضْتْ” في اللّغة على المجال أو النّاحية أو الجهة، وكثيراً ما تنقلب فيها اللّام نوناً “تِيمْلَاضِينْ”، ويقصد بها المقارعة والسّجال الشّعريّ؛ إذ لا تكتمل مقوّماتها الفنّيّة إلّا في شكل حوارٍ أدبيٍّ راقٍ ومبارزةٍ فنّيّةٍ إبداعيّةٍ بين شاعرين أو أكثر.
-
“تَاغُونِي” (ج. تِيغُونِيوِينْ): نمطٌ فنّيٌّ شعريٌّ يطلق في اللّغة على الأحاجي، ويأخذ اصطلاحاً شكل أشعارٍ ملغّزةٍ تنغلقُ على المتلقّي، وينتظر منه أن يفتحها، أو يجد لها حلولاً.
-
“أَزْدَّايْ”: ومعناه “الْمُمْتَدّ” أو “الرَّابِط”، وهو نمطٌ شعريٌّ قلّما تناولته الدّراسات الأمازيغيّة الحديثة، يعتمد على ترديد الكلمات الأخيرة من كلّ شطرٍ، ويستند غالباً إلى الامتدادات الصّوتيّة لإظهار مدى الانسجام الإيقاعيّ بين الشّعراء.
-
“وَارُّو”: شعرٌ نسائيٌّ يتداول كثيراً في كلّ من جنوب الأطلس المتوسّط وجنوب المغرب (السّوس)، ويتزامن إلقاؤهُ مع تخضيبِ أيدي العرسان بالحنّاء أو مع مقدم موكب هديّة العريس للعروس ليلة الزّفاف “تَامْغْرَا”، أو ما يسمّى في الأمازيغيّة “تَارِيكْتْ”.
-
“تَامْدَّاحْتْ”: قصيدةٌ دينيّةٌ ينظمها “أمْدَّاحْ (ج. إِمْدَّاحْنْ)” في مناسباتٍ خاصّةٍ كالأعياد الإسلاميّة. وهي أشبه ما تكون ب “أَهْلّْل” أو “تَانْشَّادْتْ” في أمازيغيّة سوس.
ولأنّ الشّعر لا يفارق الإنسان الأمازيغيّ، تُتداولُ أيضاً في المنطقة، على غرار كلّ الجهات في “تَامَازْغَا”، أنماطٌ شعريّةٌ تقليديّةٌ كثيرةٌ ترتبط بالأعمال اليوميّة والمناسبتيّة، ولذلك نجد شعراً خاصّاً بكلّ عملٍ يزاوله أو مناسبةٍ يحتفل بها، ونذكر من ذلك: شعرَ النّسج (تَامْدْيَازْتْ نْ وزْطَّا)، وشِعرَ الحرث (تَامْدْيَازْتْ نْ تْكْرْزَا)، وشِعرَ الحصاد (تَامْدْيَازْتْ ن تْمْـڴـرَا)، وشعرَ الدّرس (تَامْدْيَازْتْ نْ ورْوَا)…
-
فِي أَنْمَاطِ الْقَوْلِ الشِّعْرِيِّ الْأَمَازِيغِيِّ السُّوسِيِّ
تتداول في منطقة سوس جنوب المغرب أنواعٌ مختلفةٌ من الشّعر التّقليديّ (الشّعر التّعليميّ، والشّعر الطّقوسيّ، والشّعر الإبداعيّ…) مرتبطةٌ بمناسباتٍ عديدةٍ كالختان والزّواج والحصاد والحفلات العُموميّة الرّسميّة… ويمكن في هذا الصّدد أن نشير إلى أنماطٍ مختلفةٍ منها، مثل:
-
“تَامَاوَاشْتْ” (ج. “تِيمَاوَاشِينْ”): شعرٌ غنائيٌّ مرتجلٌ ذو مستوى رفيعٍ، شكلاً وإيقاعاً؛ فهو بطيء النّغمة والوزن، ويتّخذ شكل موالٍ طويلٍ قريبٍ من “تَامَاوَايْتْ”، ويقوم على محاورةٍ شعريّةٍ أدبيّةٍ ذات أبعادٍ اجتماعيّةٍ أو ثقافيّةٍ أو فكريّةٍ، كما يتميّز مضمونيّاً بالحضور القويّ للرّموز والألغاز(عزيز، 2017). ويحيل في مناطق أخرى على “الشّعر الهجائيّ”.
-
“أَقْصِيدْ”: القصيدة الطّويلة المغنّاة بمنطقة “السّوس”، سواء أصحبتها آلاتٌ موسيقيّةٌ أم لا.
-
“تَانْشَّادْتْ”: مصطلحٌ أصله عربيٌّ يعني “الأنشودة”، وهو قصيدةٌ مرتبطةٌ بمناسباتٍ خاصّةٍ دينيّةٍ ودنيويّةٍ، وتعكس عاداتٍ وتقاليد مرتبطةً بتاريخ المنطقة الجنوبيّة من المغرب.
-
“تَازْرَّارْتْ” (ج. “تِيزْرَّارِينْ”): مصطلحٌ مشتقٌّ من الفعل “زْرِيرْ”، الّذي يعني: “هنّأ / قدّمَ التّهنئة”، ومنه كلمة “الزّْرُورَة” المتداولة شعبيّاً في المغرب، والّتي تعني: الهديّة الّتي تقدّم للمرأة النّفساء، أو من فعل “زْرْرْ” بمعنى “رَصَعَ” “طَرَزَ”. أمّا اصطلاحاً، فهو فنٌّ شعريٌّ أمازيغيٌّ، يأخُذُ شكل مقطعٍ منفردٍ، أو قصيدةٍ طويلة النّفس مركّبةٍ من عدّة مقاطع، تؤدّى فرديّاً وجماعيّاً، وتُتبادل فيها، بعد توقّف الغناء الجماعيّ والعزف على آلات الإيقاع، كلماتُ التّرحيب والمودّة والحبّ(عصيد، 2016، صفحة 06). وقد ينشد في الحقول بعيداً عن التّجمّعات التّقليديّة. وهو على غرار “تَامَاوَاشْتْ” قريبٌ من معنى “الموّال” العربيّ و”تَامَاوَايْتْ” الأطلسيّة.
-
“دّْرْسْتْ”: مصطلحٌ مؤنّثٌ مذكّره “أَدْرَاسْ”، وهو في أمازيغيّة الجنوب المغربيّ بمعنى “الحلف الكبير”(شفيق م.، 1990). واصطلاحاً هو قصيدةٌ طويلةٌ ينشدها الشّاعر “أَمَارِيرْ” في رقصة “أَحْوَاشْ”، يستعرضُ فيها بحبكةٍ فنّيّةٍ حدثاً واقعيّاً أو قصّةً عاطفيّةً أو سيرة بطلٍ من التّاريخ أو الحكايةٍ أو الأسطورةٍ… وباعتبارها نوعاً احتفاليّاً تتميّز “دّْرْسْتْ” بطابعها التّفاعليّ الحواريّ (اليماني و الزيزاوي، 2006).
-
“أَبَاغُورْ”: شعرٌ نسائيٌّ قريبٌ من “أَبَاغُورْ” و”أَزّْنْزِي” تعدّدُ فيه محاسن العروس وفضائلها.
-
“أَنْعِيبَارْ”: كلمةٌ أمازيغيّةٌ مشتقّةٌ من “عْبْرْ”، أيّ “وَزَنَ الْكَلَامَ”، وهي صيغةٌ شائعةٌ بين المغاربة؛ إذ يمكن أن يقول أحدهم للآخر: “اعْبْرْ كْلَامْكْ” بمعنى: “زِنْهُ”. وهي في هذا السّياق شعرٌ حواريٌّ عفويٌّ مرتجلٌ ومتداولٌ كثيراً في منطقة السّوس(اليماني و الزيزاوي، 2006).
-
“تَانْضَّامْتْ”:كلمةٌ ممزّغةٌ من العربيّة تعني المنظومة الشّعريّة، وتشير إلى نظم الكلام وقرض الشّعر، ومنها كلمة “أَنْضَّامْ” وهو الشّاعر النّحرير. واصطلاحاً هي قصيدةٌ أَمَازِيغِيَّةٌ طويلةٌ نسبيّاً وتتكوّن من اثني عشر مقطعاً، ويمتدّ مجال تداولها من “خوانق إِمْـﯖونّ” إلى أقصى الجنوب المغربيّ.
-
“إِبِيسْمِي”: أشعارٌ افتتاحيّةٌ احتفاليّةٌ تتضمّن دعوات استجلاب السّعد واليمن والبركات للأزواج (من البسملة).
-
“ذِّكْرْ” (ج. لَاذْكَارْ): اصطلاحٌ عربيٌّ يحيل في هذا السّياق على تلك الأناشيد الصّوفيّة الّتي تنظم في المناسبات الدّينيّة والمواسم المخصّصة للأولياء الصّالحين في الزّوايا والأضرحة المنتشرة في المنطقة.
-
“تَاقْسِّيسْتْ”: قصّةٌ محكيّةٌ في قالبٍ شعريٍّ تكاد تكون شبيهةً بحكايات الكاتب الفرنسيّ “La Fontaine“ الّذي نظم حكايات الحيوانات شعراً. وكثيراً ما يتداولُ هذا الاصطلاح أيضاً في منطقة الرّيف شمالاً.
-
“أَسْنْمِيرْ”: قصيدةٌ شعريّةٌ مغنّاةٌ دون موسيقى تتداول كثيراً في منطقة (آيْتْ بُوڴـمَّازْ).
-
“ئِزْلَانْ نْ يِيجِي”: أبياتٌ شعريّةٌ ذات أوزانٍ وأغراضٍ مختلفةٍ، اندثر الكثير منها وبعضها لا يزال يقاوم الإهمال والنّسيان. وتتراوح مقاطع هذا النوّع الشّعريّ ما بين ثمانية واثني عشر مقطعاً. ولكلّ وزنٍ شعريٍّ اسمٌ خاصٌّ به يميّزه عن غيره.
-
“وَارُّو”: شعرٌ نسائيٌّ ينْظَمُ وقت تخضيب أيدي العرسان بالحنّاء، وله مسمّياتٌ أخرى تكاد تكون قريبةً من هذه التّسمية بحسب المناطق. وإن كان الاختلاف بينها على مستوى التّيمة والزّمن والوزن الشّعريّ. ويتداول الاصطلاح ذاته جنوب الأطلس المتوسّط.
-
“تَاسُوڴـانْتْ”: قصيدة توديع العروس وتشييعها لبيت زوجها، وهي قريبةٌ جدّا من نمط “أَسَالَاوْ”(اليماني و الزيزاوي، 2006).
-
“بَايْ بَابَا”: نوعٌ شعريٌّ معناه “الممتدّ”، يعتمد على ترديد الكلمات الأخيرة من كلّ شطرٍ مع التّركيز على الامتدادات الصّوتيّة، والغاية منه هي إظهار مدى الانسجام الصّوتيّ بين الشّعراء أو المردّدين على غرار “أَزْدَّايْ”.
-
“أَزّْنْزِي”: شعر الاحتفال بمقدم العروس إلى بيت زوجها. هو قريبٌ من “أَبَاغُورْ” و”أَسَالَاوْ” و”وَارُّو”…
-
“أَوْرَارْ”: هو لغةً “اللّعب” بالأطلس المتوسّط و”الغناء” جنوب المغرب. ويقصد به في منطقة “آيْتْ مْڴـونْ” الشّدْو الشّعريّ البعيد عن الموسيقى في مناسباتٍ معيّنةٍ، ويقتصر أداؤه فقط على النّساء المتزوّجات أو المطلّقات.
-
“لّْغَا”: اصطلاحٌ فنّيٌّ يطلق على النّمط الشّعريّ الّذي يغنّى دون آلاتٍ موسيقيّةٍ بمنطقة سوس، ولا يتعدّى في الأغلب بيتين أو ثلاثة ينشدها “أَمَارِيرْ” (الشّاعر) في رقصة “أَحْوَاشْ”.
-
“أَرَاسَالْ”: يطلق على الشّعر الغنائيّ الأمازيغيّ الشّعبيّ، سواء كان مصحوباً بالعزف على أو بدونه.
-
“تَالّْغَاتْ”: قطعةٌ شعريّةٌ في حدود ثلاثة أبياتٍ ينشدها الشّاعر “أَمَارِيرْ” في مرقص “أَحْوَاشْ”.
-
“لْحَالْ” (ج. لَاحْوَالْ): شعرٌ نسائيٌّ صوفيٌّ يجمع بين الإنشاد والرّقص.
-
“أَزْوِيرِيـڴـْ”: قصيدةٌ شعريّةٌ تحمل نفساً غنائيّاً حزيناً يتمنّى فيه المنشد السّعادة والخير للزّوجين، وقريبٌ دلاليّاً من “إِبِيسْمِي”(اليماني و الزيزاوي، 2006).
-
“تَانْشَّادْتْ”: مصطلحٌ شعريٌّ يحيل على القصيدة الغنائيّة المسترسلة ذات الأبعاد الدّينيّة والوعظيّة والأخلاقيّة، ويقابلها “أَهْلّْلْ / أَهْلِّيلْ” في الأطلس المتوسّط.
-
“لْمْسَاقْ”: نمطٌ شعريٌّ غنائيٌّ يسبق رقصة “أَحْوَاشْ” يؤدّيه فقط الرّجال والأطفال عزفاً على الدّفوف.
-
“أَسَالَاوْ”: قصيدةٌ شعريّةٌ نسائيّةٌ ترافق دون موسيقى تهييء العروس في حفل الزّفاف “تَامْغْرَا”.
-
شِعْرُ الْأَعْمَالِ الْيَوْمِيَّةِ وَالْمَوْسِمِيَّةِ (Izlan n twuriwin): نذكر من ذلك: وشعرَ الدّرس (تَامْدْيَازْتْ نْ ورْوَا)، وشعرَ الطّحْن (تَامْدْيَازْتْ نْ يِيزِيضْ)، وشِعرَ الختان (تَامْدْيَازْتْ نْ تْسْكْرَاوْتْ)، وشِعرَ الاستسقاء (تَامْدْيَازْتْ نْ تّالْغْجَا)…
ويحتفظ السّوسيّون كذلك باصطلاحاتٍ كثيرةٍ في المصادر الشّفوية والمكتوبة للدّلالة على الشّعر الأمازيغيّ، منها: تَاهْوَّارِيتْ، وتَاجْرْوِيحْتْ، وتَامْسُوسْتْ، وأَوَالْ نْ يسُويَاسْ، وأَدْرَاسْ، ونّْضْمْ، وتَامَارِيرْتْ، وأَمَارْڴ، وإِيمُورِيـﯖ، ولهَاوَا، وشِّيعْرْ، وإِيزْلِي، وإِيفْرِي، وإبْنَادْ…. فضلاً عن “تَازْضَايْتْ” (ج. تِيزْضَايْ) (زاي مفخمة)، و”تَاغْرْضْتْ” (ج. تِيغْرَاضْ)، و”تَاغْيُولْتْ” (ج. تِيغْيَالْ)، و”تامْدْيَازْتْ / تَامْلْڴازْتْ / تَاْمْلْيَازْتْ”، و”تَايْفَّارْتْ”…
ونجد على مستوى الأنماط الشّعريّة المرتبطة بالأعراس في الجنوب الشّرقيّ المغربيّ “أَسَامّْرْ”، فضلاً عن “تِيمْلَاضِينْ” و”تِيغُونِيوِينْ” الّتي سبق ذكرهما:
-
“بَاهْبِي”: شعرٌ أمازيغيٌّ ذو إيقاعٍ خاصٍّ، ويتكوّن من شطرين قائمين على ثمانية مقاطع لكلّ بيتٍ، ويتوسّط كلّ بيتٍ “مِفصلٌ”.
-
“بَايْبِي”: نمطٌ شعريٌّ وقالبٌ فنّيٌّ له إيقاعٌ تضرّعيٌّ ملحميٌّ، كما يمكن تحميله أيضاً مختلف الأغراض الشّعريّة التّقليديّة السّائدة في المنطقة. وتدلّ السّابقة “بَا”(ba) ، وهي صيغةٌ مختزلةٌ ل: بَابَا(baba) ، على التّعظيم والتّحبيب. ولا تزال تلحق بالتّضعيف أو بدونه الأسماء الشّخصيّة المتداولة في المغرب، مثل: علِي = بَاعْلِي / عْدِّي = بَاعْدِّي، وبَّاعْدِّي / ئِشُّو = بَايْشّو، وبُويْشُّو، وبَّايْشُّو / هْدِّي = بَاهْدِّي، وبَاهَادِّي، وعْسُّو، وعَبْد السَّلَام = بَاسْلَام…
-
“تَاڴـزْمْتْ / تَاڴـزِيمْتْ”: شعرٌ قَصَدِيٌّ يُنظمُ في مستهلّ رقصة “تِيـﯖـي” بكلّ حمولتها الصّوفيّة التّضرّعيّة والفلسفيّة الحكميّة… وهو مكوّنٌ من مقاطع، ومن هناك تسميته: “تَاڴـزْمْتْ”: المقطع. وتدلّ على قرض الشّعر من خلال مقاطع مجزّأةٍ تفصل بينها زغاريد النّساء يمدّ فيها الشّاعر ومعه الفرقة الرّاقصة للمقطع الأخير من البيت إيذاناً منه بانتهائه منه، لأخذ قسطٍ من النّفس والانتقال إلى المقطع الموالي.
وعموماً، يعتبرُ الشّعرُ الأمازيغيّ الصّيغة التّعبيرية المتفرّدة الّتي ظهرت في حياة الإنسان الأمازيغيّ في كلّ ربوع “تَامَازْغَا”، وقد ظلّ مرتبطاً بالسّيرورة التّاريخية والحضاريّة للثّقافة الأمازيغيّة (مجاهد، 2004، صفحة 80). وهو غنائيٌّ في جوهره، لأنّ الشّاعر لا يؤدّي مَهمّته كاملةً إلّا في محفلٍ جماهيريٍّ، يتكاملُ فيه دورا المرسل والمتلقّي، وفق طقوسٍ معيّنةٍ تقليديّةٍ يفرضٌها مقام الرّقصة الجماعيّة (أحواش، أحيدوس…) (مجاهد، 1991، صفحة 15). كما يبدو جليّاً أيضاً التّقاربُ والثّقافيّ والدّلاليّ والفنّيّ بين جلّ هذه الأنماط الشّعريّة، وهو ما يفسّر الغنى المفرداتيّ والثراء الاصطلاحيّ في الآن ذاته، في انتظار أن تصله يد التّهيئة اللّسانيّة، فتتمّ معيرته وتأسيسه على قواعد أدبيّةٍ وفنّيّةٍ مائزةٍ تبعده عن الفولكلوريّة والطّابع المحلّيّ الضّيّق.
-
اِسْتِنْتَاجَاتٌ وَتَوْصِيَاتٌ
يكشف الحديث عن المصطلحيّة (Terminologie) الأهمّية البالغة لهذا العلم النّاشئ في الثّقافة الأمازيغيّة الّتي وجدت نفسها على حين غرّةٍ أمام طوفانٍ من المستجدّات العلميّة والتّقنيّة الّتي دعتها إلى إعادة النّظر في الكثير من الأساليب الكلاسيكيّة الّتي اعتمدت في الجمع والتّدوين والتّصنيف والوصف والتّفسير، خاصّةً ما يرتبط منها بالجانب الشّعريّ، ما دام يغلب عليه البعد الشّفويّ والتّعدّد اللّهجيّ والتّباين الفنّيّ. ولذلك توخّت هذه الدّراسة الغوص في تفاصيل هذا الرأسمال الرّمزيّ ونفض الغبار عن بعض جوانبه الفنّيّة واللّغويّة. وتبعاً لذلك يمكن تسطير الاستنتاجات الآتية:
-
ضرورة تدريس هذا التّخصّص العلميّ (المصطلحيّة) في المستويات المختلفة من التّعليم الجامعيّ إلى جانب التّخصّصات اللّسانيّة الأمازيغيّة الأخرى، باعتباره من أوجهها التّطبيقيّة. لأنّه عنصرٌ لا غنى عنه لتحديث اللّغة وعصرنتها، وربطها بواقع الحياة المتدفّق بلا توقّفٍ(بيجوان و توارون، 2009، صفحة 21).
-
يعود الاختلاف والتّعدّد في المصطلحات الشّعريّة الأمازيغيّة إلى عوامل جغرافيّةٍ ووظيفيّةٍ كثيرةٍ. ذلك أنّ نمطاً معيّناً من القول الشّعريّ قد يأخذ اصطلاحاتٍ قريبةً ومختلفةً من منطقةٍ إلى أخرى، من قبيل:
-
لّْغَا = أَسْنْمِيرْ = تَالّْغَاتْ؛
-
تَامَاوَايْتْ = تَازْرَّارْتْ = تَامَاوَاشْتْ؛
-
تَانشَّادْتْ = أَهْلّْلْ / أَهْلِّيلْ = ذِّكْرْ (ج. لَاذْكَارْ) = “لْحَالْ” (ج. لَاحْوَالْ)؛
-
تَاسُوڴـانْتْ = أَزْوِيرِيـڴ / تَازْوِيرڴـْـتْ (ج. إزْوِيرْڴـنْ) = إِبِيسْمِي (ج. إبِبِيسْمِيتْنْ)…
وقد تعرف الجهة الواحدة أسماء مترادفةً لنفس النّمط. وفي الحالتين يتميّز كلّ نمطٍ، شمالاً ووسطاً وجنوباً، بمواصفاته الشّكليّة ومعطياته المضمونيّة وخصوصيّاته الفنّيّة والإيقاعيّة. ومن المصطلحات أيضاً ما هو متواردٌ في كلّ الجهات (تَامْدْيَازْتْ). كما أنّ للموضوعات والأغراض والمناسبات دوراً حاسماً كذلك في تعدّد الأنواع الشّعريّة التّقليديّة.
-
هذه المساهمة في جمع المصطلح الشّعريّ ليست شاملةً، بل توجد أنماطٌ أخرى سواء في السّوس أو الأطلس أو الرّيف، أو في كلّ مناطق “تَامَازْغَا” لم تصل إليها يد الدّراسة.
-
الشّعر المتعدّد الأغراض والاصطلاح هو تجسيد لفسيفساء البيئة الأمازيغيّة بخصوبتها وعذوبتها، وتعبير عن مدى تفتّح ذهنيّة الأمازيغ الّتي تنبذ الرّأي الوحيد الّذي يحرّم على الفرد حرّيته، وقد عبّر عن ذلك بكلّ ما خالج وجدانه أو راود ذاكرته دون تكلّفٍ أو تصنّعٍ أو زيفٍ. والتّجربة الشّعريّة بقدرتها الفائقة وكمّها وكيفها الّتي وسمت هي الأخرى بالقيم الّتي قدّرت الشّاعر الأمازيغيّ كونه ذاكرة تغنّي التّراث وتؤسّس التّاريخ، وتبني المستقبل من خلال التعبير المستديم عن وعي الجماعة ومناهضة كلّ أشكال الإقصاء والتّهميش ووفاء للرّسالة الأدبيّة والفنّيّة.
-
الشّعر الأمازيغيّ الأطلسيّ والسّوسيّ متعلّقٌ بالمحيط الاجتماعيّ والجغرافيّ والثّقافيّ والتّاريخيّ والاقتصاديّ، وقد عرف اضطهاداً لانتمائه إلى ثقافةٍ ولغةٍ هامشيّةٍ، رغم ما يتميّز به من خصوصيّاتٍ تعبيريّةٍ وفنّيّةٍ ووظيفيّةٍ(الورياشي، 1986).
-
الشّعر الأمازيغيّ وليد الظّروف الاجتماعيّة للإنسان الأمازيغيّ، وبذلك يمكن اعتباره حصيلةً اجتماعيّةً محضةً يحاول به المجتمع الأمازيغيّ إعادة بناء ذهنه، و”من الضّروريّ استحضار السّياق الاجتماعيّ الّذي يشير إلى أنّ الممارسة الأمازيغيّة تشكّل في حدّ ذاتها إنتاجاً رمزيّاً يتولّد عن العلاقات الاجتماعيّة”(سكنفل، 2006).
ومن التّوصيات الّتي خرجت بها هذه الورقة العلميّة:
-
ضرورة تكثيف الجهود بالمشاركة والتّعاون في البحث والعمل الجماعيّ، وإنتاج عملٍ قاموسيٍّ خاصٍّ بالنّتاج الشّعري الأمازيغيّ المغربيّ. ومن المعروف أنّ الإنسان ضعيفٌ بنفسه قويٌّ بأخيه، فكلّما تكاثفت الجهود إلّا وأثمرت خدماتٍ جليلةٍ لا يمكن أن يحقّقها أيّ عملٍ فرديٍّ مهما بلغ من الإتقان والرّصانة؛
-
جمع وتدوين الشّعر الأمازيغيّ في كلّ ربوع “تَامَازْغَا”، وإنشاء بنوكٍ اصطلاحيّةٍ في مختلف الحقول الدّلاليّة.
-
إعطاء زخمٍ إعلاميٍّ وديداكتيكيٍّ لما تمّ جمعه والاتّفاق عليه وتقرّر في النّدوات والمؤتمرات من الاصطلاحات الأدبيّة والفنّيّة والتّقنيّة…؛
-
عقد مؤتمراتٍ واجتماعاتٍ للتّتبّع والمراجعة، ومتابعة ما يستجدّ من الأبحاث المصطلحيّة الأمازيغيّة والمرتبطة خصوصاً بالنّقد الأدبيّ، وتنسيق الجهود بين مختلف الباحثين ومراكز الدّراسات الخاصّة والعامّة؛
/// خَاتِمَة
لَمّا كان أغلب المنجز الإبداعيّ الشّعريّ شفويّاً، فهو منذورٌ للتّلف والضّياع، ومن هنا كانت الحاجة ملحّةً من أجل تضافر الجهود حتّى يعرف هذا الكنز الثّمين من موروثنا الثّقافيّ طريقه إلى الاهتمام والتّدوين. لا سيّما أنّ الشّاعر الأمازيغيّ الأطلسيّ يشهد نوعاً من التّهميش والعزلة، إذ لا زال يلعب أدواراً فولكلوريّةً لا ترقى إلى مستوى الرّسالة الشّعريّة النّبيلة الّتي يضطلع بها، وهو ما يفرض التّفكير مليّاً في ردّ الاعتبار للشّاعر الأمازيغيّ وتمكينه من حقوقه الثّقافيّة إسوةً بباقي المبدعِين باللّغات الأخرى… إذ لا يمكن تصوّر لغةٍ في خضمّ تناميها وتجدّدها وتطوّرها دون أن يواكبها، من جهةٍ، أدبٌ متنوّع التّعابير والأجناس، ومن جهةٍ أخرى، احتفاءٌ بالدّارس والمبدع والفنّان وكلّ من يشتغل بهذه اللّغة. ولذلك كان من أهداف هذه الورقة تثمين الإبداع الشّعريّ الأمازيغيّ المغربيّ التّقليديّ في انتظار جمعه وتدوينه وتحقيقه وتدريسه.
[1]– التّكنيز المصطلحيّ: وضع المكانز المصطلحيّة (Thesaurus) سواء بتأليف المعاجم العلميّة والفنيّة المختصّة أو بالتّخزين في الحواسيب.
[2]– أَمَارِيرْ (ج. إِمَارِيرْنْ): الشّاعر السّوسيّ (الرَّايْسْ “ج. الرّوَايْسْ”) الّذي ينشد ويرتجل الشّعر في محفل “أَحْوَاشْ بفضاء “أَسَايْسْ” (المرقص).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(°) أستاذ باحث في اللّسانيّات وعلوم التربية، من أعماله: “معجم المعاني أمازيغي عربي”، “التواصل في المنظومة التربوية في المغرب”، “النظرية الحقلية والصناعة المعجمية الموضوعاتية”..
البيبليوغرافيا
البيبليوغرافيا العربية፡
ابراهيم ابن مراد. (1997). مسائل في المعجم (ط. 1). بيروت: دار الغرب الإسلامي.
أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السّكاكي. (2000). مفاتيح العلوم. بيروت، لبنان: دار الكتب العلميّة.
أحمد عصيد. (1992). هاجس التّحديث في النّص الشّعريّ الحديث. مجلّة آفاق (1)، الصفحات 135 – 140.
أحمد عصيد. (2016). دراسات في الأدب الأمازيغيّ. (منشورات المعهد الملكيّ للثّقافة الأمازيغيّة، المحرر) الرّباط: مطيعة المعارف الجديدة.
الجاحظ. (1977). البيان والتبيين (المجلد 1). بيروت، لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
الحسين أسكنفل. (2004). تاريخ الأدب الأمازيغي مدخل نظري سلسلة الدراسات الفنية والأدبية. (منشورات المعهد الملكيّ للثّقافة الأمازيغيّة، المحرر) الرباط: المعارف الجديدة.
الحسين أسكنفل. (2006). التّحوّلات في الشّعر الأمازيغيّ الحديث- السياق الاجتماعيّ والوعي الفنّيّ (الشّعر الأمازيغيّ بسوس). (المعهد الملكيّ للثقافة الأمازيغيّة، المحرر) تاريخ الأدب الأمازيغيّ مدخل نظريّ، الصفحات 89 – 110.
الحسين أمصحو. (2013). مفهوم الشّعر في الأدب الأمازيغي. تأليف المعهد الملكيّ للثّقافة الأمازيغيّة (المحرر)، الأنماط الشّعريّة الأمازيغيّة التّقليديّة. الرّباط، المغرب: مطبعة المعارف الجديدة.
الحسين مجاهد. (1989). معلمة المغرب. (الجمعيّة المغربيّة للتّأليف والتّرجمة والنّشر، المحرر) سلا، المغرب: مطابع سلا.
الحسين مجاهد. (1991). الأدب الأمازيغي بالمغرب. تاسكلا ن تمازيغت: مدخل للأدب الأمازيغي (الصفحات 15 – 85). أكادير: منشورات الجمعية المغربيّة للبحث والتّبادل الثّقافيّ.
الحسين مجاهد. (2004). تاريخ الأدب الأمازيغيّ: مدخل نظري. (منشورات المعهد الملكي للثّقافة الأمازيغيّة، المحرر) الرّباط: المعارف الجديدة.
المختار السّوسيّ. (1959). خلال جزولة. تطوان، المغرب: المطبعة المهديّة.
بلعيد بودريس. (2015). مشاهدات في حقوق الإنسان. الرّباط، المغرب: مطبعة المعارف.
حميد بوحبيب. (2013). الشّعر الشّفويّ القبائليّ: السّياق والبنيات والوظائف (مقاربة أنثربولوجيّة). الجزائر: دار التّنوير.
حميد عبد العزيز. (2012). وظيفة علم المصطلح في الثّقافة المعاصرة. (مختبر البحث في العلاقات الثّقافيّة المغربية – الإيبيريّة، المحرر) أبحاث في المنهج واللّسانيّات والأدب(2)، الصفحات 141 – 148.
خالد فهمي . (2003). تراث المعاجم الفقهية في العربية (المجلد ط. 1). القاهرة: إيتراك للطباعة والنشر.
خديجة عزيز. (3 ماي, 2017). خصوصيات الشّعر الأمازيغي بالمغرب. تم الاسترداد 16-01-2021 من هسبريس: https://www.hespress.com
سعيدي مولودي. (2006). مقدّمة نظريّة لتاريخ الأدب الأمازيغيّ: مدخل نظريّ. (منشورات المعهد الملكي للثّقافة الأمازيغيّة مستديرة، المحرر) موائد مستديرة، 20 – 21.
سعيدي مولودي. (2018). مدخل إلى الأدب الأمازيغيّ بالأطلس المتوسّط. (منشورات جمعيّة أجدير إيزوران للثّقافة الأمازيغيّة بخنيفرة، المحرر) الرّباط، المغرب: مطبعة الرّباط نت.
سيلفيا بافيل وديان نوليه. (2001). دليل المصطلحيّة. (ترجمة خالد الأشهب، المترجمون) كيبيك: وزارة الأشغال العموميّة والمصالح الحكوميّة، كندا.
شحاذة الخوري. (1989). دراسات في الترجمة والمصطلح والتعريب. بيروت، لبنان: دار طلاس للدراسات والترجمة.
طه عبد الرّحمان. (2006). روح الحداثة – المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلاميّة. الدار البيضاء، المغرب: المركز الثّقافي العربيّ.
عباس الجراري. (1971). من وحي التّراث. الرّباط: مطبعة الأمنية.
عبّاس الجراري. (غشت, 1978). معجم مصطلحات الملحون الفنّيّة، ، السّنة الخامسة، خ: 1، ،. مجلّة الفنون، 1.
عبد الرّحمان ابن خلدون. (1965). المقدّمة. القاهرة، مصر: دار البيان العربي.
عبد العزيز بن عبد الجليل. (غشت, 1978). ، الموسيقى الشعبيّة المغربيّة، ، السّنة الخامسة، ع: 1، ،. مجلّة الفنون(1).
على القاسمي. (1987). مقدّمة في علم المصطلح. القاهرة، مصر: مكتبة النهضة المصريّة.
علي القاسمي. (مطبعة المعارف الجديدة, 2008). علم المصطلح: أسسه النّظريّةوتطبيقاته المنهجيّة. بيروت، لبنان: مكتبة لبنان ناشرون.
علي بن محمد الجرجاني. (1998). التعريفات (المجلد ط. 4). بيروت، لبنان: دار الكتاب العربي.
عمر أمرير. (1987). أمالو من الفنون الشّعبيّة المغربيّة. الدّار البيضاء: مطابع الكتاب.
فؤاد أزروال. ( 12 – 13 مارس , 2004). الملتقى الأول للأدب الأمازيغيّ . وجدة، المغرب، كلّية الآداب والعلوم الإنسانيّة جامعة محمد الأوّل.
فيليب سيرينج،. (1992). الرّموز في الفنّ، الأديان، الحياة، (ترجمة عبد الهادي عبّاس، المترجمون). دمشق، سوريا: دار دمشق.
قسوح اليماني، وعبد المطلب الزيزاوي. (يونيو, 2006). الشعر الأمازيغي بالريف: مقاربة تاريخية (الجزء الثاني). تاريخ الاسترداد 02 02, 2021، من تاويزا: http://tawiza.byethost10.com/Tawiza110/yamani1.htm
قيس مرزوق الورياشي. (1986). شعر الشّعب وشعر النّخبة (محاولة في سوسيولوجيّة التّمايز). جوانب من الأدب في المغرب الأقصى. 1، الصفحات 63-96. وجدة: كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة سلسلة ندوات.
ماري كلود لوم. (2012). علم المصطلح مبادئ وتقنيات. (ريما بركة، المترجمون) بيروت، لبنان: المنظّمة العربيّة للتّرجمة.
محمد أرجدال. (21 – 22 دجنبر, 2011). تأمّلات في الشّعر الأمازيغي الحديث. أعمال الندوات، الصفحات 53 – 68.
محمّد أرجدال. (2016). تأمّلات في الشّعر الأمازيغيّ الحديث. عمال النّدوة الوطنيّة المنظّمة برحاب كلّية الآداب والعلوم الإنسانيّة (الصفحات 53 – 55). أكادير: طبع ونشر سوس – أكادير.
محمّد المسعودي، و بوشتّى ذكيّ. (1999). الشّعر الغنائيّ الأمازيغيّ (الأطلس المتوسّط نموذجاً). طنجة: وكالة شراع لخدمات الإعلام والاتّصال.
محمّد أوسوس. (2010). بعض الملامح العامّة للتّجربة الشّعريّة الشّبابيّة الأمازيغيّة الحديثة بسوس. (المعهد الملكي للثّقافة الأمازيغيّة، المحرر). أسيناك، 4 – 5، الصفحات 41 – 54.
محمد رواس قلعه جي، و حامد صادق قنيبي. (1985). معجم لغة الفقهاء (المجلد ط. 1). بيروت: دار النّفائس للطّباعة والنشر والتّوزيع.
محمد شفيق. (1991). المعجم الأمازيغي العربي (المجلد 1). (منشورات أكاديميّة المملكة المغربيّة، المحرر) الرباط: الفن التاّاسع.
محمّد شفيق. (2000). من أجل مغارب مغاربيّة بالأولويّة، ط: 1، (مركز طارق بن زياد للدّراسات والأبحاث، المحرر). الرّباط، المغرب: المعارف الجديدة.
محمّد صاري. (2009). الأوهام الشّائعة عن المصطلح العلميّ – المصطلح اللّسانيّ نموذجاً. المصطلحيّة والتّرجمة في خدمة الإعلام والاقتصاد والعلوم.
محمود فهمي حجازي. (1995). المصطلحات العلميّة في اللّغة العربيّة في القديم والحديث. القاهرة، مصر: دار غريب للطّباعة والنّشر والتّوزيع.
مصطفى الشّهابيّ. (1995). المصطلحات العلميّة في اللّغة العربيّة في القديم والحديث. بيروت، لبنان: دار صادر.
مفتاحة اعمر، و آخرون. (2017). المعجم العامّ للّغة الأمازيغيّة (أمازيغيّ – فرنسيّ – عربيّ) (المجلد 13). (منشورات المعهد الملكي للثّقافة الأمازيغيّة، مركز التّهيئة اللّغويّة، سلسلة قواميس ومعاجم، المحرر) الرّباط، المغرب: مطبعة المعارف الجديدة.
هنري بيجوان، و فيليب توارون. (2009). المعنى في علم المصطلحات. (ريتا خاطر، المترجمون) بيروت، لبنان.
البيبليوغرافيا الأجنبية:
Alain Rey. (1979). la terminologie : Noms et notions. Paris: puf.
Daniel Gouadec. (1990). Terminologie Constitutions des données. Paris: afnor gestion.
Depecker Loïc. (2003). Entre signe et concept፡ Eléments de terminologie générale. Paris: Presse Sorbonne Nouvelle.
Guy Rondeau. (1984). Introduction à la terminologie (المجلد 2ème édition). Québec: Gaëtan Morin.
Henrik Nilsson. (2010). Towards a National Terminology Infrastructure, The Swedish Experience, in፡ M. Amsterdam The Netherlands Philadelphia: arcel Thelen and Frieda Steura Eds., Terminology in Everyday Life ,John Benjamins Pub.
Juan Sager. (1990). A Pratical course in Terminology Processing. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.
Mamel Célio Conceiçào. (2005). Concepts, termes et reformulations. Lyon: Presse universitaire de Lyon.
Miloud Taifi. (1990). Dictionnaire Amazighe du Moyen Atlas. Paris: l’Harmattan.
Miloud Taifi. (1991). Dictionnaire tamazight – français (parler Maroc central), , . Paris: l’Harmattan, Awal.
Tassadit, Y. (1990). L’Izli ou l’amour chanté en kabyle. Alger: Ed Bouchène-Awal.
Teresa Cabré. (Décembre , 1994). Terminologie et Dictionnaires” – –Vol :-n°––pp: . 39(4 )، الصفحات 589-598.












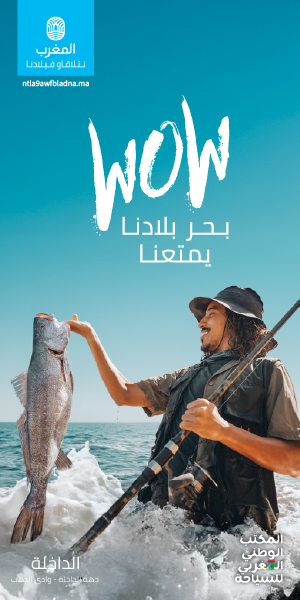
تعليقات
0