-
د. محمد أمحدوك (°)
ملخص:
لمّا كانَ دورُ المدرّسِ هو تكوينُ الفرد والمساهمةُ في إدماجه بالمحيط السّوسيوثقافيّ والاقتصاديّ، وكانت الأعمالُ الفنّيّةُ محاولةً دؤوبةً لأنسنةِ الواقعِ والتسامِي بهِ، وكانت السّينمَا، في أحد اتّجاهاتها، محاكاةً للواقع ورصدًا دقيقا لتحوّلاته المختلفة، فإنّ شرعيّة التّساؤل تتجلّى أساسا في الكيفيّةِ الّتي يمكن من خلالها تقييم تجربة الإبداع السّينوغرافيّ “التّربويّ” في المغرب.
فهل ثمّة حلولٌ “سينمائيّة”ٌ ناجعةٌ من شأنها المساهمة في تجاوزِ حالِ الأزمةِ الّتي تنقضُ ظهر المدرسة المغربيّة؟ وإلى أيّ مدى كان المخيالُ السّينوغرافيّ المغربيّ موضوعيّا في رصد الواقعِ الاجتماعيّ -التّربويّ للمدرّس؟ وما المعالم الّتي تحدّدها الوثائق الرّسميّة والتّقارير الدّوليّة لأوضاعه الاجتماعيّة والتّربويّة؟
يفرضُ الجوابُ عن هذه الأسئلة حزمةً من الإجراءاتِ التّحليليّة، ويدعو إلى ملامسة مفاهيم وتصوّرات خاصّة. لذلك كان لا بدّ من قراءة جوانب مختلفة من المنجز السّينمائيّ المغربيّ، والبحث في أسس الممارسة السّينوتربويّة، مع فحص العلاقات التّربويّة داخل الثّالوث: المدرّس – المجتمع – السّينما، باستثمار البعدين التّواصليّ-السيميولوجي والسّيكو سوسيولوجيّ.
-
مقدمة
لمّا كان دور المدرّس هو تكوين الفرد والمساهمة في إدماجه بالمحيط السّوسيو ثقافيّ والاقتصاديّ، وكانت الأعمال الفنّيّة خلاصة التّجربة الإنسانيّة في المجتمع ومحاولة دؤوبة لأنسنة الواقع والتّسامي به، وكانت السّينما، في أحد اتّجاهاتها، محاكاة للواقع ورصدا دقيقا لتحوّلاته المختلفة، فإنّ شرعيّة التّساؤل تتجلّى أساسا في الكيفيّة الّتي يمكن من خلالها تقييم تجربة الإبداع السّينمائيّ “التّربويّ” في المغرب. فهل ثمّة – حقيقةً – حلولٌ “سينمائيّةٌ” ناجعةٌ من شأنها المساهمة في تجاوُز حالة الأزمة الّتي تنقض ظَهر المدرسة المغربيّة؟ وإلى أيّ مدى كان المخيال السّينوغرافيّ المغربيّ موضوعيّا في رصد الواقع الاجتماعيّ-التّربويّ للمدرّس؟. وقبل ذلك، كيف تبدو صورة المدرّس في الواقع السّوسيو تربويّ المغْربيّ؟ وما المعالمُ الّتي تحدّدها الوثائقُ الرّسميّة والتّقارير الدّوليّة لأوضاعه الاجتماعيّة والتّربويّة؟
يفرض الجوابُ عن هذه الأسئلة حزمةً من الإجراءات التّحليليّة، مثلما يدعو إلى ملامسة مفاهيم وتصوّراتٍ ومناهج خاصّةٍ، والاستناد إلى حقولٍ معرفيّةٍ متعدّدةٍ (السّوسيولوجيا، والبيداغوجيا، والسّيميولوجيا، والتّواصل…). لذلك كان لا بدّ من قراءة جوانب مختلفةٍ من المنجز السّينمائيّ المغربيّ، والبحث في أسس وتصوّرات الممارسة السّينوتربويّة، وخلخلة بعض القناعات الرّاسخة فيها، مع فحص جملة من العلاقات التّربويّة داخل الثّالوث: المدرّس – المجتمع – السّينما.
ومن ثمّة توخّت هذه الدّراسة ممارسة نوع من النّقد على بعض المسلكيّات “السّينوتربويّة” الّتي أصبحت نشازات سوسيو ثقافيّة في الوسط الفنّيّ، وطرح هموم المدرّس وقضاياه المتشعّبة في المجتمع المغربيّ اعتمادا على المنظور السّينوغرافيّ، باعتباره مرآة تقرّب للمشاهد حقيقة واقعه الاجتماعيّ، ومبصارا يشخّص من خلاله طبيعة نظرة المجتمع إليه، وذلك لفتح آفاق جديدة لاشتغال العلاقة مدرّس / مجتمع، الأمر الّذي سيساهم لا مرية في خلق فضاءات أوسع للتّفكير والتّأمّل، ومن ثمّ الدّفع بالثّالوث السّابق نحو تجاوز حالة الأزمة الّتي يعيشها المدرّس المغربي ومعه المؤسّسات التّربويّة.
أولا: وضعيّة المدرّس في الواقع السّوسيو تربويّ المغربيّ
إذا كانَ المتعلّمُ، وفق المقاربات التّربويّة الحديثة، محورَ العمليَّةِ التّعليميَّةِ التّعلّميَّةِ، فإنّ المدرّسَ، بحكم عمله وعلاقاته وتخصُّصه واتّصالاته، هو جوهر هذه العمليّة برمّتها، ما دام المسؤولَ المباشر عن مهنة التّدريس، والمعنيّ الأوّل بتنشئة الفرد وبناء شخصيّته، ومن خلال الفرد تنشئة جميع فئات المجتمع وتكوينها. لكنّ المتأمّل في العقود الأخيرة للمنظومة التّربويّة المغربيّة، يجد فيها ضرراً كبيراً لحق كيان المدرّس وهيبته، بل ودفعت به إلى أرذل مقام، بعدما كان، لقرونٍ طويلةٍ خلت، رأس المجتمع والمشكاة الّتي يهتدى بنورها.
حتّى لا يكادُ يمرّ يومٌ إلّا وصفحات وسائل الإعلام، بمختلف ألوانها وأشكالها، مصدّرة، وبالبنط العريض، بخبرٍ عن مدرّسٍ تعرّض لضربٍ أو جرحٍ أو تنكيلٍ… فما يكون من المتعلّم، وهو المتتبّعُ الدّؤوب للتّكنولوجيّات الحديثة، إلّا اقتناصَ تلك المشاهد ومحاولة تنزيلها على أرض الواقع. فكيف تقدّمُ التّقارير الدّولية والوثائق الرّسميّة المغربيّة “مربي الأجيال”؟ وما الصورة الّتي بات يظهر عليها اجتماعيّا؟
-
صورةُ المدرّسِ المغربيِّ في بعْضِ التّقاريرِ الدّوليّةِ والوثائِقِ الرَّسْميّة
أكّد التّقرير الّذي قدّمته اللّجنةُ الدّوليّةُ المعنيّةُ بالتّربية للقرن الحادي والعشرين لمنظّمة الأمَمِ المّتّحدة للتّربية والعلم والثّقافة (اليونيسكو) سنة 1996م أنّ المدرّس يشعر، أنّه وحيدٌ معزولٌ، لأنّه يقوم بنشاطٍ فرديٍّ فقط، ولكن أيضا بسبب أهمّية التّوقّعات الّتي يتعرَّضُ لها والّتي كثيرا ما تكون جائرَةً، وهو يودّ قبل كلّ شيء أن تحترم كرامته (ديلور و آخرون، 1996، صفحة 27). ولذلك خلُصَ إلى أنّ عمليّة إعداد المدرّس تحتاج إلى إعادة نظرٍ كاملةٍ، وأنّه لتحسين نوعيّة التّعليم، ينبغي أوّلا تحسين أحواله من حيث وضعه الاجتماعيّ ومناهج تكوينه وظروف عمله، لأنّه لن يكون قادرا على الوفاء بما يُطلبُ منه إلّا إذا اكتسبَ المعارفَ والمهاراتِ والقُدُراتِ المهنيّةِ، والإرادة القويّة… وهو ما يمكن تلخيصه في النّقط الأربع الآتية:
-
تحسين الوضع الاجتماعيّ للمدرّس: لأنّ وضعه الاجتماعيّ بات ضعيفاً مقارنةً مع التّطَوّراتِ الاقتصاديَّةِ المتلاحقةِ والمستوى المعيشيّ المتسارع، أصبح المدرّس في السّنين الأخيرة يفكّر في البحث عن موارد أخرى يحسّن بها وضعه الاجتماعيّ والاقتصاديّ (السّاعات الإضافيّة – المهن الحرّة…)، وهو ما أثّر / يؤثّر كثيرا في عطائه التّربويّ داخل الفصل الدّراسيّ.
-
الإرادة القويّة: ينبغي في هذا الصدّد أن يتقدّم لمهنة التّدريس من كانت له فعلا عزيمة قويّة ورغبة جامحة في هذه المهنة، وليس كلّ من يريد الخروج فقط من غيابات البطالة وشظف العيش.
-
الرّفع من جودة ظروف العمل: لا سيّما مع حجم الاكتظاظ والضّغط والأعباء المتزايدة الملقاة على عاتق المدرّس، فضلا عن المذكّرات الوزاريّة الّتي أضحت تعبث بهيبته، وتصون المتعلّم أكثر منه(وزارة التربية الوطنية، 2014م)؛ حيث تحوّلت الفصول الدّراسيّة في العقود الأخيرة إلى حلبات للصّراع والشّنآن. وعوض أن يفكّر المدرّس في المنهج الأمثل لتبليغ المحتويات الدّراسيّة، أضحى ينصرف إلى إرساء قواعد البيئة المشجّعة على التعلّم، وتحييد ضغوط السّياقات المشحونة، فكانت النّتيجة ضياع الجهد، وهدر الزّمن البيداغوجيّ، وتراجع دافعيّة التّعليم والتّعلّم.
-
تجويد القدرات المهنيّة للمدرّس: في سياق التّحوّلات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والتّكنولوجيّة المتسارعة الّتي عرفها المغرب في العقود الأخيرة، صار الاقتصار في إعداد المدرّس على مرحلة التّكوين في المراكز الجهويّة لمهن التّربية والتّكوين غير كاف، لذا تتحتّم متابعة المدرّس في الفصل ومصاحبته بتكوينات مستمرّة تزيد من فعاليّة أساليبه ومهاراته ومعارفه.
وارتهن الميثاق الوطنيّ للتّربية والتّكوين (1999م)، من جهته، تجديد المدرسة المغربيّة بجودة عمل المدرّس وإخلاصه والتزامه. والجودة في هذا السياق مرتبطة بالتّكوين المستمرّ الفعّال والمستديم، والوسائل التّربويّة الملائمة، والتّقويم الدّقيق للأداء البيداغوجيّ (المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلميّ، 1999). ولذلك عرض سمات خاصّة يفترض أن تميّز المدرّس النّشيط، منها:
-
السّمات المعرفيّة التّكوينيّة: وذلك عبر تمكين المدرّس من تكوين رصين قبل استلامه لمهامّه التّربويّة والتّعليميّة(المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلميّ، 1999). وقد حدّدت هذه الوثيقة مجموعة من الأسس القويمة الّتي يمكن أن تزيد من متانة التّكوين الأساسيّ للأطر التّربويّة عامّة، كالتّكوين الذّاتيّ المستمرّ، وتعزيز التّكوين الأساس في التّخصّصات المتعلّقة بالتّواصل والتّنشيط الثّقافيّ والتّكنولوجيّات الحديثة…
-
السّمات التّدريسيّة المنسجمة مع روح العصر: وهي سماتٌ ترتبطُ أساسا بالمعارف والأداء والنّتائج. وقد أمست من خلالها المتطلّباتُ الحديثةُ في إعداد المدّرس منحصرةً في ثلاث دعاماتٍ كبرى: الدّعامة المعرفيّة الخاصّة بالتّخصّص، والدّعَامة التّواصُليّة المرتبطة بتبليغِ المعارفِ وإدارةِ الفصل الدّراسيّ، والدّعَامَة الثّقافيّةِ الخاصّة بالإعدادِ العَامِّ.
ويأتي الرّفعُ من جودةِ عملِ الفاعلاتِ والفاعلين التّربويّين (مدرّسين ومكوّنين ومؤطّرين وباحثين ومدبّرين…)، في مقدّمة الأولويّات الكفيلة بالنّهوض بأداء المدرسة بمختلف مكوّناتها، وتحسين مردوديّتها، وإنجاح إصلاحها. ولذلك دعا المَجْلسُ الأعلَى للتّربية والتّكوين والبحث العلميّ في الدّعامَة التّاسِعة من الرّؤية الاستراتيجيّة 2015 – 2030 المرتبِطَة بتجديد مهن التّدريس والتّكوين والتّدبير إلى العمل على إتقان تكوينهم وحفزهم، وإعادة الاعتبار لأدوارهم، واحترام كرامتهم، وتحسين ظروف مزاولتهم للعمل (المجلس الأعلى للّتربية والتكوين والبحث العلميّ، 2015، صفحة 27).
ومن حيث الأدوار والهيئات، أكّدت الرّؤية الاستراتيجيّة للإصلاح، “على الإحاطة الشّاملة بالمَهَامّ الموكولة للمدرّس، التّربويّة منها والتّقييميّة والاجتماعيّة والثّقافيّة والتّواصُليّة، وضَبْطِها والتّنصيص القانونيّ عليها، واعتمادها كأساس لتحديد المسؤوليّة، والتّقييم، والتّرقي المهنيّ، والحرص على تطوير التّكوين في اتجاه دَعم التّخصّص، ولا سيّما في التّعليم الابتدائيّ” (المجلس الأعلى للّتربية والتكوين والبحث العلميّ، 2015، صفحة 25).
وحرصا على انتقاء أجود الكفاءات، والاختيار الأمثل للأجيال الجديدة من المدرّسات والمدرّسين، أكّدت هذه الوثيقة التوّجيهيّة على ضرورة اعتماد معايير محدّدة لولوج مهن التّربية والتّكوين تتمثّل أساسا في: الجاذبيّة للمهنة، والاستعدادات النّفسيّة والمعرفيّة والقيميّة، والتّوافر على المعارف والمؤهّلات والكفايات الضّروريّة وفق ما يستلزمه الإطار المرجعيّ لكفايات المهنة (المجلس الأعلى للّتربية والتكوين والبحث العلميّ، 2015، صفحة 25).
في حين ركّزت المذكّرة الوزاريّة 15/099 المتعلّقة بالتّدابير ذات الأولويّة لتنزيل الرّؤية الاستراتيجيّة على ضرورة مصاحبة المدرّسين أثناء مزاولتهم لمهامّهم، للرّفع من مستوى أدائهم المهنيّ داخل الأقسام الدّراسيّة، وتشجيع الأساتذة على استثمار التّجديدات التّربويّة، وتعزيز تقاسم الخبرات بين المدرّسين (التّدبير رقم 15). كما حثّت على أهميّة الرّفع من جودة التّكوين الأساس للمدرّسين وتزويد المنظومة التّربويّة بأطر ذات كفاءات عالية (التّدبير 16) (وزارة التّربية الوطنيّة والتّكوين المهني والتّعليم العالي والبحث العلمي، 2015م).
وحيث إنّ ضمان تعليم ذي جودة للجميع يستلزم اتّخاذ الإجراءات اللّازمة لذلك، وعلى رأسها: تجديد مهن التّدريس والتّكوين والتّدبير، وبخاصّة في الوسط القرويّ أو في الهامش الجغرافيّ للمغرب، دعا القانون الإطار رقم 51.17 المتعلّق بمنظومة التّربية والتّكوين والبحث العلميّ إلى “وضع نظام خاصّ لتحفيز وتشجيع الأطر التّربويّة والإداريّة على ممارسة مهامّها بالأوساط القرويّة والمناطق ذات الخصاص (من أجل تعميم التّعليم الإلزاميّ بالنّسبة لجميع الأطفال البالغين سنّ التّمدْرُس)” (وزارة التّربية الوطنيّةوالتكوين المهنيّ والتّعليم العالي والبحث العلميّ، 2019)، و”تمكين أطر التّدريس والتّكوين والبحث من اكتساب كفايات لغويّة متعدّدة، مع تقييدهم باستعمال اللّغة المقرّرة في التّدريس دون غيرها من الاستعمالات اللّغويّة” (وزارة التّربية الوطنيّةوالتكوين المهنيّ والتّعليم العالي والبحث العلميّ، 2019).
نَخْلُصُ بعد هذا الجرْدِ المقتضب للمقوّمات الأَسَاسيّة الّتي ينْبَغِي أنْ تتوفّر في المدرّس بناء علَى مَضَامِين وتوجيهات الوثَائق الرّسميّة والتّقارير الدّوليّة إلى تحديد أهمّ الأدوار المنوطة به في ضوء التّغيّرات الحالية، وهي لا تخرجُ على ثلاثة أدوارٍ كُبرى: التّدريس – البحث العلميّ – خدمة المجتمع (Eble, 1972, p. 110). وكلّها تقتضي بيئةً اجتماعيّةً خاصّةً تشجِّعُهُ وتشدّ بأزره، بيد أنّهُ أصبحَ في العقودِ الأخيرَةِ، ولأسبابٍ كثيرةٍ، مادَّةً دَسِمَةً للسّخريَّةِ والاسْتِهْزَاء.
-
صُورةُ المُدرّس فِي الوَاقِعِ الاجْتِمَاعِيّ المَغْرِبِيّ
سَاعَدَت الاختلالاتُ والانحرافاتُ الّتي طالَتْ مهْنَةَ التّعليمِ علَى رَسْم صورةٍ سيّئةٍ في أذهانِ النّاس عن المدرّس، وعظمت فيها المبالغة إلى الدّرجة الّتي أصبح معها في الدّرك الأسفل من الهرم الاجتماعيّ المغربيّ، حتّى أضحى يصدُق عليه ما رواه الجاحظ من أمثال العامّة “أحمقُ من معلّمِ كُتّاب”، وما رواه عن بعض الحُكَمَاء، حينَ قال: “لا تستشيرُوا معلّما، ولا راعي غنم، ولا كثير القعود مع النّساء” (الجاحظ، 1968، صفحة 136). فأسيء إلى سمعة المعلّم، وصارت عبارة “معلّم الصّبيان” مثلا يضرب للضّعة والامتهان. ومن ثمّ تراجعت مكانة المدرّس في المجتمع، وفقد كثيرا من هيبته وبريقه، بالنّظر إلى ما كان عليه في العُهُود السّابقة، ولعلّ ذلك يرجعُ إلى تضافُر جملةٍ من العواملِ الاجتماعيّةِ والاقتصاديّة والثّقافيّة…، من قبيل:
-
اضطراب المنظومة القيميّة للنّسق التّربويّ: يتجسّد ذلك في سنّ تشريعات تقوم على جعل المتعلّم في قلب الاهتمام والتّفكير، في مقابل التّقليل من شأن المدرّس وتحجيم دوره. ولا أدلّ على ذلك من عدم الأخذ بقرارات المجالس التّربويّة الّتي يشارك في تدبيرها وخلاصات التّقارير الدّوريّة الّتي تخرج عنها، فضلا عن المذكّرة الوزاريّة الخاصّة بالإجراءات التّأديبيّة لمجلس القسم، الّتي صادرت حقّه في زجر المتعلّم وتوقيفه، إذا ما صدر عنه ما يمسّ جوهر السّيرورة التّعليميّة بالمؤسّسة(وزارة التّربية الوطنيّةوالتكوين المهنيّ والتّعليم العالي والبحث العلميّ، المذكّرة 14 / 867، 2014).
-
العامل الاقتصاديّ – الاجتماعيّ: حيث أضحت أجرةُ المدرّسِ لا تكفيهِ في قضاءِ حاجاته وصَوْنِ كرامته، ممّا أثّر بشكلٍ كبيرٍ في عطائِهِ التّربويّ. أضفْ إلى ذلِكَ عدم استفادته من الحقوقِ الأسَاسيّة (المادّية والمعنويّة)، حَتّى صارَ اليومَ الحَلَقَةَ الأضْعَفَ في المجتمعِ، والمتّهم الأوّل في فَشَلِ جُلّ المشاريعِ الإصلاحيّة المرتبطة بالمنظومة التّربويّة المغربيّة. كما أنّ تراجع المستويات المعيشيّة لعامّة المغاربة، جعل أغلبيّة المتخرّجين تتهافت للخروج من شرنقة البطالة، فدخل المهنة من كان مستواه العلميّ والوجدانيّ دون متطلّبات هذه الوظيفة الحسّاسة، وأصبح التّعليم مهنة من لا مهنة له.
-
الميز السّلبيّ لمهنة التّعليم: حيث أضحى يَلِجُهَا الفاشلون من الولوج لكلّيات الهندسة والطّبّ والتّقنيات الحديثة، فلو كانت جاذبيّة هذه المهنة أقوى مادّيا واجتماعيّا لَدَخَلَ حَقْلَ التّعليم رجالٌ ونساءٌ أكفاء، وتغيّرت بذلك النّتائج.
-
قُصُورات على مستوى الحياة المدرسيّة: ترتبط هذه القصورات ببنية الأقسام، وضعف الإمكانات المادّية والتّقنية اللّازمة ليؤدّي المدرّس مهامّه على أكمل وجهٍ، فضلا عن تلك الأخلال المرتبطة بأنماط الحكامة الإداريّة وأساليبها.
-
تراجع التّأطير النّقابيّ: لا مِرْية أنّ المؤسّسات النّقابيّة في المغرب تعْرفُ تراجعاً كبيراً، ممّا نحا بأغلب المدرّسين إلى رفض الانخراط في هذا المشهد البارد. فإذا كان، سلفا، دور العمل النّقابيّ منصبّا على الاهتمام بمعالجة هموم المدرّس ومقاسمته انشغالاته، فقد توجّهت أنظاره، في العقود الأخيرة، إلى العمل السّياسيّ والتّهافت على المناصب والمكاسب الشّخصيّة الضيّقة.
-
تطوّر التّكنولوجيّات الحديثة: في ظلّ تراجُعِ دور الأسرة، وارتفاع نسبة البطالة في صفوفِ الشّبابِ، وضعف حملات التّوعية الهادفة من الإعلام وجمعيّات المجتمع المدنيّ، أثرّت الدّيناميّة الكبيرة الّتي شهدتها التّكنولوجيا الحديثة على أفكار المتعلّمين، وجعلتهم لا يبالون بالتّحصيل والتعلّم، فانتكس تواصلهم مع المدرّسين، وتراجعت مردوديّتهم التّربويّة(البرجاوي، 2017م، صفحة 130).
وقد تضافرت هذه العوامل كلّها لتسفرَ عن وضع اجتماعيّ مقلق يحزّ في نفس المدرّس المغربيّ. لكن، ما دامت أغلب النّتائج التّربويّة الإيجابيّة يقف وراءها مدرّس أتقن دوره، وتحمّل مسؤوليّته، وكرّس حياته للعمل الجماعيّ، ومعالجة جلّ الإكراهات الّتي تعوق السّير العادي للمؤسّسة التّعليميّة، ستسمو لا ريب مكانته الاجتماعيّة، وسيكسب رضا مختلف الفاعلين التّربويّين والاجتماعيّين، مهما تعالت محاولات التّشويه والتّشهير والسّخريّة… ومن ثمّة فالمدخلُ الصّحيحُ لأيّ إصلاح تعليميّ لا بدّ أن يضع في الحسبان تأهيل المدرّس، لأنّه هو الّذي يجعل المتعلّم متفاعلا ومفكّرا ومبدعا في مختلف العلوم، وهو من يؤهّله ليصبح شخصية ذات أنماط متعدّدة ومتوازنة، بعد تنمية قدراته وصقل مهاراته الأساسيّة (بنيونس، 2015، صفحة 10).
وحيث إنّ الأعمالَ الفنّيّة هي مرآة للمجتمع يَكشفُ من خلالها على قضاياه وبنياته المختلفة، وحلم يرسم واقعا يرنو الوعي الجمعيّ لتحقيقه، كان من الطّبيعيّ أن تعالج السّينما، منذ بداياتها في المغرب، موضوع المدرّس بإشكالاته وقضاياه المتعدّدة. لكنّ السّخريّة وشمت أعمالها، حيث قدّمت المدرّس في قالب فارغ وضمن شخصيّات كاريكاتيريّة سطحيّة، ولو أنّ أعمالا محدودة قاومت هذا الاتّجاه، وقدّمت له نماذج إيجابيّة.
وعموما، لم يكن المدرّس على مدار عقود طويلة موضوعا أساسيّا في الفنّ والأدب المغربيّين، ولا العنصر الأهمّ الملازم للسّرد السّينوغرافيّ، بما يجعلنا قادرين على الحديث، كما سيأتي في الأسطر اللّاحقة، عن صور بعينها اعتمدها المخرجون المغاربة، ظهر فيها المدرّس أداة للتّعبير عن العديد من القضايا الكبرى الّتي شغلت الرّأي العامّ في فترات زمنيّة متفاوتة، ولو أنّه يحضر تارات طرفا بارزا في بعض منعطفات الحبكة السّينمائيّة.
فإلى أيّ حدٍّ تمكّن إذن الطّرْحُ الدّراماتولوجيّ السّينمائيّ المغربيّ من تقديم ومعالجة مختلف القضايا الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثّقافيّة للمدرّس؟
ثانيا: صورة المدرّس في السّينما المغربيّة: دراسة وصفيّة تحليليّة
بفعل العوامل الاقتصاديّة والمعيشيّة الصّعبة الّتي ما فتئ يمرّ بها المغاربة قاطبةً، حوّلت الشّاشةُ الكبيرَةُ المدرّسَ المَغْرِبيّ إلى تاجرَ علمٍ ومادّة خاماً للسُّخريّةِ الدّرَاميّةِ. وقد انتهجَ السّينمائيّونَ المغاربةُ هذا النّهْجَ المتهكّمَ من المدّرسِ في كثيرٍ من الأعمال، ففصّلوا مشاهد كثيرةً تعبّر بأسلوبٍ فكهٍ عن ظروفهِ المادّية والاجتماعيّة المزرية. وقد اتّسم هذا الخطابُ السَّطْحيّ، ما عدا في حالاتٍ خاصّةٍ محدودةٍ، بتهميش دوره وقيمته في المجتمع، وإظهاره بصورة البائس الخالي من أيّ نوعٍ من المعرفة، ولا يكاد يدخل إلى الفصل إلّا ليكون هدفاً للسّخريّة والاستهزاء.
ومن ثمّة يبدُو أنّ الأسَاسَ الّذي صارت ترتكز عليه الرّؤيَةُ السّينُوغرافيّةُ المغربيّةُ الحديثَةُ هو تنحية الجانب الإنسانيّ في المُدرّس؛ وتجريده من رسالته السّامية، وإبرازه موظّفا يسعى فقط إلى كسب عيشه، فضلا عن إظهاره منشغلا بهمومٍ شَخصيّةٍ سطحيّةٍ، بعيداً عنْ كلّ ما هو اجتماعيّ أو سياسيّ أو وطنيّ (الحركة الانتقاليّة، والتّرقية، وتقديم الشّواهد الطّبيّة، والإضرابات المستمرّة، والعنف المدرسيّ…).
ومن هذا المنطلق، نروم في هذه الورقة إبراز مدى صدقيّة هذه الدّعوى، واستكشاف مساهمة السّينما المغربيّة في نقل القيم التّربويّة، وبيان بعض الصّور الّتي قدّمت بها المدرّس، وذلك بتحليل مضمون شريطٍ سينمائيٍّ مغربيٍّ عَرَفَ رواجاً كبيراً في القاعات السّينمائيّة المغربيّة.
2 1.عيّنة الدّراسة
قَدْ تكونُ المدرسةُ السّينمائيّةُ المغربيّةُ من بين المدارسِ العربيّةِ الأقلِّ احتفاءً بقضايا المدرّس ووضعه ومعاناته داخل فضاء يشهد تراجعات كثيرة ومفارقات كبيرة على المستويين الاجتماعيّ والاقتصاديّ. فكيف تمّ تقديمُ المدرّسِ في الأنموذجِ السّينمائيِّ المختارِ؟ وإلى أيّ حدٍّ كانتْ السّينِمَا المغربيّةُ منصفةً في نقل الواقع السّوسيوتربويّ للمدرّس؟ وهل كانت المقاربةُ السّينمائيّةُ لمشاكل المدرّس المغربيّ وأوضاعه المعقّدة نابعةً من خيار فنّيٍّ وفكريٍّ أصيلٍ أم كانت مجرّد استجابةٍ لمطالب سوسيو اقتصاديّةٍ معيّنةٍ؟
2.2 الإشكاليّة
قَدْ تكونُ المدرسةُ السّينمائيّةُ المغربيّةُ من بين المدارسِ العربيّةِ الأقلِّ احتفاءً بقضايا المدرّس ووضعه ومعاناته داخل فضاء يشهد تراجعات كثيرة ومفارقات كبيرة على المستويين الاجتماعيّ والاقتصاديّ. فكيف تمّ تقديمُ المدرّسِ في الأنموذجِ السّينمائيِّ المختارِ؟ وإلى أيّ حدٍّ كانتْ السّينِمَا المغربيّةُ منصفةً في نقل الواقع السّوسيوتربويّ للمدرّس؟ وهل كانت المقاربةُ السّينمائيّةُ لمشاكل المدرّس المغربيّ وأوضاعه المعقّدة نابعةً من خيار فنّيٍّ وفكريٍّ أصيلٍ أم كانت مجرّد استجابةٍ لمطالب سوسيو اقتصاديّةٍ معيّنةٍ؟
2 3.البعد المنهجيّ
المنهج المستخدم في الدّراسة هو منهج تحليلِ المَضْمُون الّذي يندرِجُ ضمن الدّراسات الوصْفيّة الّتي تعتمد في جانب كبير منها على الوصف والتّحليل واستخدام الأساليب الكمّيّة والكيفيّة في التّعبير عن البيانات والنّتائج (حسين، د. ت، صفحة 125)، حيث تمّ في البداية عرض بطاقة تقنية عن الشريطِ السّينِمَائيّ، فمتنه الحكائيّ، قبل تحليل بعض الجوانب المرتبطة بصورة المدرّس والرّسالة التّربويّة الّتي نحا الفيلم لتبليغها، ثمّ الخروج بملاحظات واستنتاجات خاصّة مشفوعة بخلاصات عامّة فتوصيات.
-
24. العرض والتّحليل
“القسم 8” فيلم مغربي من إخراج جمال بلمجدوب وإنتاج القناة الثانية المغربيّة سنة 2003م، شارك في بطولته كلٌّ من فاطمة خير، ورفيق بوبكر، وعزيز حطّاب… يُعدّ هذا الفيلم محطَّةً فارقَةً في المسار الإبداعي للمخرج[i]؛ إذ لقي نجاحاً كبيراً، وحاز على جوائز مشرّفة في مسابقاتٍ فنِّيَّةٍ عديدةٍ، مثل «نجوم بلادي» في المغرب، وذلك لما قدمّه من رسائِلَ سُوسيُوتَرْبَويَّةٍ مُرتبِطَةٍ بمعضلة العنفِ المتفشّية في العقود الأخيرة بالفصول الدراسيّة المغربية. لكنّه تعرّض أيضا لنقدٍ شدِيدٍ، واعتبر تجنّياً سافراً على المدرّس، وتحريضاً غير مباشر على العنف المدرسيّ ذاته، ومساساً بحرمة الفضاء التّربويّ بِرُمّتِهِ...
-
البطاقة التّقنيّة للفيلم
الجدول 1: البطاقة التّقنية لفيلم “الْقسم 8“
المعلومات العامّة |
الصّنف الفنّيّ |
دراما اجتماعيّة |
سنة الإصدار |
2003م |
|
مدة العرض |
93 دقيقة |
|
لغة العرض |
العامّية المغربيّة |
|
الدّولة |
المغرب |
|
الطّاقم الإداريّ والفنّيّ والتّقنيّ |
الإخراج |
جمال بلمجدوب |
السّيناريو |
منير شهير، وهشام الركراكي، وجمال بلمجدوب |
|
التّشخيص / التّمثيل |
فاطمة خير، ورفيق بوبكر، وعزيز حطّاب، وسعد التّسولي، وأحمد الصّعري، وفاطمة وشّاي، وعائشة ساجد، وعمر العزّوزي، ونفيسة الرّحالمي، ونزهة بدر، ومحمد بوغابة، وهشام الرّكراكي، وعبد الإله الحجّامي، ومصطفى الرّوكي، ومحمد شليح… |
|
الموسيقى التّصويريّة |
عبد الواحد العزيزي العلوي، وسعيد العزيزي العلوي |
|
المونتاج |
ياسين بنعطية |
|
إدارة الإنتاج |
القناة الثّانية المغربيّة |
-
المتن الحكائيّ للفيلم
يعرض “القسم 8” قصّة مدرّسة اللّغة الفرنسية “ليلى” (فاطمة خير)، الّتي يتمّ إخطارها بقبول انتقالها إلى مؤسّسة تعليميّة قريبة من المنزل الّذي تقطن به هي ووالدتها الأرملة (عائشة ساجد) بالدّار البيضاء. فتبدو الوقائع إيجابيّة بالنّسبة للبطلة مقارنة بالصّعوبات الّتي كانت تعاني منها بسبب رحلاتها الطّويلة بين محلّ سكناها ومقرّ عملها السّابق، مّما أخّرَ زواجها من رشيد، الموظّف الإطار بشركة تأمين (سعد التّسولي).
وتدور أحداث الفيلم أساساً حول حجرَةٍ دراسيّةٍ (رقم 8)، متناولاً ما يقع فيها من صراعاتٍ وشنآن بين المدرّسة “ليلى” واثنين من متعلّميها: امجيد (رفيق بوبكر) وميلود (عزيز حطّاب)، ممّا خلقَ لدى الطّرفين حالة من اللّاتوازن؛ إذ عانى المتعلّمان دومًا من الطّرد ولوم زملائهم في القسم، بينما تخبّطت المدرّسةُ في مشاكل إداريةٍ وسيكوسوسيولوجيةٍ كثيرَةٍ أثّرت على حياتها الشّخصيّة وعلى مردوديّتها التّربويّة. ومع تقدّم الأحداث، يزداد منسوب التّوتّر بين طرفي العمليّة التّعليميّة – التّعلميّة، حيث تتعرّضُ المدرّسة لانهيارٍ نفسيٍّ تنقلُ على إثره للمستشفى. وبعد عودتها، تنهج سياسيةَ الباب المسدود، فتغلق كلّ مسارات التّواصُل بينها وبين تلاميذِ القسم “8”، وتزدادُ الحبكة السّينمائيّة تعقيداَ عندما يهمّ “امجيد” (رفيق بوبكر)، الّذي كان أكثر التّلاميذ إثارة للمتاعب والشّغب داخل الفصل وخارجه، بمحاولة انتحارٍ داخل فضاء المؤسسة. فتكتشفُ المدرّسة أنّ بطلي الشّغب والعنف يعانيان من مشاكل سيكو-أسريّةٍ، وأنّ الشّغب هو ردّ فعلٍ سلبيّ منهما عن عدم الرّضا بظروفهما الاجتماعيّة والاقتصاديّة، لذلك تقرّر نسج علاقة أكثر توطّداً معهما، ليصيرا بعد ذلك أنموذجين للالتزام والجدّية والهدوء.
2-4-3- صورةُ المدرّسِ والرّسالةُ التّربويّةُ للفيلم
يقدّمُ الفيلمُ أنموذجاً لمدرّسةٍ طموحةٍ انتقلتْ حديثاً إلى مؤسّسةٍ تعليميّةٍ قريبةٍ من أسرتها، حتّى تستقرّ اجتماعيّا ونفسيّا، وتزيد من فعاليّة عطائها التّربويّ. وحيث إنّ خبرتَهَا البيداغُوجِيّةَ محدودةٌ من حيثُ أساليب التّعامل مع حالاتِ الشّغب داخل الفصْل الدّراسيّ، في مقابل متعلّمين بسوابق عنفٍ وشغَبٍ عانت كثيرا منها مدرّسةٌ سابقةٌ، لم تكن لتنجحَ في مهمّتها التّربويّة، فينتهي بها الأمرُ بمصحّةٍ للأمراضِ النّفسيّة، قبل أن تُعالج هذه الظّاهرة بيداغوجيّاً، وتنجح في تقويم سُلُوكات متعلّيمها المشاغبين العنيفين.
ينقلُ “القسم 8″، عموما، رسالةً تربويّةً مرتبطَةَ بصورةِ المدرّسِ داخل فصلٍ دراسيٍّ مشحونٍ بالعنفِ والشّغب. حيث كانت ظاهرة العنف المدرسيّ، بمختلف تجلّياتها وصورها، محور دوران فلك حبكته السّينمائيّة، فتصدّرت المشاهدُ العنفيّة (الرّمزيّة والماديّة) أحداثه، وكانت المشاكلُ الأسريّة للمتعلّم، وإدمانه على المخدّرات، وتدنّي مستواه الدّراسيّ، عوامل زادت من توتّر العلاقة مدرّس / متعلّم. ولذلك عمد السّيناريست إلى تقديم صورةٍ عن مجمل الأساليب الّتي يمكن أن ينهجها المدرّس للحدّ من هذه الظّاهرة: العقاب الجماعيّ للمتعلّمين من خلال اقتعاد كرسيّ المكتب طيلة الحصّة الدّراسيّة، والامتناع عن الشّرح والتّواصل معهم، وطرد المشاغبين منهم… إلّا أنّ هذه الطّرائق لم تكن ناجعة، لكون المدرّسة تفتقر لتجربةٍ مهنيّةٍ وبيداغوجيّةٍ كافيَةٍ تؤهّلها لفتح باب التّواصل الفعّال مع متعلّميها؛ ممّا سييسّر لها فهم ظروفهم واستيعاب أسباب انحرافهم، ومن ثمّة الدّفع بهم لتحقيق نتائج إيجابيّة.
وبذلك يعالج هذا الفيلم جانباً من العلاقة مدرّس / متعلّم، حيث يسلّط الضّوء أكثر على الواقع الّذي يعيش تحت نيره المدرّس المغربيّ، متوقّفا عند مخاطر ظاهرة العنف المدرسيّ الناجمة – حسب مضمون الفيلم – عن غياب تواصُلٍ فعّالٍ بين طرفي هذه العلاقة، فيقدّم بريداً توجيهيّاً وتربويّاً مهمّاً لتحقيق التّوازن بين مختلف أطرافها، يتأسّس على تفهّم الطّرفين لبعضهما خارج أسوار الفصل الدّراسيّ، لأنّ من شأن ذلك تجسير روابط تربويّة متينة بينهما، ممّا يُيَسِّر تحقيق الأهداف التّربويّة المسطّرة.
يبسُطُ هذا الفيلمُ، إذن، صورةً عمّا يتكبَّدُهُ المدرّسُ اجتماعيّاً وثقافيّاً، في ظلّ تنامِي ظاهرةِ الشّغبِ والعُنْفِ المدرسيّين، ويعرضُ جملةً من النّتائج السّلبيّة الّتي تترتّب عن انسدَادِ آفاقِ التّواصُلِ داخلَ الفصْلِ الدّراسِيّ، وَما ينتجُ عن ذلك من صداماتٍ ومَسْلَكِيّاتٍ لا ترْبويّةٍ. ثمّ يخلُصُ إلى تقديمِ حُزمةٍ من الحُلولِ الّتي من شأنِهَا الحدّ من استفحالِ هذِهِ الظّاهِرَةِ.
-
نتائج الدراسة
من المؤكّد أنّ جمال بلمجدوب قد طرحَ في فيلمه “القسم 8” إشكاليّةً جديدةً لم يسبق أن تناولتها السّينما المغربيّة، لكنّ عرضَ هذا الفيلم في كلّ مرّة أضحى مناسبة لاندلاع فتيل الشّغب بين صفوف المتعلّمين. إذ نجح في تقديم طابقٍ شهيٍّ لشريحةٍ واسعةٍ من المتعلّمين المتعطّشين لهوى الانحراف، فأمست المؤسّسات التّعليميّة مستنقعاتٍ عطنةً لتنزيل بعض لقطاته في مشاغبة المدرّسين، والتحرّش بالمدرّسات، ومضايقة كلّ من في الفضاء المدرسيّ من إدارةٍ وأطقمٍ تربويّةٍ وتقنِيّةٍ وأمنيّةٍ… حيث نفثَ “القسم 8” في روع المتعلّم جرعاتٍ إضافيّةً من الجرأة والصّفاقة، مكّنته من خلال أجرأة أحداثه على واقعه المأزوم من التمرّدَ على المبادئ المؤسِّسَة للتّوقير والاحترام اللّازمين لرمزيّة المؤسّسة التّعليميّة، وهو ما يفنّد البعد التّربويّ / الإصلاحيّ المزعوم من الفيلم، والّذي مفاده المساعدة في حلحلة إشكاليّة العنف الّتي أضحت تنخر الجسد المدرسيّ المغربيّ، والتّحسيس بخطورة ما وصل إليه الواقع التّربويّ من انحلال وتفسّخ وتهتّك، وإبراز قدرة “المرأة” على تغيير الواقع الموبوء للأفضل. لكن يبدو أنّ العلاج بهذه الوسائل قد حوّل وضع المدرسة المغربيّة من المتأزّم إلى الكارثيّ ومن البسيط إلى المركّب.
فباسم نقل واقعها المتردّي، وتحت يافطة الإصلاح والتّعاطي الغيور مع مشاكل المدرسة المغربيّة، استهدف “القسم 8” تجسيد خصوصيّات المرحلة التّاريخيّة الّتي ظهر فيها، وما تعرفه من انهيارٍ للأنساق القيميّة بلغ زُباه أن تحوّلت المدرسة من فضاءٍ لتلقّي أصول المعرفة إلى حقلٍ قفرٍ غبارٍ تُطرَحُ فيه نفايات العبث وأضرابٍ من العنف والاجتراء المُشين. فزادت مظاهر العنف الكثيرة من عمق معاناة المدرّس، ليس فقط عبر التّعنيف والتّرهيب والتّجريح، ولا عبر التعرّض للاستفزاز داخل الفصل وخارجه، ولكن أيضاً من خلال الإهانات الاجتماعّية العديدة المتمثّلة في التنكيت والتّسلية بوضعه المتردّي ومستواه المعيشيّ المتدهور، في ظلّ واقعٍ مهنيٍّ يشهَدُ ارتفاع مؤشّرات الإرهاق وتفاقم الأمراض المزمنة، ويعرف افتقار المؤسّسات التّعليميّة إلى أدنى الشّروط الصّحّيّة والبيداغوجيّة اللّازمة.
وتتّضح بجلاء النّسبة الكبيرة للشّغب والسّلوك المُحاكي لما قامت به شخصيّة “مجيد” (رفيق بوبكر) من فوضى واجتراءٍ سافلٍ داخل القسم وفي محيط المدرسة، وبعيدا عنها حيث الإقامة الشّخصيّة لعائلة المدرّسة “ليلى”، حتّى صار كلّ أعضاء الجسم التّربويّ المغربيّ ضحايا استفزازات ومضايقات من متعلّمين على شاكلة ما حصل في هذا الشّريط. وعديدةٌ هي الأمثلة الّتي تنشرها يوميّا وسائل الإعلام، على اختلاف أشكالها وألوانها، عن حوادث مشابهة لوقائع هذا الشّريط (على سبيل المثال لا الحصر حادث مدينة وجدة[ii]).
ورغم أنّ النهاية جاءت مصحّحة ومعالجة لبعض جوانب ظاهرة العنف المدرسيّ، لكنّها لم تنجح في مسح الصّورة السّلبيّة الّتي تكرّست في أعمال سينمائيةٍ لاحقةٍ. حيث عادت هذه الموجة للظّهور بقوّةٍ مع فيلم “المعلّمة” لحسن المفتي سنة 2004م (المدرّسة الانتهازيّة الّتي عملت على الاستفادة من الانتقال عبر التّدليس والتّحايُل على القانون بالزّواج الأبيض)، و”مول البندير” لإبراهيم الشّكيري سنة 2018م (التّخلّي عن مهنة التّدريس لاحتراف العزف والغناء وما في ذلك من هدمٍ صارخٍ لنظام “القدوة” النّاجع في التّربية عبر العصور).
بينما لجأ كتّابٌ قلائلُ إلى رسم صورةٍ مثاليّةٍ عن المدرّس، وكأنّها أصبحت مطلباً اجتماعيّاً بعيد المنال؛ كما في الدّور الّذي لعبه أمين النّاجي سنة 2009م في فيلم “صدى الجبل” لعبد الله العبداوي، حيث أوضح الوجه الحقيقيَّ والنّسقَ الأخلاقيّ والقيميّ الّذي يتّسم به المدرّس العامل بالهامش الجغرافيّ والاجتماعيّ للمغرب، وكشف عن حبّه وشغفه الكبيرين لمهنته رُغم كلّ العوائق الّتي ما فتئت تعترضه في أدائه لمهمّته النّبيلة. ويبدو أنّ هذا المنجز السّينمائيّ يمثّل استثناءً في المسيرة الدّراميّة للسّينما المغربيّة، إذ ما تزال تصرّ الشاشتان الصّغيرة والكبيرة في سبيل التّسلية على المزيد من التّشويه لصورة المدرّس.
ويلتقي “القسم 8” مع المسرحيّة المصريّة الشّهيرة “مدرسة المشاغبين”[iii] من حيثُ المغْزَى الاجْتِماعيّ والبعد التّربويّ المحصُور في قدرةِ “المرأة” على تقديم الحُلول التّربويّة النّاجَعَة، والتغلّب على جموح الشّباب الثّائر على كلّ الأنساق السّوسيوثقافيّة، بدءاً بالأسرة، ومروراً بالشّارع والإعلامِ، وانتهاءً بالمدرسةِ وما يؤثّثُ فضاءها من مكَوّناتٍ متشعّبةٍ.
تبقَى للفيلمِ قيمته التّربويّة والسّوسيولُوجيّة الّتي لن يمرّ عليهَا الباحثُ المتخصّصُ مرور الكرام. فهو وثيقةٌ بَصَريّةُ مُهِمّةٌ تَرْبَوِيّا. كَمَا يُعْتَبَرُ أداةً أكاديميّةً عمليّةً وبيداغوجيّةً لرصد خصوصيّات الوضع السّوسيوثقافيّ للمجتمع المغربيّ، ما دامت المكتبةُ السّينمائيّةُ المغْربيّةُ لا تتوفّرُ علَى ما يَكْفِي من الإنتاجَاتِ المتخصّصَةِ في المُعَالَجَةِ البيدَاغُوجِيّةِ لمختلف الظّواهر السّوسيوتَرْبويّة. ولذلك فهذا العملُ يضَعُ المُشَاهِدُ أمام الواقِعِ المُزْرِيِ الّذي تعيشُهُ المدرسةُ ومعها المدرّسُ المغربيُّ، ولوْ أنَّهُ معروضٌ من الزَّاويَةِ السّينوغرافيَّةِ التّخَيُّليَّةِ. ويمكنُ فِي هَذَا الإطارِ بسطُ الخُلاصَاتِ الموجَزَةِ الآتِيَةِ:
-
يَحملُ كُلُّ مخرجٍ نظرةً مُتعاطفةً ومُنحازةُ لكلّ النّماذجِ التّربويّةِ المغربيّةِ، ولكنّهَا تبقَى نظرةً واقعةً تحتَ أسْرِ قراءةٍ تجاريّةٍ غيّبت طريقةَ تفكيرِ المدرّسِ وموقفه الحقيقيّ إزاءَ وضْعِهِ وَوَضْع الشّخْصِيّاتِ المُحِيطَةِ بِهِ فِي كُلِّ حالةٍ (الشّريطُ قراءةٌ ذاتُ بعدٍ ترفيهيٍّ تجاريٍّ للواقعِ السّوسيُوتربويِّ المَغْربيِّ).
-
يحْكِي الفيلمُ المدروسُ مأساةً مركّبةً ناجمةً عن تعقيداتِ المنظومةِ التّربويّةِ والاجتماعيّةِ والسّياسيّةِ وقوانينها الصّارمة، ليس المدرّسُ فيها هو الضّحيّة الوَحيدة، بَلْ حتَّى المتَعلّم والأُسْرَة والمُجتمع المغْربيّ برمّته.
-
تَحْسين أُجُورِ المدرّسين بما يتناسب مع ما يبذلونه من جهدٍ، حتّى تنسجمَ مع الارتفاعِ المستمرّ في الأسعارِ ومستوى المعيشةِ على الصّعيدِ المحليِّ والقومِيّ والعالمِيّ.
-
تَفَشِّي ظَاهِرَة العنف المدرسيّ وانهيار النّسق القيميّ دليلٌ واضحٌ على عمْقِ الأزمةِ الّتي تضربُ المدرسَةَ المَغْربيّةَ.
-
توصِيات
يبْدُو من خلالِ هذه الدّراسة المتواضِعَة أنّ إِعداد متعلّمٍ مالكٍ للعين السّينمائيّة هو أحد المداخل الكفيلة بتحقيق الغايات التّربويّة من هذين الفيلم وما يشاكلهما؛ حيث إنّ غياب الثّقافة السّينمائيّة والوعي بدورِها الكبير في بناء حياة الفرد والمجتمعِ يشكّلُ العائقَ الأكبرَ أمام سينما تربويّةٍ مغربيّةٍ فاعلةٍ. إذ لا يمكنُ أن يكون هذا الفنّ هادفاَ إلّا بمتعلّمٍ واعٍ بدورها الفنّيّ والإنسَانيّ. وتمثّل المؤسّساتُ التّربويّةُ، لا ريب، الفضاءَ الأنسبَ لترسيخ هذه الثّقافة عبر الأندية السّينمائيّة والانفتاح على الفاعلين السّينمائيّين (مخرجين، ومؤلّفين، وممثلين، ومنتجين…)، وترسيخ ثقافة سينمائيّة حقيقيّة، تقربّه من السّينما الحقّة، وتبعده عن الرّداءة وما يتولّد عنها من مسلكيّاتٍ لا تربويّةٍ. فضلاً عن ضرورة إعادة الاعتبار للمدرّس، وبشكل مستعجلٍ، ضمن كلّ الرّؤى الإصلاحيّة الّتي تبلورها المنظومة التّربويّة المغربيّة.
وعموما، يمكن أن تساعد على نجاح هذه الرّؤى الشّروط الدّنيا الآتية:
-
جعل المدخل السّينمائيّ جزءا أساسيّا يدخل ضمن سيرورة تكامليّة مع المعينات التّعليميّة الكلاسيكيّة (السّبورة – الكتاب المدرسيّ…)، وبناء فضاءات خاصّة بالمؤسّسات التّربويّة والتّعليميّة تستغلّ بشكل حصريّ للأنشطة الموازية، وتكييف جداول الحصص لتتضمّن حيّزا كافيا لتحليل الصّور ودراسة الأفلام السّينمائيّة، للحدّ من “الأميّة الأيقونيّة” الّتي ما فتئت تزداد تفاقما في كلّ أوساط ومستويات المجتمع المغربيّ.
-
ربط السّينما بكلّ الموادّ التّربويّة (التّاريخ، الجغرافيا، العلوم، الأدب، التّربية الدّينيّة، الرّياضيّات، الفنون التّشكيليّة…)، وإنشاء نوادي سينمائيّة وفنّيّة لتحليل الخطاب السّمعيّ البصريّ بالمؤسّسات التّعليميّة.
-
تأطير رصين ومتين للمدرّسين في مجال الاستثمار الدّيداكتيكيّ للمنتجات السّينوغرافيّة، حتّى يتمّ تصريفه إلى المتعلّم بجودة عالية.
-
دعم مجالات الشّراكة بين الفاعلين في مجال السّينما والتّلفزيون ورجال التّربية والتّعليم.
-
تجويد / تجديد التّكوينات الّتي يتلقّاها المدرّسون وتنويعها حتّى تواكب التّطوّرات الّتي يشهدها العالم الرّقمي والتّكنولوجيّ العالميّ.
-
تشجيع الصّناعة السّينمائية لإنتاج أفلام تحفّز المدرّس، وتدعو المجتمع للالتفاف حوله، وتشجّعه على العطاء والمثابرة.
-
الاستغلال الأمثل لخصيصة التّواصل الجماهيريّ المميّزة للسّينما لإنتاج أفلام يستشعر من خلالها المشاهد المغربيّ أهميّة المشاركة في حلحلة الأزمة الّتي تنخر الجسد التّربويّ.
-
إرساء سياسة واضحة المعالم في مجال التّواصل السّمعيّ – البصريّ لحماية المتلقّي الغضّ من استهلاك أشرطة ملوّثة بأبعاد ثقافيّة أو إيديولوجيّة لا تمتّ بصلة للثّوابت المغربيّة العربيّة الإسلاميّة.
-
تحفيز المدرّس عبر آليّات داخليّة بعيدة عن المقاربات الزّجريّة الّتي تزيد من نفوره وغرابته عن الوسط الّذي يفترض أن يحتضنه ويشجّعه.
-
منح مهنة التّعليم مزايا مماثلة للمهن الأخرى كالطّبّ والهندسة، حتّى يزداد إقبال العناصر الممتازة من الطّلّاب للالتحاق بالمدارس العليا للتّربية والتّكوين والمراكز الجهويّة لمهن التّربية والتّكوين، ولكي يشعر المدرّس بأهمّية وظيفته وقيمته بالنّسبة للمجتمع.
-
إعادة الاعتبار للمدرّس من خلال منحه صلاحيّات أوسع في ديناميّة الأوراش الإصلاحيّة الّتي يشهدها الوسط التّربويّ (الأخذ بقرارات مجالس الأقسام والمجالس التّربويّة…).
-
تحسين أجور المدرّسين بما يتناسب مع ما يبذلونه من جهد، وحتّى تنسجم مع الارتفاع المستمرّ في الأسعار ومستوى المعيشة على الصّعيد المحلّي والقوميّ والعالميّ.
-
دعوة الباحثين في مختلف الاتّجاهات الأكاديمّية إلى الاهتمام بهذا الموضوع الشّائك لأنّ الكتابات حوله قليلة ونادرة.
هذه مجموعة من المقترحات تتوخّى المساهمة في تجاوز حالة الأزمة الّتي تعيشها المدرسة المغربيّة، وفي قلبها المدرّس. قد نكون أصبنا في بعضها وأخطأنا في بعضها الآخر، ولكنّ الأهمّ يبقى طرح الإشكاليّة للنّقاش بجدّية وحزم. إذ منذ عقود خلت، كان ولا زال الخطاب المهيمن على السّاحة التّربويّة هو محوريّة المتعلّم في المخطّطات والسّياسات التّعليميّة بشكل عامّ (تجديد المناهج، والتّكوينات…). ونعتقد بأنّه قد حان الوقت لطرح الإشكاليّة بشكل مختلف، وتكون: أليست إعادة الاعتبار للمدرّس اجتماعيّا واقتصاديّا وثقافيّا مدخلا رئيسا لتجاوز حالة الأزمة الّتي تنخر جسد المدرسة المغربيّة؟
-
خاتمة:
تُؤدّي السّينِما فِي الميدَانِ التّربويّ، بِاعْتبَارِها وَسِيلةً تواصليّةً جماهيريّةً مركّبةً من جَوانب جَمَاليَّةٍ متعدّدةٍ، أدواراً محوريَّةً تُساعدُ على صياغةِ المواقفِ والاتّجَاهَات الإيجَابيّة، حيثُ تجْمع بين الحرَكَة والصُّورة والمُؤثّرات البَصَرِيّة والصّوتيّة في آنٍ واحدٍ، ممّا يجعل مشاعرَ المتلقّي، لا سيّما المشاهد الغضّ، عرضةً للإثارة إلى درجة التّأثير في ثوابت شخصيّته، ومن ثمّة اندماجه في محيطه.
بيد أنّ السّينما المغربيّة، منذ بداية الألفيّة الثّالثة، وفي معالجتها للواقع السّوسيوتربويّ، أجحفت في حقّ المدرسة والمدرّس معا؛ إذ قليلةٌ هي المُنجزاتُ السّينمَائيّةُ الّتِي حفلت بقضاياهما المتشعّبة، وعالجت أوضاعهما الشّائكة، ولم تكن حتّى موضوعيّةً في نقل صورتهما الواقعيّةِ والحقيقيّة للمشَاهِدِ المغربيّ. فلم تظهر المدرسة إلّا كحلبة للصّراع والعنف والتّهميش، ولم يحضر فيها المدرّس كما عهد به في التّراث العربيّ الإسلاميّ، وحدّدت مقوّماته التّقاريرُ الدّوليّة والوثائق الرّسميّة، باعتباره الفنار الموجّه للمجتمع، وأحد مفاصل المشاريع التّنمويّة الّتي تساهم في الرّفع من مستوى المجتمع المغربيّ..
بل ما فتئت تزيد الوضع المأزوم حدّةً وشراسةً، بكلّ ما تحمله من إصرارٍ غريبٍ على تجميد الأوضاع الاجتماعيّة وتكريس الممارسات التّقليديّة الّتي تعزّز تهميشه، فضلاً عن كلّ الفعاليّات التّربويّة. ولذلك قد تكون قضيّة المدرّس سياسيّة بالدّرجة الأولى، مهما كانت مظاهرها نفسيّةً أو اجتماعيّةً أو اقتصاديّةً أو ثقافيّةً…
ومن ثمّة فأيّ متتبّعٍ للسّينما “التّربويّة” المغربيّة وأيّ متأمّلٍ للشّأنِ التّربويّ في المغربِ لا يملكُ إلّا أن ينادي إلى ضرورة تشكيلِ إرادةٍ سياسيّةٍ حقيقيّةٍ، وإيجاد صيغةٍ وسيطَةٍ تبرز صورةً حيويةً مختلفةً عن المدرّس، وتقومُ على أسسٍ سياسيّةٍ إصلاحيّةٍ تنويريّةٍ حقيقيّةٍ، من شأنها الارتقاء بوضعه والخروج به من نفقِ الصُّوَرِ النّمطيّة المكرورة الّتي تبعث الملَلَ والرّفْضَ في نفس المتلقّي المتبصّر، ومن ثمّ الرّقيّ بالمدرسة في شتّى اتّجاهاتها ومجالاتها. ونختم بقول الشّاعر:
اَلْمُعَلِّمُ وَالطَّبِيبُ كِلَاهُمَـــــــــــا لَا يَنْصَحَانِ إِذَا هُمَا لَمْ يُكَرَّمَــــا
فَاصْبِرْ لِدَائِكَ إِنْ أَهَنْتَ طَبِيبَــــهُ وَاصْبِرْ لِجَهْلِكَ إنْ جَفَوْتَ مُعَلّمـَـــا.
الإحالات والمراجع:
° الإحالات[i]–
بدأ المخرج المغربي جمال بلمجدوب مساره السينمائي بثلاثة أفلام قصيرة، هي: “ليلة محترمة”، و”رجل القش”، و”ناقص واحدة”، قبل أن يعرف أكثر ويشتهر بفيلمه الطويل “ياقوت”.[ii]– شهدت ثانوية السلام التأهيلية التابعة للنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بوجدة / أنكاد (المغرب) يوم الثلاثاء 28 فبراير 2012م سيناريو مماثل للفيلم “القسم 8″، بعد أن أقدم شخص، كان يتابع بها دراسته سابقا (17 سنة)، على محاولة الانتحار، حيث صعد إلى الطابق الثالث، وشرع يصرخ ويتوعّد برمي نفسه، ولولا تدخل رفاقه لوقعت المأساة… (بوابة وجدة أنفو وموقع المغرس).[iii]– مدرسة المشاغبين: مسرحية مصريّة كوميديّة من تأليف علي سالم، وإخراج جلال الشرقاوي، وبطولة عادل إمام، وسهير البابلي، وسعيد صالح، وأحمد زكي، ويونس شلبي…، عرضت سنة 1973م. وقد تحوّلت في السنة نفسها إلى فيلم سينمائي أخرجه حسام الدين مصطفى ومثل فيه: نور الشريف، وميرفت أمين، وعبد المنعم مدبولي، ومحمد عوض…
° المراجع:#
العربية
-
الجاحظ, أ. ع. (1968). البيان والتّبيين(Vol. 1). (ت. ف. عطوي, Trad.) بيروت: دار صعب.
-
المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلميّ. (1999). الميثاق الوطنيّ للتّربية والتّكوين. الفصل133, المغرب.
-
المجلس الأعلى للّتربية والتكوين والبحث العلميّ. (2015, 05). الرّؤية الاستراتيجيّة لإصلاح التّعليم 2015 – 2030م. الرباط.
-
المصطفى مولاي البرجاوي. (2017م). حول التّربية والتّعليم: الواقع والرّهان. (منشورات الزّمن، سلسلة شرفات 85،، المحرر) سلا: مطبعة بني يزناسن.
-
ديلور , ج., & آخرون. (1996). الكنز المكنون، تقرير قدّمته إلى اليونيسكو اللّجنة الدّوليّة المعنيّة بالتّربية للقرن الحادي والعشرين.منشورات اليونيسكو.
-
سمير محمد حسين. (د. ت). بحوث الإعلام -الأسس والمبادئ. القاهرة: عالم الكتب.
-
عبد الرّحمان بنيونس. (04 يونيو, 2015). المعلّم ودوره في تحويل الأهداف التّربويّة إلى سلوكٍ عمليٍّ ع: 40، . جريدة المحجّة.
-
وزارة التربية الوطنيّة. (2014, 10 17). المذكّرة 14 / 867. القرارات التّأديبيّة المتّخذة من طرف مجالس الأقسام، وخاصّة منها المتعلّقة بالطّرد المؤقّت عن المؤسّسة. الرباط.
-
وزارة التربية الوطنية. (17 أكتوبر, 2014م). المذكّرة 14 / 867. القرارات التّأديبيّة المتّخذة من طرف مجالس الأقسام، وخاصّة منها تلك المتعلّقة بالطّرد المؤقّت عن المؤسّسة، حيث نصّت هذه المذكّرة على اعتماد عقوبات بديلة تتمثّل في تقديم خدمات ذات نفع عامّ للمؤسّسة التّعليميّة.
-
وزارة التّربية الوطنيّة. (2019, 08 28). القانون الإطار17. قانون إطار يتعلّق بمنظومة التّربية والتّكوين والبحث العلميّ, المادة32. الرباط, المغرب.
-
وزارة التّربية الوطنيّة والتّكوين المهني والتّعليم العالي والبحث العلمي. (2015م, أكتوبرالمذكرة الوزاريّة 15 / 099.التدابير ذات الأولوية لتنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التّعليم 2015 – 2030م.
-
الأجنبيّة


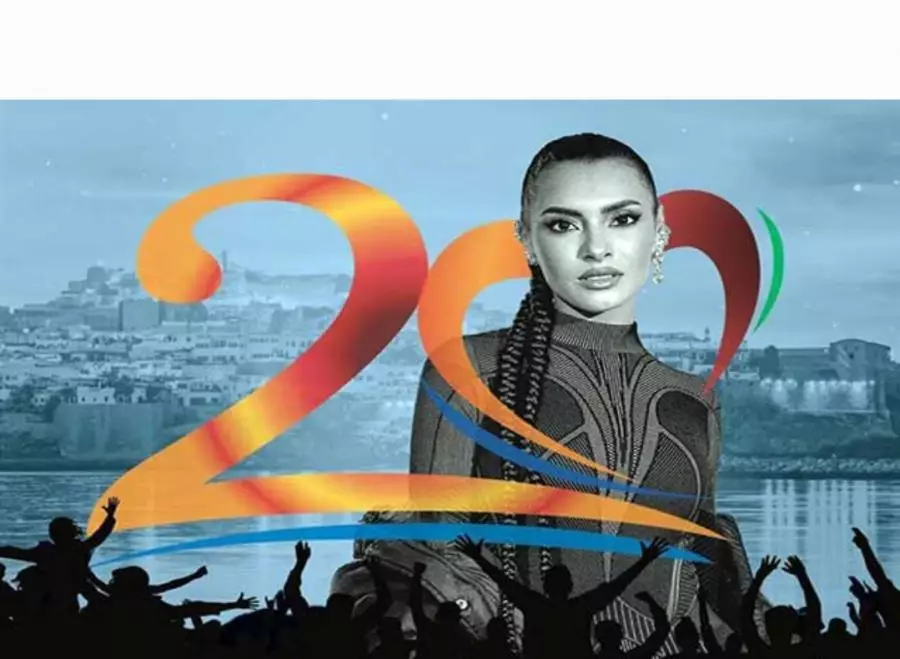









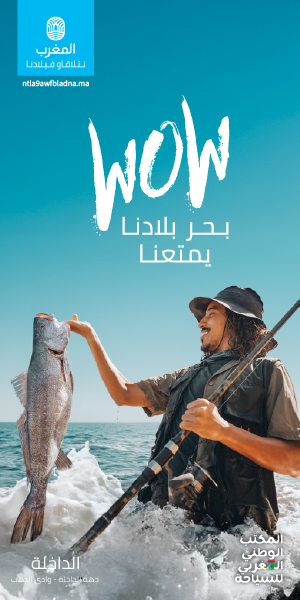
تعليقات
0