-
د. محمد أمحدوك (°)
ملخص:
من البديهيّ القول إن الوظيفة الأولى للمدرّس هي تعليم الفرد والمساهمة في إدماجه بوسطه السّوسيو ثقافيّ والاقتصاديّ، كما تعتبر الأعمال الفنّيّة، بشتّى صنوفها، خلاصة التّجربة الإنسانيّة في المجتمع ومحاولة لتشخيص الواقع والرفع من قيمته، وبما أنّ السّينما، في أحد اتجاهاتها، محاكاة للواقع ورصدٌ دقيقٌ لتحوّلاته المختلفة، فإنّ شرعيّة التّساؤل تتجلّى أساسا في الكيفيّة الّتي يمكن من خلالها تقييم تجربة الإبداع السّينوغرافيّ “التّربويّ” في المغرب.
فهل توجد آفاقٌ “سينمائيّة” ناجعة من شأنها المساهمة في تجاوز حال الأزمة الّتي تنقض ظهر المدرسة المغربيّة؟ وإلى أيّ مدى كان يمكن القول إنّ المخيال السّينوغرافيّ المغربيّ كان منصفا أو موضوعيّا وهو يرصد الواقع السّوسيوتربويّ للمدرّس؟ وقبل ذلك، ما المعالم الّتي تحدّدها الوثائق الرّسميّة والتّقارير الدّوليّة لأوضاعه الاجتماعيّة والتّربويّة؟
لتوضيح هذه الإشكاليةّ، استندنا إلى منهجية تحليل المضمون، حيث عملنا على تشخيص وتحليل جوانب من الإكراهات السوسيوثقافيّة والاقتصادية التي تقف حائلا أمام نجاعة الأداء التربوي والتعليمي للمدرس المغربيّ من خلال الشريط السينمائيّ “مول البندير” (1) الذي أنتج سنة 2018.
1- مقدمة
لمّا كان دور المدرّس هو تكوين الفرد والمساهمة في إدماجه بالمحيط السّوسيو ثقافيّ والاقتصاديّ، وكانت الأعمال الفنّيّة خلاصة التّجربة الإنسانيّة في المجتمع ومحاولة دؤوبة لأنسنة الواقع والتسامي به، وكانت السّينما، في أحد اتجاهاتها، محاكاة للواقع ورصدا دقيقا لتحوّلاته المختلفة، فإنّ شرعيّة التّساؤل تتجلّى أساسا في الكيفيّة الّتي يمكن من خلالها تقييم تجربة الإبداع السّينمائيّ “التّربويّ” في المغرب.
فهل ثمّة –حقيقة-حلولٌ “سينمائيّة” ناجعة من شأنها المساهمة في تجاوز حالة الأزمة الّتي تنقض ظهر المدرسة المغربيّة؟ وإلى أيّ مدى كان المخيال السّينوغرافيّ المغربيّ موضوعيّا في رصد الواقع الاجتماعيّ-التّربويّ للمدرّس؟ وقبل ذلك، كيف تبدو صورة المدرّس في الواقع السّوسيو تربويّ المغربيّ؟ وما المعالم الّتي تحدّدها الوثائق الرّسميّة والتّقارير الدّوليّة لأوضاعه الاجتماعيّة والتّربويّة؟
يفرض الجواب عن هذه الأسئلة حزمة من الإجراءات التّحليليّة، مثلما يدعو إلى ملامسة مفاهيم وتصوّرات ومناهج خاصّة، والاستناد إلى حقول معرفيّة متعدّدة (السّوسيولوجيا، والبيداغوجيا، والسّيميولوجيا، والتّواصل…). لذلك كان لا بدّ من قراءة جوانب مختلفة من المنجز السّينمائيّ المغربيّ، والبحث في أسس وتصوّرات الممارسة السّينوتربويّة، وخلخلة بعض القناعات الرّاسخة فيها، مع فحص جملة من العلاقات التّربويّة داخل الثّالوث: المدرّس – المجتمع – السّينما، وذلك باستثمار البعدين التّواصليّ والسّيكو سوسيولوجيّ.
ومن ثمّة توخّت هذه الدّراسة ممارسة نوع من النّقد على بعض المسلكيّات “السّينوتربويّة” الّتي أصبحت نشازات سوسيو ثقافيّة في الوسط الفنّيّ، وطرح هموم المدرّس وقضاياه المتشعّبة في المجتمع المغربيّ اعتمادا على المنظور السّينوغرافيّ، باعتباره مرآة تقرّب للمشاهد حقيقة واقعه الاجتماعيّ، ومبصارا يشخّص من خلاله طبيعة نظرة المجتمع إليه، وذلك لفتح آفاق جديدة لاشتغال العلاقة مدرّس / مجتمع، الأمر الّذي سيساهم لا مرية في خلق فضاءات أوسع للتّفكير والتّأمّل، ومن ثمّ الدّفع بالثّالوث السّابق نحو تجاوز حالة الأزمة الّتي يعيشها المدرّس المغربي ومعه المؤسّسات التّربويّة والتّعليميّة.
-
وضعيّة المدرّس في الواقع السّوسيو تربويّ المغربيّ
إذا كان المتعلّم، وفق المقاربات التّربويّة الحديثة، محور العمليّة التّعليميّة التّعلّميّة، فإنّ المدرّس، بحكم عمله وعلاقاته وتخصّصه واتّصالاته، هو جوهر هذه العمليّة برمّتها، ما دام المسؤول المباشر عن مهنة التّدريس، والمعنيّ الأوّل بتنشئة الفرد وبناء شخصيّته، ومن خلال الفرد تنشئة جميع فئات المجتمع وتكوينها. لكنّ المتأمّل في العقود الأخيرة للمنظومة التّربويّة المغربيّة، يجد فيها ضررا كبيرا لحق كيان المدرّس وهيبته، بل ودفعت به إلى أرذل مقام، بعدما كان، لقرون طويلة خلت، رأس المجتمع والمشكاة الّتي يهتدى بنورها.
ولا يكاد يمرّ يوم إلّا وصفحات وسائل الإعلام، بمختلف ألوانها وأشكالها، مصدّرة، وبالبنط العريض، بخبر عن مدرّس تعرّض لضرب أو جرح أو تنكيل… فما يكون من المتعلّم، وهو المتتبّعُ الدّؤوب للتّكنولوجيّات الحديثة، إلّا اقتناص تلك المشاهد ومحاولة تنزيلها على أرض الواقع. فكيف تقدّم التّقارير الدّولية والوثائق الرّسميّة المغربيّة “مربي الأجيال”؟ وما الصورة الّتي بات يظهر عليها اجتماعيّا؟
-
صورة المدرّس المغربيّ في بعض التّقارير الدّولية والوثائق الرّسميّة
أكّد التّقرير الّذي قدّمته اللّجنة الدّوليّة المعنيّة بالتّربية للقرن الحادي والعشرين لمنظّمة الأمم المّتّحدة للتّربية والعلم والثّقافة (اليونيسكو) سنة 1996م أنّ المدرّس يشعر، أنّه وحيد معزول، لأنّه يقوم بنشاط فرديّ فقط، ولكن أيضا بسبب أهمّية التّوقّعات الّتي يتعرض لها والّتي كثيرا ما تكون جائرة، وهو يودّ قبل كلّ شيء أن تحترم كرامته (جاك ديلور وآخرون، 1996م، ص: 27). ولذلك خلص إلى أنّ عمليّة إعداد المدرّس تحتاج إلى إعادة نظر كاملة، وأنّه لتحسين نوعيّة التّعليم، ينبغي أوّلا تحسين أحواله من حيث وضعه الاجتماعيّ ومناهج تكوينه وظروف عمله، لأنّه لن يكون قادرا على الوفاء بما يطلب منه إلّا إذا اكتسب المعارف والمهارات والقدرات المهنيّة، والإرادة القويّة… وهو ما يمكن تلخيصه في النّقط الأربع الآتية:
-
تحسين الوضع الاجتماعيّ للمدرّس: لأنّ وضعه الاجتماعيّ بات ضعيفا مقارنة مع التّطوّرات الاقتصاديّة المتلاحقة والمستوى المعيشيّ المتسارع، أصبح المدرّس في السّنين الأخيرة يفكّر في البحث عن موارد أخرى يحسّن بها وضعه الاجتماعيّ والاقتصاديّ (السّاعات الإضافيّة –المهن الحرّة…)، وهو ما أثّر / يؤثّر كثيرا في عطائه التّربويّ داخل الفصل الدّراسيّ.
-
الإرادة القويّة: ينبغي في هذا الصدّد أن يتقدّم لمهنة التّدريس من كانت له فعلا عزيمة قويّة ورغبة جامحة في هذه المهنة، وليس كلّ من يريد الخروج فقط من غيابات البطالة وشظف العيش.
-
الرّفع من جودة ظروف العمل: لا سيّما مع حجم الاكتظاظ والضّغط والأعباء المتزايدة الملقاة على عاتق المدرّس، فضلا عن المذكّرات الوزاريّة الّتي أضحت تعبث بهيبته، وتصون المتعلّم أكثر منه (المذكّرة 14 / 867 بتاريخ 17 أكتوبر 2014م)؛ حيث تحوّلت الفصول الدّراسيّة في العقود الأخيرة إلى حلبات للصّراع والشّنآن. وعوض أن يفكّر المدرّس في المنهج الأمثل لتبليغ المحتويات الدّراسيّة، أضحى ينصرف إلى إرساء قواعد البيئة المشجّعة على التعلّم، وتحييد ضغوط السّياقات المشحونة، فكانت النّتيجة ضياع الجهد، وهدر الزّمن البيداغوجيّ، وتراجع دافعيّة التّعليم والتّعلّم.
-
تجويد القدرات المهنيّة للمدرّس: في سياق التّحوّلات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والتّكنولوجيّة المتسارعة الّتي عرفها المغرب في العقود الأخيرة، صار الاقتصار في إعداد المدرّس على مرحلة التّكوين في المراكز الجهويّة لمهن التّربية والتّكوين غير كاف، لذا تتحتّم متابعة المدرّس في الفصل ومصاحبته بتكوينات مستمرّة تزيد من فعاليّة أساليبه ومهاراته ومعارفه.
وارتهن الميثاق الوطنيّ للتّربية والتّكوين (1999م)، من جهته، تجديد المدرسة المغربيّة بجودة عمل المدرّس وإخلاصه والتزامه. والجودة في هذا السياق مرتبطة بالتّكوين المستمرّ الفعّال والمستديم، والوسائل التّربويّة الملائمة، والتّقويم الدّقيق للأداء البيداغوجيّ (الميثاق الوطنيّ للتّربية والتّكوين: الفصل: 133). ولذلك عرض سمات خاصّة يفترض أن تميّز المدرّس النّشيط، منها:
-
السّمات المعرفيّة التّكوينيّة: وذلك عبر تمكين المدرّس من تكوين رصين قبل استلامه لمهامّه التّربويّة والتّعليميّة (الميثاق الوطنيّ للتّربية والتّكوين: الفصل: 133). وقد حدّدت هذه الوثيقة مجموعة من الأسس القويمة الّتي يمكن أن تزيد من متانة التّكوين الأساسيّ للأطر التّربويّة عامّة، كالتّكوين الذّاتيّ المستمرّ، وتعزيز التّكوين الأساس في التّخصّصات المتعلّقة بالتّواصل والتّنشيط الثّقافيّ والتّكنولوجيّات الحديثة…
-
السّمات التّدريسيّة المنسجمة مع روح العصر: وهي سمات ترتبط أساسا بالمعارف والأداء والنّتائج. وقد أمست من خلالها المتطلّبات الحديثة في إعداد المدّرس منحصرة في ثلاث دعامات كبرى: الدّعامة المعرفيّة الخاصّة بالتّخصّص، والدّعامة التّواصليّة المرتبطة بتبليغ المعارف وإدارة الفصل الدّراسيّ، والدّعامة الثّقافيّة الخاصّة بالإعداد العامّ.
ويأتي الرّفع من جودة عمل الفاعلات والفاعلين التّربويّين (مدرّسين ومكوّنين ومؤطّرين وباحثين ومدبّرين…)، في مقدّمة الأولويّات الكفيلة بالنّهوض بأداء المدرسة بمختلف مكوّناتها، وتحسين مردوديّتها، وإنجاح إصلاحها. ولذلك دعا المجلس الأعلى للتّربية والتّكوين والبحث العلميّ في الدّعامة التّاسعة من الرّؤية الاستراتيجيّة 2015 – 2030 المرتبطة بتجديد مهن التّدريس والتّكوين والتّدبير إلى العمل على إتقان تكوينهم وحفزهم، وإعادة الاعتبار لأدوارهم، واحترام كرامتهم، وتحسين ظروف مزاولتهم للعمل (الرّؤية الاستراتيجيّة لإصلاح التّعليم 2015 – 2030م، ص: 24).
ومن حيث الأدوار والهيئات، أكّدت الرّؤية الاستراتيجيّة للإصلاح، “على الإحاطة الشّاملة بالمهامّ الموكولة للمدرّس، التّربويّة منها والتّقييميّة والاجتماعيّة والثّقافيّة والتّواصليّة، وضبطها والتّنصيص القانونيّ عليها، واعتمادها كأساس لتحديد المسؤوليّة، والتّقييم، والتّرقي المهنيّ، والحرص على تطوير التّكوين في اتجاه دعم التّخصّص، ولا سيّما في التّعليم الابتدائيّ” (الرّؤية الاستراتيجيّة لإصلاح التّعليم 2015 – 2030م، ص: 25).
وحرصا على انتقاء أجود الكفاءات، والاختيار الأمثل للأجيال الجديدة من المدرّسين والمدرّسات، أكّدت هذه الوثيقة التوّجيهيّة على ضرورة اعتماد معايير محدّدة لولوج مهن التّربية والتّكوين تتمثّل أساسا في: الجاذبيّة للمهنة، والاستعدادات النّفسيّة والمعرفيّة والقيميّة، والتّوافر على المعارف والمؤهّلات والكفايات الضّروريّة وفق ما يستلزمه الإطار المرجعيّ لكفايات المهنة (الرّؤية الاستراتيجيّة لإصلاح التّعليم 2015 – 2030م، الدّعامة التاسعة، ص: 25).
في حين ركّزت المذكّرة الوزاريّة 15/099 المتعلّقة بالتّدابير ذات الأولويّة لتنزيل الرّؤية الاستراتيجّية على ضرورة مصاحبة المدرّسين أثناء مزاولتهم لمهامّهم، للرّفع من مستوى أدائهم المهنيّ داخل الأقسام الدّراسيّة، وتشجيع الأساتذة على استثمار التّجديدات التّربويّة، وتعزيز تقاسم الخبرات بين المدرّسين (التّدبير رقم 15). كما حثّت على أهميّة الرّفع من جودة التّكوين الأساس للمدرّسين وتزويد المنظومة التّربويّة بأطر ذات كفاءات عالية (التّدبير 16) (المذكرة الوزاريّة 15 / 099، بتاريخ 12 أكتوبر 2015م).
وحيث إنّ ضمان تعليم ذي جودة للجميع يستلزم اتّخاذ الإجراءات اللّازمة لذلك، وعلى رأسها: تجديد مهن التّدريس والتّكوين والتّدبير، وبخاصّة في الوسط القرويّ أو في الهامش الجغرافيّ للمغرب، دعا القانون الإطار رقم 51.17 المتعلّق بمنظومة التّربية والتّكوين والبحث العلميّ إلى “وضع نظام خاصّ لتحفيز وتشجيع الأطر التّربويّة والإداريّة على ممارسة مهامّها بالأوساط القرويّة والمناطق ذات الخصاص (من أجل تعميم التّعليم الإلزاميّ بالنّسبة لجميع الأطفال البالغين سنّ التّمدرس)” (القانون الإطار 51 – 17 المتعلّق بمنظومة التّربية والتّكوين والبحث العلميّ، المادة: 20)، و”تمكين أطر التّدريس والتّكوين والبحث من اكتساب كفايات لغويّة متعدّدة، مع تقييدهم باستعمال اللّغة المقرّرة في التّدريس دون غيرها من الاستعمالات اللّغويّة” (القانون الإطار، المادة 32).
نخلص بعد هذا الجرد المقتضب للمقوّمات الأساسيّة الّتي ينبغي أن تتوفّر في المدرّس بناء على مضامين وتوجيهات الوثائق الرّسميّة والتّقارير الدّوليّة إلى تحديد أهمّ الأدوار المنوطة به في ضوء التّغيّرات الحالية، وهي لا تخرج على ثلاثة أدوار كبرى: التّدريس – البحث العلميّ – خدمة المجتمع (Eble, Kennith, (1972), P. 110). وكلّها تقتضي بيئة اجتماعيّة خاصّة تشجّعه وتشدّ بأزره، بيد أنّه أصبح في العقود الأخيرة، ولأسباب كثيرة، مادّة دسمة للسّخرية والاستهزاء.
-
صورة المدرّس في الواقع الاجتماعيّ المغربيّ
ساعدت الاختلالات والانحرافات الّتي طالت مهنة التّعليم على رسم صورة سيّئة في أذهان النّاس عن المدرّس، وعظمت فيها المبالغة إلى الدّرجة الّتي أصبح معها في الدّرك الأسفل من الهرم الاجتماعيّ المغربيّ، حتّى أضحى يصدق عليه ما رواه الجاحظ من أمثال العامّة “أحمق من معلّم كتّاب”، وما رواه عن بعض الحكماء، حين قال: “لا تستشيروا معلّما، ولا راعي غنم، ولا كثير القعود مع النّساء” (الجاحظ، البيان والتّبيين، ص: 136). فأسيء إلى سمعة المعلّم، وصارت عبارة “معلّم الصّبيان” مثلا يضرب للضّعة والامتهان. ومن ثمّ تراجعت مكانة المدرّس في المجتمع، وفقد كثيرا من هيبته وبريقه، بالنّظر إلى ما كان عليه في العهود السّابقة، ولعلّ ذلك يرجع إلى تضافر جملة من العوامل الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثّقافيّة…، من قبيل:
-
اضطراب المنظومة القيميّة للنّسق التّربويّ: يتجسّد ذلك في سنّ تشريعات تقوم على جعل المتعلّم في قلب الاهتمام والتّفكير، في مقابل التّقليل من شأن المدرّس وتحجيم دوره. ولا أدلّ على ذلك من عدم الأخذ بقرارات المجالس التّربويّة الّتي يشارك في تدبيرها وخلاصات التّقارير الدّوريّة الّتي تخرج عنها، فضلا عن المذكّرة الوزاريّة الخاصّة بالإجراءات التّأديبيّة لمجلس القسم، الّتي صادرت حقّه في زجر المتعلّم وتوقيفه، إذا ما صدر عنه ما يمسّ جوهر السّيرورة التّعليميّة بالمؤسّسة (المذكّرة 14 / 867 بتاريخ 17 أكتوبر 2014م بشأن القرارات التّأديبيّة المتّخذة من طرف مجالس الأقسام، وخاصّة منها المتعلّقة بالطّرد المؤقّت عن المؤسّسة).
-
العامل الاقتصاديّ – الاجتماعيّ: حيث أضحت أجرة المدرّس لا تكفيه في قضاء حاجاته وصون كرامته، ممّا أثّر بشكل كبير في عطائه التّربويّ. أضف إلى ذلك عدم استفادته من الحقوق الأساسيّة (المادّية والمعنويّة)، حتى صار اليوم الحلقة الأضعف في المجتمع، والمتّهم الأوّل في فشل جلّ المشاريع الإصلاحيّة المرتبطة بالمنظومة التّربويّة المغربيّة. كما أنّ تراجع المستويات المعيشيّة لعامّة المغاربة، جعل أغلبيّة المتخرّجين تتهافت للخروج من شرنقة البطالة، فدخل المهنة من كان مستواه العلميّ والوجدانيّ دون متطلّبات هذه الوظيفة الحسّاسة، وأصبح التّعليم مهنة من لا مهنة له.
-
الميز السّلبيّ لمهنة التّعليم: حيث أضحى يلِجُهَا الفاشلون من الولوج لكلّيات الهندسة والطّبّ والتّقنيات الحديثة، فلو كانت جاذبيّة هذه المهنة أقوى مادّيا واجتماعيّا لدخل حقل التّعليم رجال ونساء أكفاء، وتغيّرت بذلك النّتائج.
-
قصورات على مستوى الحياة المدرسيّة: ترتبط هذه القصورات ببنية الأقسام، وضعف الإمكانات المادّية والتّقنية اللّازمة ليؤدّي المدرّس مهامّه على أكمل وجه، فضلا عن تلك الأخلال المرتبطة بأنماط الحكامة الإداريّة وأساليبها.
-
تراجع التّأطير النّقابيّ: لا مرية أنّ المؤسّسات النّقابيّة في المغرب تعرف تراجعا كبيرا، ممّا نحا بأغلب المدرّسين إلى رفض الانخراط في هذا المشهد البارد. فإذا كان، سلفا، دور العمل النّقابيّ منصبّا على الاهتمام بمعالجة هموم المدرّس ومقاسمته انشغالاته، فقد توجّهت أنظاره، في العقود الأخيرة، إلى العمل السّياسيّ والتّهافت على المناصب والمكاسب الشّخصيّة الضيّقة.
-
تطوّر التّكنولوجيّات الحديثة: في ظلّ تراجع دور الأسرة، وارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشّباب، وضعف حملات التّوعية الهادفة من الإعلام وجمعيّات المجتمع المدنيّ، أثرّت الدّيناميّة الكبيرة الّتي شهدتها التّكنولوجيا الحديثة على أفكار المتعلّمين، وجعلتهم لا يبالون بالتّحصيل والتعلّم، فانتكس تواصلهم مع المدرّسين، وتراجعت مردوديّتهم التّربويّة (مولاي المصطفى البرجاوي، 2017م، ص: 130).
وقد تضافرت هذه العوامل كلّها لتسفرَ عن وضع اجتماعيّ مقلق يحزّ في نفس المدرّس المغربيّ. لكن، ما دامت أغلب النّتائج التّربويّة الإيجابيّة يقف وراءها مدرّس أتقن دوره، وتحمّل مسؤوليّته، وكرّس حياته للعمل الجماعيّ، ومعالجة جلّ الإكراهات الّتي تعوق السّير العادي للمؤسّسة التّعليميّة، ستسمو لا ريب مكانته الاجتماعيّة، وسيكسب رضا مختلف الفاعلين التّربويّين والاجتماعيّين، مهما تعالت محاولات التّشويه والتّشهير والسّخريّة… ومن ثمّة فالمدخلُ الصّحيحُ لأيّ إصلاح تعليميّ لا بدّ أن يضع في الحسبان تأهيل المدرّس، لأنّه هو الّذي يجعل المتعلّم متفاعلا ومفكّرا ومبدعا في مختلف العلوم، وهو من يؤهّله ليصبح شخصية ذات أنماط متعدّدة ومتوازنة، بعد تنمية قدراته وصقل مهاراته الأساسيّة (عبد الرحمان بنيونس، 2015م، ص: 10).
وحيث إنّ الأعمالَ الفنّيّة هي مرآة للمجتمع يَكشفُ من خلالها على قضاياه وبنياته المختلفة، وحلم يرسم واقعا يرنو الوعي الجمعيّ لتحقيقه، كان من الطّبيعيّ أن تعالج السّينما، منذ بداياتها في المغرب، موضوع المدرّس بإشكالاته وقضاياه المتعدّدة. لكنّ السّخريّة وشمت أعمالها، حيث قدّمت المدرّس في قالبٍ فارغٍ وضمن شخصيّاتٍ كاريكاتيريّةٍ سطحيّةٍ، ولو أنّ أعمالاً محدودةً قاومت هذا الاتّجاه، وقدّمت له نماذج إيجابيّةً.
وعموما، لم يكن المدرّس على مدار عقود طويلة موضوعا أساسيّا في الفنّ والأدب المغربيّين، ولا العنصر الأهمّ الملازم للسّرد السّينوغرافيّ، بما يجعلنا قادرين على الحديث، كما سيأتي في الأسطر اللّاحقة، عن صور بعينها اعتمدها المخرجون المغاربة، ظهر فيها المدرّس أداة للتّعبير عن العديد من القضايا الكبرى الّتي شغلت الرّأي العامّ في فترات زمنيّة متفاوتة، ولو أنّه يحضر تاراتٍ طرفاً بارزاً في بعض منعطفات الحبكة السّينمائيّة.
فإلى أيّ حدّ تمكّن إذن الطّرح الدّراماتولوجيّ السّينمائيّ المغربيّ من تقديم ومعالجة مختلف القضايا الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثّقافيّة للمدرّس؟
-
صورة المدرّس في السّينما المغربيّة: دراسة وصفيّة تحليليّة
بفعل العوامل الاقتصاديّة والمعيشيّة الصّعبة الّتي ما فتئ يمرّ بها المغاربة قاطبة، حوّلت الشّاشة الكبيرة المدرّس المغربيّ إلى تاجر علم ومادّة خام للسّخريّة الدّراميّة. وقد انتهج السّينمائيّون المغاربة هذا النّهج المتهكّم من المدّرس في كثير من الأعمال، ففصّلوا مشاهد كثيرة تعبّر بأسلوبٍ فكهٍ عن ظروفه المادّية والاجتماعيّة المزرية. وقد اتّسم هذا الخطاب السّطحيّ، ما عدا في حالاتٍ خاصّةٍ محدودةٍ، بتهميش دوره وقيمته في المجتمع، وإظهاره بصورة البائس الخالي من أيّ نوعٍ من المعرفة، ولا يكاد يدخل إلى الفصل إلّا ليكون هدفاً للسّخريّة والاستهزاء.
ومن ثمّة يبدو أنّ الأساس الّذي صارت ترتكز عليه الرّؤية السّينوغرافيّة المغربيّة الحديثة هو تنحية الجانب الإنسانيّ في المُدرّس؛ وتجريده من رسالته السّامية، وإبرازه موظّفا يسعى فقط إلى كسب عيشه، فضلاً عن إظهاره منشغلا بهموم شخصيّة سطحيّة، بعيدا عن كلّ ما هو اجتماعيّ أو سياسيّ أو وطنيّ (الحركة الانتقاليّة، والتّرقية، وتقديم الشّواهد الطّبيّة، الإضرابات المستمرّة، والعنف المدرسيّ…).
ومن هذا المنطلق، نروم في هذه الورقة إبراز مدى صدقيّة هذه الدّعوى، واستكشاف مساهمة السّينما المغربيّة في نقل القيم التّربويّة، وبيان بعض الصّور الّتي قدّمت بها المدرّس، وذلك بتحليل مضمون فيلم سينمائيّ مغربيّ عرف نقاشا وجدلا كبيرا وقت عرضه.
-
عيّنة الدّراسة
ترتكز هذه الدّراسة على تحليل مضمون شريط سينمائيّ “تربويّ” مغربيّ، ونظرا لتباين طبيعة الأفلام السّينمائيّة الّتي عالجت مثل هذه المواضيع، فقد تمّ اللّجوء إلى العيّنة الحصريّة القصديّة، واختير العمل السّينمائيّ: “مول البندير”. وترجع أسباب اختيار هذا الفيلم إلى كونه يمثّل جانبا خاصّا من التّعليم المغربيّ (يكسر هذا الشريط من خلال شخصيّة المدرّس “عبد الرّفيع” نظام القدوة الترّبويّ، ليبسط في طابع دراميّ جانبا من الضّغوط الّتي يعيشها المدرّس العامل بالقطاع الخاصّ…)
-
الإشكاليّة
قد تكون المدرسة السّينمائيّة المغربيّة من بين المدارس العربيّة الأقلّ احتفاء بقضايا المدرّس ووضعه ومعاناته داخل فضاء يشهد تراجعات كثيرة ومفارقات كبيرة على المستويين الاجتماعيّ والاقتصاديّ. فكيف تمّ تقديم المدرّس في الأنموذج السّينمائيّ المختار؟ وإلى أيّ حدّ كانت السّينما المغربيّة منصفة في نقل الواقع السّوسيو تربويّ للمدرّس؟ وهل كانت المقاربة السّينمائيّة لمشاكل المدرّس المغربيّ وأوضاعه المعقّدة نابعة من خيار فنّيّ وفكريّ أصيل أم كانت مجرّد استجابة لمطالب سوسيو اقتصاديّة معيّنة؟
-
البعد المنهجيّ
المنهج المستخدم في الدّراسة هو منهج تحليل المضمون الّذي يندرج ضمن الدّراسات الوصفيّة الّتي تعتمد في جانب كبير منها على الوصف والتّحليل واستخدام الأساليب الكمّيّة والكيفيّة في التّعبير عن البيانات والنّتائج، حيث تمّ في البداية عرض بطاقة تقنية عن الشريط، فمتنه الحكائيّ، قبل تحليل بعض الجوانب المرتبطة بصورة المدرّس والرّسالة التّربويّة الّتي نحا لتبليغها، ثمّ الخروج بملاحظاتٍ واستنتاجاتٍ خاصّةٍ مشفوعةٍ بخلاصاتٍ عامّةٍ فتوصياتٍ.
-
العرض والتّحليل
يحكي الشّريط السّينمائيّ المغربيّ “مول البندير” (صاحب الدّفّ) للمخرج إبراهيم الشّكيري (2) قصة مدرّس شابّ تخلّى عن مهنته ليحترف الغناء الشّعبيّ. ومن ثمّة فقد أثار جدلا كبيرا في السّاحة التّربويّة المغربيّة، بين من يراه مروّجا لصورة سلبيّة مُحِطّة ومهينة للمدرّس، وبين من يرى أنّه يقدّم صورة موضوعيّة وعادلة عن واقعه الاجتماعيّ-الاقتصاديّ المأزوم.
-
البطاقة التّقنيّة للفيلم
المعلومات العامّة |
النّوع الفنّيّ |
دراما اجتماعيّة |
سنة الإصدار |
2018م |
|
مدة العرض |
92 دقيقة |
|
لغة العرض |
العامّية المغربيّة |
|
الدّولة |
المغرب |
|
الطّاقم الإداريّوالفنّيّ والتّقنيّ |
الإخراج |
إبراهيم الشكيري |
السّيناريو |
حسن فوطة |
|
التّصوير |
زهير برّادة وحميد أكداش |
|
الصوت |
محمد حمان رواتب |
|
التّشخيص / التّمثيل |
فيصل عزيزي، وهدى صدقي، وصلاح الدّين بنموسى، وسعاد العلوي، وزهور السّليماني، وصلاح عبد الحقّ، ونورة الولتيتي، وإبراهيم بلعزري… |
|
الموسيقى التّصويريّة |
عادل عيسى |
|
المونتاج |
عمران أمير |
|
الإنتاج |
تنفيذ الإنتاج |
القناة الثّانية المغربيّة |
زمن العرض |
رمضان 1440ه / 2019م |
(ج. 4): البطاقة التّقنية لفيلم “مول البندير “
-
المتن الحكائيّ للفيلم
يعرض “مول البندير” (2) قصّة “عبد الرّفيع” المدرّس الأعزب، ذو المدخول الشّهريّ الضّعيف، الّذي يعيش مع والدته بمنزل بسيط في أحد الأحياء الشّعبيّة. وبسبب بُعده عن المؤسّسة التّعليميّة الّتي يشتغل بها، يحضر دائما متأخّرا، ولذلك يقرّر الانتقال إلى مسكن قريب. لكنّه سرعان ما سيكتشف أنّ السّيّدة الّتي اكترى منها المنزل الجديد (سعاد العلوي) تعمل راقصة شعبيّة “شيخة“، تنظّم عادة في بيتها حفلات تمرينيّة ساهرة، ممّا ضايقه في البداية، وأثّر فيه كثيرا، لكنّه سيصبح بعدئذ جزءا أساسيّا من هذه الاحتفالات، حين بلغها إتقانه العزف على آلة الدّفّ (البندير)، فتضغط عليه حتّى تدمجه في فرقتها الفنّيّة، ويستجيب مُكْرَها لإلحاحاتها بسبب ظروفه المادّيّة الصّعبة (مرض الأمّ واستعصاء تسديد ما تراكم بذمّته من ديون). فتنقلب حياته رأسًا على عقب، ويبني صرح مجده الفنّيّ على أنقاض مهنته “الشّريفة” الّتي لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماته الاجتماعيّة – الاقتصاديّة.
2-4-3- صورة المدرّس والرّسالة التّربويّة للفيلم
حاول الشّريط السّينمائيّ “مول البندير” تبليغ رسالة مرتبطة بالواقع المادّي الهشّ الّذي ما انفكّ يعيشه المدرّس المغربي في العقود الأخيرة، فأبرز مجمل الضّغوطات الّتي يتعرّض لها خصوصا بالقطاع الخاصّ، سواء داخل المؤسّسة الّتي يشتغل بها أو خارجها. كما أثار مسألة عدم الاهتمام الكافي للسّياسات التّعليميّة والتّربوّية المتعاقبة في المغرب بالمجال الفنّيّ، ليؤكّد على ضرورة بناء وتجهيز قاعات للمسرح والسّينما والرّسم داخل الفضاءات المدرسيّة.
كما جسّد “مول البندير” أنموذجا حقيقيّا للمدرّس الّذي يعمل في مؤسّسة تعليميّة خصوصيّة، وما يتعرّض له فيها يوميّا من انتهاكات (الإهانات المستمرّة، وضعف الأجر الّذي يستفيد منه…) وتهديدات مستمرّة بالطّرد من لدن رئيسه المباشر، ولذلك فهو يسلّط الضّوء على العبث والشّطط والضّغط الّذي يطال مدرّسي هذا القطاع، كما يصوّر معاناة المدرّس المغربيّ من النّاحية المادّية، الأمر الّذي يدفعه، أحيانا، لتحقيق ذاته اجتماعيّا واقتصاديّا، إلى الانفتاح على آفاق وتجارب أخرى، والقبول بعروض مهنيّة، مهما كانت طبيعتها، لتقليص الهوّة الّتي تفصل بين راتبه الشّهريّ ومصاريفه الأساسيّة الخاصّة.
-
ملاحظات واستنتاجات
على الرّغم من الطّبيعة التّوجيهيّة والتّربويّة للفيلم، إلّا أنّ الآراء قد تضاربت حول طريقة رصده للواقع السّوسيو تربويّ للمدرّس وفحوى رسالته التّربويّة. وهذا ما يجعل من الانفتاح على مضامين الدّرسين السّوسيولوجيّ والبيداغوجيّ مدخلا أساسيّا لاستخلاص طبيعة تمثّل هذا الإنتاج الفنّيّ للفضاء التّربويّ المغربيّ. ولو أنّه لا يكاد يخرج عن صيغة التّباين المعروفة والمتداولة بشكل واسع في المحكيّ اليوميّ للمغاربة. فمن جهة هناك تعليم خصوصيّ بمؤسّساته وموارده البشريّة والمادّيّة المعروفة بتكوينها وجودتها، ومن جهة ثانية، هناك تعليم عموميّ بإمكاناته المحدودة وطاقمه التّربويّ، الّذي يتحمّل فوق طاقته لكي يعيد منظومة القيم الاجتماعيّة والثّقافيّة إلى نصابها. ومن أبرز الملاحظات الّتي يمكن تسجيلها في هذا الإطار:
-
تكريس الشّريط السّينمائيّ للتّبخيس المجّانيّ للمدرّس، والدّفع بالمجتمع المغربيّ إلى التّقليل من شأنه، متناسيا أو متجاهلا أنّ طبيعة المجتمع الّذي يتمّ بناؤه مرتبطة بالتّربية المؤسّساتيّة والمدرّس ذاته، وأيّ خدش لصورته، هو في الحقيقة خدش للمجتمع ككلّ له آثاره الوخيمة على أجيال المستقبل والوطن برمّته.
-
تشخيص حقيقة الحالة المادّية المزرية الّتي يعيشها المدرّس المغربيّ، لكنّ تقديم صورته في قالب سلبيّ يلهث فقط وراء الرّبح المادّي مبالغ كثيرا فيها؛ حيث تتوالى المشاهد ليتحوّل المدرّس “النّشيط” إلى عضو رئيس في فرقة للرّاقصات الشّعبيّات “الشّيخات”، وهي الجماعة المعروفة ثقافيّا واجتماعيّا في المغرب بتفسّخ أخلاقها وتهتّك قيمها. فلو أدّى البطل “عبد الرّفيع” دور المدرّس “الشّهم” الذي أجبرته ظروفه الاجتماعيّة القاسية على حمل الدّفّ في قالب دراميّ لحظيّ وبشخصيّة ذات أنفة وكبرياء، لمرّر رسالته بشكل سلس ومقبول، ونال إعجاب الجميع، لكنّ طاقم الفيلم بالغ في التّبخيس من قيمة المدرّس، فوقع في متاهة النّمطيّة و”الكليشيهاتيّة” المرفوضة إبداعا وتداولا ونقدا.
-
انتصار الفيلم في النّهاية للموهبة الفنّيّة للمدرّس (الغناء)، ولفكرة الفنّ عموما، حيث قام البطل بتشييد مؤسّسة تربويّة مجهّزة بقاعة للمسرح والسّينما والرّسم…، وهو الّذي عانى من الحرمان “الفنّيّ” في طفولته، وفي ذلك تحسيس بأهميّة الأنشطة الموازية في بناء شخصيّة المتعلّم، وهي الجانب المغبون في الحياة المدرسيّة، وتنويه منه إلى ضرورة إيلاء الاهتمام أكثر بموضوع التّوجيه التّربويّ، ونداء صارخ للتّعجيل ببناء وتجهيز قاعات للمسرح والسّينما والرّسم داخل فضاءات المؤسّسات التّعليميّة.
-
تمرير رسالة مفادها أنّ التّحصيل الدّراسي لم يعد يجدي نفعا عكس الفنّ والغناء، في الوقت الّذي تشجّع فيه وسائل الإعلام ومواقع التّواصل الاجتماعيّ الشّباب على التّوجه أكثر إلى “الغناء والرّقص” لأنّهما يدرّان مالًا وفيرًا، ويحقّقان نجاحات اجتماعيّة ومادّيّة لا تتأتّى بالعلم والتّحصيل (دعوة للاقتداء ب”مول البندير” الحقيقيّ).
-
إبراز الشّريط للبون الشّاسع بين مخرجات التّقارير الدّوليّة ومضامين النّصوص الرّسميّة من جهة، والواقع السّوسيو اقتصادي والثّقافي للمدرّس من جهة ثانية، وحتى بين صورته في الترّاث الترّبويّ العربيّ الإسلاميّ وقيمته الاجتماعيّة والتّربويّة في العقود الأخيرة.
-
المنجز السّينمائيّ باعتباره فنّا يجمع بين عالمين متناقضين؛ الحقيقة والخيال، كان قاسيا في معالجته لواقع المدرّس المغربيّ، خصوصا بالنّسبة لذلك العامل بالقطاع الخاصّ، لأنّه يعيش ضغطا مهنيّا واجتماعيّا كبيرا مقابل أجر زهيد، وحتّى الصّورة التّخيّلية الّتي يفترض أن تكون حالمة وذات بعد استشرافيّ إصلاحيّ تنويريّ، كانت موشومة بالسّخريّة وتكريس الوضع القائم (التخلّي عن المهنة “الشّريفة”، والقبول بالاندماج والذوبان في وسط مرفوض ثقافيّا واجتماعيّا)، بيد أنّه توفّق في التّعريف والمساهمة في تشخيص جانب كبير من المشاكل الّتي تتخبّط فيها المدرسة المغربيّة (ضعف التّوجيه، والتّبخيس من قيمة المدرّس، وضعف المستوى الدّراسيّ للمتعلّمين، والتّحسيس بالتّغيرات القيميّة الطّارئة على المجتمع المغربيّ والتحوّلات الّتي طالت الميدان التّربويّ، وتغيّر مفهوم القدوة التّربويّ…)، بالدّعوة إلى إيلاء الاهتمام بالبنيات التّحتيّة للمؤسّسات التّعليميّة، لا سيّما تأهيلها بالفضاءات المخصّصة للأنشطة الموزاية (مسرح، ورسم، وموسيقى…)
-
تفسير تراجع قيمة العلم والعلماء في المغرب بتراجع مستوى التّعليم ذاته، وسيادة أنماط تسييريّة تغيب فيها الحكامة والإرادة الحقيقيّة؛ وهو ما تؤكّده اللّازمة الّتي ما انفكّت ترد على لسان بطل الشريط “عبد الرّفيع”: “إنّما الأمم الأخلاق ما بقيت...“؛ ولو أنّ التركيز انصبّ أكثر على رصد الأعطاب المدرسيّة والأخلال السّوسيو تربويّة الّتي يشهدها المدرّس بالتّعليم الخصوصيّ.
-
توصيات
-
يبدو من خلال هذه الدّراسة المتواضعة أنّ إِعداد متعلّم مالك للعين السّينمائيّة هو أحد المداخل الكفيلة بتحقيق الغايات التّربويّة من هذين الفيلمين وما يشاكلهما؛ حيث إنّ غياب الثّقافة السّينمائيّة والوعي بدورها الكبير في بناء حياة الفرد والمجتمع يشكّل العائق الأكبر أمام سينما تربويّة مغربيّة فاعلة. إذ لا يمكن أن يكون هذا الفنّ هادفا إلّا بمتعلّم واع بدورها الفنّيّ والإنسانيّ. وتمثّل المؤسّسات التّربويّة، لا ريب، الفضاء الأنسب لترسيخ هذه الثّقافة عبر الأندية السّينمائيّة والانفتاح على الفاعلين السّينمائيّين (مخرجين، ومؤلّفين، وممثلين، ومنتجين…)، وترسيخ ثقافة سينمائيّة حقيقيّة، تقربّه من السّينما الحقّة، وتبعده عن الرّداءة وما يتولّد عنها من مسلكيّات لا تربويّة. فضلا عن ضرورة إعادة الاعتبار للمدرّس، وبشكل مستعجل، ضمن كلّ الرّؤى الإصلاحيّة الّتي تبلورها المنظومة التّربويّة المغربيّة.
وعموما، يمكن أن تساعد على نجاح هذه الرّؤى الشّروط الدّنيا الآتية:
-
جعل المدخل السّينمائيّ جزءا أساسيّا يدخل ضمن سيرورة تكامليّة مع المعينات التّعليميّة الكلاسيكيّة (السّبورة – الكتاب المدرسيّ…)، وبناء فضاءات خاصّة بالمؤسّسات التّربوية والتّعليميّة تستغلّ بشكل حصريّ للأنشطة الموازية، وتكييف جداول الحصص لتتضمّن حيّزا كافيا لتحليل الصّور ودراسة الأفلام السّينمائيّة، للحدّ من “الأميّة الأيقونيّة” الّتي ما فتئت تزداد تفاقما في كلّ أوساط ومستويات المجتمع المغربيّ.
-
ربط السّينما بكلّ الموادّ التّربويّة (التّاريخ، الجغرافيا، العلوم، الأدب، التّربية الدّينية، الرّياضيّات، الفنون التّشكيليّة…)، وإنشاء نوادي سينمائيّة وفنّيّة لتحليل الخطاب السّمعيّ البصريّ بالمؤسّسات التّعليميّة.
-
تأطير رصين ومتين للمدرّسين في مجال الاستثمار الدّيداكتيكيّ للمنتجات السّينوغرافيّة، حتّى يتمّ تصريفه إلى المتعلّم بجودة عالية.
-
دعم مجالات الشّراكة بين الفاعلين في مجال السّينما والتّلفزيون ورجال التّربية والتّعليم.
-
تجويد / تجديد التّكوينات الّتي يتلقّاها المدرّسون وتنويعها حتّى تواكب التّطوّرات الّتي يشهدها العالم الرّقمي والتّكنولوجيّ العالميّ.
-
تشجيع الصّناعة السّينمائية لإنتاج أفلام تحفّز المدرّس، وتدعو المجتمع للالتفاف حوله، وتشجّعه على العطاء والمثابرة.
-
الاستغلال الأمثل لخصيصة التّواصل الجماهيريّ المميّزة للسّينما لإنتاج أفلام يستشعر من خلالها المشاهد المغربيّ أهميّة المشاركة في حلحلة الأزمة الّتي تنخر الجسد التّربويّ.
-
إرساء سياسة واضحة المعالم في مجال التّواصل السّمعيّ – البصريّ لحماية المتلقّي الغضّ من استهلاك أشرطة ملوّثة بأبعاد ثقافيّة أو إيديولوجيّة لا تمتّ بصلة للثّوابت المغربيّة العربيّة الإسلاميّة.
-
تحفيز المدرّس عبر آليّات داخليّة بعيدة عن المقاربات الزّجريّة الّتي تزيد من نفوره وغرابته عن الوسط الّذي يفترض أن يحتضنه ويشجّعه.
-
منح مهنة التّعليم مزايا مماثلة للمهن الأخرى كالطّبّ والهندسة، حتّى يزداد إقبال العناصر الممتازة من الطّلّاب للالتحاق بالمدارس العليا للتّربية والتّكوين والمراكز الجهويّة لمهن التّربية والتّكوين، ولكي يشعر المدرّس بأهمّية وظيفته وقيمته بالنّسبة للمجتمع.
-
إعادة الاعتبار للمدرّس من خلال منحه صلاحيّات أوسع في ديناميّة الأوراش الإصلاحيّة الّتي يشهدها الوسط التّربويّ (الأخذ بقرارات مجالس الأقسام والمجالس التّربويّة…).
-
تحسين أجور المدرّسين بما يتناسب مع ما يبذلونه من جهد، وحتّى تنسجم مع الارتفاع المستمرّ في الأسعار ومستوى المعيشة على الصّعيد المحلّي والقوميّ والعالميّ.
-
تشجيع المدرّس على الاطّلاع والبحث والدّراسة والمشاركة في المؤتمرات العلميّة، وترقيته للوظائف السّامية، متى تحصّل على شهادات دراسيّة عليا، مما يشجّعه على النّمو الأكاديميّ والمهنيّ.
-
دعوة الباحثين في مختلف الاتّجاهات الأكاديمّية إلى الاهتمام بهذا الموضوع الشّائك لأنّ الكتابات حوله قليلة ونادرة.
هذه مجموعة من المقترحات تتوخّى المساهمة في تجاوز حالة الأزمة الّتي تعيشها المدرسة المغربيّة، وفي قلبها المدرّس. قد نكون أصبنا في بعضها وأخطأنا في بعضها الآخر، ولكنّ الأهمّ يبقى طرح الإشكاليّة للنّقاش بجدّية وحزم. إذ منذ عقود خلت، كان ولا زال الخطاب المهيمن على السّاحة التّربويّة هو محوريّة المتعلّم في المخطّطات والسّياسات التّعليميّة بشكل عامّ (تجديد المناهج، والتّكوينات…). ونعتقد بأنّه قد حان الوقت لطرح الإشكاليّة بشكل مختلف، وتكون:
أليست إعادة الاعتبار للمدرّس اجتماعيّا واقتصاديّا وثقافيّا مدخلا رئيسا لتجاوز حالة الأزمة الّتي تنخر جسد المدرسة المغربيّة؟
الخلاصة
تؤدّي السّينما في الميدان التّربويّ، باعتبارها وسيلة تواصليّة جماهيريّة مركّبة من جوانب جماليّة متعدّدة، أدوارا محوريّة تساعد على صياغة المواقف والاتجاهات الإيجابيّة، حيث تجمع بين الحركة والصّورة والمؤثّرات البصريّة والصّوتيّة في آن واحد، ممّا يجعل مشاعر المتلقّي، لا سيّما المشاهد الغضّ، عرضة للإثارة إلى درجة التّأثير في ثوابت شخصيّته، ومن ثمّة اندماجه في محيطه.
بيد أن السّينما المغربيّة، منذ بداية الألفيّة الثّالثة، وفي معالجتها للواقع السّوسيو تّربويّ، أجحفت في حقّ المدرسة والمدرّس معا؛ إذ قليلة هي المنجزات السّينمائيّة التي حفلت بقضاياهما المتشعّبة وعالجت أوضاعهما الشّائكة، ولم تكن حتّى موضوعيّة في نقل صورتهما الواقعيّة والحقيقيّة للمشاهد المغربيّ.
فلم تظهر المدرسة إلّا كحلبة للصّراع والعنف والتّهميش، ولم يحضر فيها المدرّس كما عهد به في التّراث العربيّ الإسلاميّ، وحدّدت مقوّماته التّقاريرُ الدّوليّة والوثائق الرّسميّة، باعتباره الفنار الموجّه للمجتمع، وأحد مفاصل المشاريع التّنمويّة الّتي تساهم في الرّفع من مستوى المجتمع المغربيّ، بل ما فتئت تزيد الوضع المأزوم حدّة وشراسة، بكلّ ما تحمله من إصرار غريب على تجميد الأوضاع الاجتماعيّة وتكريس الممارسات التّقليديّة الّتي تعزّز تهميشه، فضلا عن كلّ الفعاليّات التّربويّة.
ولذلك قد تكون قضيّة المدرّس سياسيّة بالدرجة الأولى، مهما كانت مظاهرها نفسيّة أو اجتماعيّة أو اقتصاديّة أو ثقافيّة… ومن ثمّة فأيّ متتبّع للسّينما “التّربويّة” المغربيّة وأيّ متأمّل للشّأن التّربويّ في المغرب لا يملك إلّا أن ينادي إلى ضرورة تشكيل إرادة سياسيّة حقيقيّة، وإيجاد صيغة وسيطة تبرز صورة حيوية مختلفة عن المدرّس، وتقوم على أسس سياسيّة إصلاحيّة تنويريّة حقيقيّة، من شأنها الارتقاء بوضعه والخروج به من نفق الصّور النّمطيّة المكرورة الّتي تبعث الملل والرّفض في نفس المتلقّي المتبصّر، ومن ثمّ الرّقيّ بالمدرسة في شتّى اّتجاهاتها ومجالاتها. ونختم بقول الشاعر:
المعلّم والطبيب كلاهمــــــــــا لا ينصحان إذا هما لم يكرّمــــــا
فاصبر لدائك إن أهنت طبيبــــه واصبر لجهلك إن جفوت معلّمـا
///////////
(1) يطلق لقب “مول البندير” على المغنّي الشّعبيّ المغربيّ “عثمان مولين”، الّذي تضارع سيرته الخاصّة أحداث هذا الشّريط التّلفزيّ؛ فهو شابّ مغربيّ تلقّى تعليمًا عاليًا، حيث تخصّص في الإدارة والتّسيير، لكنّ حياته انقلبت رأسا على عقب حين انتشر له شريط مصوّر وهو يغنّي ويعزف على الدفّ، فاشتهر وامتهن الفنّ، وهو حاليًا من أكثر المغنّين الشعبيّين ظهورا في المهرجانات والبرامج الفنّيّة الإذاعيّة والتّلفزيّة.
-
(2) إبراهيم الشّكيري: مخرج مغربيّ، من أعماله “الطّريق إلى كابول” (سنة 2012م).
المصادر والمراجع
المراجع العربيّة:
ابن خلّكان، (أبو العبّاس شمس الدّين أحمد بن محمّد بن أبي بكر)، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان، تحقيق إحسان عبّاس، دار صادر، بيروت، 1972م.
ابن منظور، لسان العرب، ط: 1، دار صبح، الجزائر، 2008م.
أنيس إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللّغة العربيّة، الإدارة العامّة للمعجمات وإحياء التّراث، المكتبة الإسلاميّة للطّباعة والنّشر والتّوزيع، إستانبول، تركيا، 1972م.
البرجاوي مولاي المصطفى، حول التّربية والتّعليم: الواقع والرّهان، منشورات الزّمن، سلسلة شرفات 85، مطبعة بني يزناسن، سلا، 2017م.
بنيونس عبد الرحمان، المعلّم ودوره في تحويل الأهداف التّربويّة إلى سلوك عمليّ، جريدة المحجّة، ع: 40، 04 يونيو 2015م.
الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب، رسائل الجاحظ، تحقيق عبد السّلام هارون، دار الجيل، المجلّد الثّاني، الجزء الثّالث، بيروت، ط: 1، 1991م (تقع رسالة المعلّمين في الجزء الأوّل من المجلّد الثّاني، وقد جاءت في حوالي 24 صفحة (2700 كلمة)).
الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب، فلسفة الجدّ والهزل، تقديم محمد علي الزّعبيّ، دار الشّؤون الثّقافيّة العامّة “آفاق عربيّة”، بغداد، العراق، 1989م.
الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب، البيان والتّبيين، تحقيق فوزي عطوي، ط: 1، دار صعب، بيروت، 1968م.
حسن، أمينة أحمد، رسالة المعلّم في الإسلام ومدى فهم المعلّمين لها في العصر الحديث، منشورات أبحاث مؤتمر المناهج التّربويّة والتّعليميّة في ظلّ الفلسفة الإسلاميّة والفلسفة الحديثة، المعهد العالميّ للفكر الإسلاميّ بالتّعاون مع الجمعيّة العربيّة للتّربية الإسلاميّة، القاهرة، 29-31 يوليو 1990م.
الخربوطليّ، علي حسن، الحضارة العربيّة الإسلاميّة، مكتبة الأنجلو مصريّة، القاهرة، د. ت، مصر.
ديلور جاك وآخرون، الكنز المكنون، تقرير قدّمته إلى اليونيسكو اللّجنة الدّوليّة المعنيّة بالتّربية للقرن الحادي والعشرين، منشورات اليونيسكو، 1996م.
الزبيديّ قيس، المرئيّ والمسموع في السّينما، منشورات وزارة الثّقافة السّوريّة، سلسلة الفنّ السّابع، 112، دمشق، سوريا، 2006م.
زكيّ مبارك، النّشر الفنّيّ، القاهرة، مصر، 1935م.
شلبي أحمد، تاريخ المناهج الإسلاميّة، مكتبة النّهضة المصريّة، القاهرة، 1978م.
الشّهرستانيّ، أبو الفتح محمّد عبد الكريم بن أبي بكر أحمد، الملل والنّحل، تحقيق عبد العزيز محمّد الوكيل، مؤسسة الحلبيّ وشركاه للنّشر والتّوزيع، القاهرة، مصر، 1968م / 1387ه.
ضيف شوقي، تاريخ الأدب العربيّ، العصر العبّاسيّ الثّاني، ط: 2، دار المعارف، مصر.
طوقان إبراهيم، الأعمال الشّعريّة الكاملة، مؤسّسة هنداوي للتّعليم والثّقافة، القاهرة، 2012م.
العقّاد، عبّاس محمود، التّعليم عند العرب في الكتاب، دار المعارف للطّباعة والنّشر، القاهرة، 1946م.
الغزالي، أبو حامد محمّد الطوسيّ النّيسابوريّ، إحياء علوم الدّين ومعه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، ط: 1، دار ابن حزم، 2005م.
كامل، مرسي أحمد ووهبة مجدي، معجم الفنّ السّينمائيّ، وزارة الثّقافة والإعلام، الهيئة المصريّة للكتاب، 1973م.
هيغـل، جورج فيلهلم فريديريش، المدخل إلى علم الجمال، ترجمة جورج طرابيشي، ط: 2، دار الطليعة، بيروت، لبنان، 1988م.
المراجع الأجنبيّة:
Eble, Kennith, 1972, Professors as Teachers, Jossey – bass. Publishers. London.
الوثائق الرّسمية المغربيّة:
المجلس الأعلى للتّربية والتّكوين والبحث العلميّ، المملكة المغربيّة، الميثاق الوطنيّ للتّربية والتّكوين (1999م)، الفصل: 133.
المجلس الأعلى للتّربية والتّكوين والبحث العلميّ، المملكة المغربيّة، الرّؤية الاستراتيجيّة لإصلاح التّعليم 2015 – 2030م، الدّعامة التاسعة.
وزارة التّربية الوطنيّة والتّكوين المهنيّ والتّعليم العالي والبحث العلميّ، المملكة المغربيّة، المذكّرة 14 / 867 بتاريخ 17 أكتوبر 2014م بشأن القرارات التّأديبيّة المتّخذة من طرف مجالس الأقسام، وخاصّة منها تلك المتعلّقة بالطّرد المؤقّت عن المؤسّسة، حيث نصّت هذه المذكّرة على اعتماد عقوبات بديلة تتمثّل في تقديم خدمات ذات نفع عامّ للمؤسّسة التّعليميّة.
وزارة التّربية الوطنيّة والتّكوين المهني والتّعليم العالي والبحث العلمي، المملكة المغربيّة، المذكرة الوزاريّة 15 / 099، بتاريخ 12 أكتوبر 2015م، المتعلّقة بالتدابير ذات الأولوية لتنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التّعليم 2015 – 2030م.
وزارة التّربية الوطنيّة والتّكوين المهني والتّعليم العالي والبحث العلميّ، المملكة المغربيّة، القانون الإطار 51 – 17 المتعلّق بمنظومة التّربية والتّكوين والبحث العلميّ، المادة: 20.












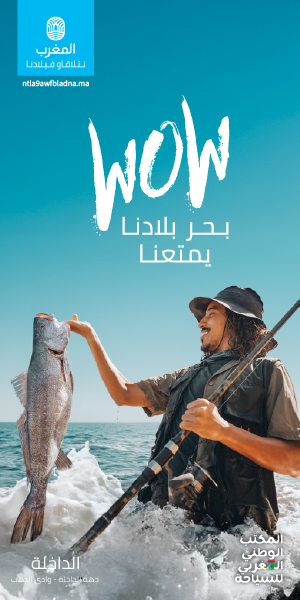
تعليقات
0