- فتح الله بوعزة (×)
لا يستقيم الحديث عن إصلاح المنظومة التربوية وفقا لأحكام القانون الإطار، والإطار الإجرائي لخارطة الطريق 2022 ـ 2026، بمعزل عن إصلاح البنيات الإدارية اللاممركزة (التسمية الرسمية للمصالح الخارجية في القانون رقم 24 ـ 46 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية ـ الجريدة الرسمية 7328 بتاريخ 7 غشت 2024) المكلفة بتنزيل الإصلاح المنشود. ونقصد بذلك مجموع الأقسام، والمصالح، بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديريات الإقليمية التابعة لها، طبقا لأحكام القانون رقم 07، والقرارات الوزارية المنظمة لهياكلها الإدارية، من حيث العدد، والاختصاصات المنوط بها أمر تنفيذها؛ وكذا النصوص القانونية المنظمة لشغل مناصب المسؤولية بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ولا شك في أن إصلاحا كبيرا من هذا الحجم، بأسناده الدستورية والقانونية ذات الطبيعة الإلزامية، وشموليته لمكونات المدرسة المغربية الثلاث: المتعلم، والأستاذ، والمؤسسة؛ وكذا إعادة هيكلة البنيات الإدارية المركزية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (الجريدة الرسمية عدد 7324 بتاريخ 8 غشت 2024)، وإمكان خلق بنيات إدارية لا ممركزة تابعة لها بالجهات والأقاليم، يتطلب ـ بالإضافة إلى الالتزام بتوجه الدولة إلى إرساء حكامة جيدة للمنظومة التربوية وفقا لأحكام الدستور ـ كفاءات نوعية وفقا لمعايير نظامية، ومعرفية، ومهنية محددة بشكل دقيق بعيدا عن أي نزوع مزاجي، ودون محاباة، أو ولاء لأي طرف من داخل المنظومة التربوية، وخارجها على حد سواء.
وإذا كانت بعض ” مهن التربية والتكوين ” حظيت بتأطير تشريعي لمهام موظفيها النظاميين، وتدقيق لاختصاصاتهم، واشتراط تكوين أساس قبل ممارستهم مهامهم”؛ فإن الهيئات النقابية ـ رغم تنصيص المادة 37 من القانون الإطار على إشراكها في إعداد الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات ـ وكذا الجمعيات المهنية، والفاعلين التربويين والإداريين، نادرا ما يهتمون بمسألة من هذا النوع؛ بالرغم من أهميتها القصوى في تجويد التدبيرين الجهوي والإقليمي لإشكالات منظومة التربية والتكوين، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية؛ بالإضافة إلى كونها تقع ضمن دائرة الأسباب المؤدية إلى حدوث نزاعات مهنية مؤثرة على السير الطبيعي للبنيات الإدارية اللاممركزة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ـ وبعض المؤسسات العمومية التي تدور في فلكها، وأهدافها الاستراتيجية ـ بوصفها مرافق عمومية محدثة لغاية تدبير احتياجات الإدارة والمرتفق على حد سواء، وفقا لقواعد الحكامة الجيدة؛ وإمكان تحولها ـ لا قدر الله ـ إلى “ريع مستتر” مُغلّف بدعاوى، وتبريرات مهزوزة يسقطها أول تحقيق إداري محايد ونزيه في الموضوع.
ومعلوم أن إسناد مناصب المسؤولية يخضع لضوابط قانونية عامة تتأسس على ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى مختلف الوظائف ـ كما أقر دستور البلاد (2011 )، وديباجة القانون الإطار ذلك ـ وتستلزم شروطا نظامية محددة في الإطار والدرجة، والشهادة التي تسمح بولوج إطار متصرف من الدرجة الثالثة، والأقدمية في الخدمة “بإدارات الدولة والجماعات الترابية”، بالنسبة إلى الموظفين المرسمين والأعوان المتعاقدين؛ مع إضافة شرط ممارسة مهام رئيس مصلحة بالنسبة إلى المترشحين لشغل مناصب رؤساء الأقسام، وإمكان المرور إلى إعلان ثان عن شغور المنصب موضوع التباري في حالة عدم انتقاء أي مترشح، والشروط المتعلقة بوضع الترشيحات، وآجالها، وتكوين لجنة الانتقاء والمقابلة، والإعلان عن النتائج (المرسوم رقم 681 ـ 11 ـ 2 بتاريخ 25 نونبر 2011 “في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية”).
وقد أضاف منشور رئيس الحكومة رقم 2013 ـ 7 بتاريخ 29 أبريل 2013 في موضوع “التعيين في مناصب المسؤولية ” شروط الخبرة المهنية، والأقدمية العامة في منصب من مناصب المسؤولية وترتيب المترشحين في السلالم المعتمدة في المؤسسة الأصلية للمستخدمين، أو النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والجماعات الترابية، وتأكيد إمكان الطعن في “محاضر اللجن”، وضرورة التقيد “بما يلزم من الحزم” بالتدابير والإجراءات الواردة في المنشور إياه.
وركز المنشور الوزيري رقم 1 بتاريخ 5 فبراير 2019 ” حول شروط الترشح لمنصبي رئيس قسم أو رئيس مصلحة بالإدارات العمومية” على ضرورة تمكين التقنيين، والمحررين و الأعوان المتعاقدين من الدرجة الأولى ـ على الأقل ـ المرتبين في سلم الأجور رقم 11، من الترشح لمناصب رؤساء الأقسام والمصالح؛ بالنظر إلى أن درجتهم تندرج ضمن “الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل لدرجة متصرف من الدرجة الثانية، وإطار مهندس دولة”؛ وكذا المرتبين منهم في درجة ذات رقم استدلالي مماثل لدرجة متصرف من الدرجة الثالثة ـ السلم العاشر، دون اشتراط حصولهم على الإجازة.
غير أن التذكير بمقتضيات المرسوم رقم 681 ـ 11 ـ 2، واعتماده كمرجع أثناء الإعلان عن التباري لشغل مناصب المسؤولية لم يحولا دون وقوع تجاوزات كبيرة في إسناد هذه المناصب بالبنيات الإدارية اللاممركزة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تكشف الممارسات الميدانية بسببها، عن قصور مهني كبير في تدبير الشأن التربوي والإداري، وتحقيق أهداف المنظومة التربوية ـ جهويا وإقليميا ـ على المديَيْنِ المتوسط والطويل. ولعل فشل برامج الإصلاح التربوي السابقة، أو عدم تحقيق بعض أهدافها الاستراتيجية على الأقل، يرجعان إلى أسباب متشابكة من بينها أعطاب الحكامة التربوية.
وقد سبق للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017 ـ الجزء الأول ـ في هذا الصدد ـ إثارة مسألة “عدم تطابق مؤهلات الأطر والمهام الإدارية المسندة إليهم” ـ بواحدة من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ـ من خلال:
- إسناد مهام الإشراف على المصالح الإدارية إلى موظفين لا يسمح لهم “النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ـ 2003 “بممارستها باستثناء مهام الإدارة التربوية بعد التقييد في لوائح الأهلية” (المادة 92 من نظام 2003)، والتي اقتصرت ـ فيما بعد ـ على إطار المتصرف التربوي في النظام الأساسي لسنة 2024 ـ الجريدة الرسمية عدد 7277 بتاريخ 26 فبراير 2024؛
- عدم إسناد هذه المناصب إلى أطر أخرى يُستنْتج من خلال تسميتها أنها أطر عليا من حيث التكوين، والدرجة الوظيفية، متوفرة بالأكاديمية المعنية؛
- الإسناد المباشر لمناصب المسؤولية ” دون إعمال مسطرة مبنية على شروط شفافة وموضوعية للانتقاء”؛ وقد اعتبر التقرير المشار إليه آنفا ذلك “اختلالا تنظيميا في تدبير مناصب المسؤولية”.
و يمكن في هذا السياق ـ عطفا على خلاصات وتوصيات التقرير المذكور ـ إدراج لجوء بعض الرؤساء الإداريين إلى إجراء مقابلة انتقائية لمترشح وحيد ( في الوقت الذي كلفت فيه المذكرة الوزارية رقم 15 بتاريخ 8 مارس 2004 “لجنة المقابلة” بإجراء المقابلات مع المترشحين الستة الأوائل)، أو تكليف بعض الموظفين بمهام القسم والمصلحة أو المديريات الإقليمية مؤقتا، دون إشهار “التكليفين الجهوي والإقليمي”، بإعلانهما بين الموظفين ذوي الصفة القانونية المطلوبة، وتقييدهما بشروط تدعم النزاهة، والشفافية في انتقاء الراغبين في التكليف.
وقد تبين ـ في مواقع متعددة ـ أن المكلفين مؤقتاـ بطريقة غير معلنة للرأي العام التربوي والإداري يحظون ـ رسميا ـ بالمناصب التي تم فيها قرار التكليف سابقا؛ الأمر الذي يطرح سؤالا كبيرا حول التزام “الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية” بضمان “ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق” بناء على الفصل 31 من الدستور؛ وجدّيةِ ومصداقيةِ المقابلات الانتقائية، وإعمالِ مبدأ تكافؤ الفرص بين الراغبين المترشحين لشغل مناصب المسؤولية، وتمكينهم من الحق نفسه في الحصول على المعلومات والمعطيات “الموثوقة” الضامنة “للتنافس النزيه والحر والمشروع ” (المادة 10 من القانون 13ـ 31 ) المتعلقة بالمنصب موضوع التباري على قدم المساواة بينهم في سياق الإعمال الفعلي للحق في الوصول إلى المعلومة (الفصل 27 من دستور البلاد ـ المواد 11 وما بعدها في القانون 13 ـ 31 ـ المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 22 فبراير 2018)، وتثمين كفاءات لها باعٌ طويل في تدبير بنيات إدارية لا ممركزة لسنوات طوال، وانتسابها إلى أطر وظيفية عليا من حيث التكوين والإطار والدرجة، بالإضافة إلى خبراتها المعرفية والمهنية، وتكوينها المستمر؛ ومشاركاتها المشهود عليها في مختلف محطات الإصلاح التربوي قديمِها وحديثِها؛ مما يسقط الإدارة صاحبة المنصب الشاغر في ممارسة بعض أشكال “التمييز” الضمني أو الصريح المحظور دستوريا (تصدير دستور 2011)، و”أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية .. والشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز (الفصل 36 من الدستور).
ويمكن القول إن الاختلال المشار إليه آنفا يكشف ـ في أحد جوانبه ـ عن ضعف المؤهلات الوظيفية، والمعرفية والكفايات التدبيرية للمعنيين بمناصب المسؤولية المشار إليهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات المذكور سابقا ؛ كما يستلزم ـ من جهة ثانية ـ ضرورة تفعيل “وصاية الدولة” على القرارات الإدارية المتخذة ـ في هذا الباب ـ من لدن رؤساء لجن المقابلات الانتقائية المعينة، باعتبار “الأكاديميات الجهوية مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي” و تخضع ـ في الوقت ذاته ـ لوصاية الدولة” فيما يخص تقيد أجهزتها بأحكام القانون خصوصا ما يتعلق بالمهام المسندة إليها، والحرص بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.” من لدن رؤسائها؛ وتخضع أيضا “ للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية، كما هو مثبت في المادة الأولى من القانون رقم 07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ وهو مدخل أساس لتخليق الحكامة العمومية للمنظومة التربوية، و” تعزيز اليقظة القانونية” (المادتان الأولى والسادسة والعشرون (1 و26) من المرسوم المنظم لاختصاصات وزارة التربية الوطنية غشت 2024)؛ ومحاسبة من تسبب في تراجع المهن التدبيرية”، وتخلفها عن تحقيق أهداف المنظومة التربوية كما ونوعا.
وقد أخضع الفصل 154 من الدستور “المرافق العمومية لمعايير الشفافية والجودة”، كما أخضع تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية” المنشودة مجتمعيا، بما في ذلك “تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية”، وأسند هذه المهمة إلى المجلس الأعلى للحسابات (الفصل 147)؛ بالإضافة إلى “مبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة” المفروض على “أعوان المرافق العمومية” الالتزام بها أثناء تأدية وظائفهم (الفصل 155).
وقد سبق للتقرير العام عن نصف قرن من التنمية البشرية” (2005) أن تنبأ، بالطريق التراجعي للحكامة في مغرب 2025 (ص31) داعيا إلى جعل “ الحركية والمحاسبة والشفافية والتقويم، قيما عادية في تدبير الشأن العام”؛ وشدد التقرير نفسه على ضرورة أن يتسم ” نظام اتخاذ القرار بالعقلنة وبالتفاعلية؛ ذلك أن تدخل الدولة يكون أكثر نجاعة عندما تضطلع بالمهام الكاملة بصفتها القيمة على وضع الاستراتيجية وقواعد الضبط، وعندما توفر أوسع شروط الشفافية بالنسبة للفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين” (ص35) سعيا إلى تحقق “المغرب المأمول” في أفق 2025 الذي يشكّل تحسينُ نظام حكامته” واحدا من الرهانات الخمس التي يمكن كسبها لتحقيق ذلك ص 33) ؛ كما نحا تقرير اليونسكو المنحى نفسه حين أكد ـ في سياق تكريس آلية المساءلة في التعليم ـ على ضرورة “مساءلة الحكومات في المقام الأول باعتبارها الجهة الضامنة للحق في التعليم وعلى عاتقها تقع المسؤولية في إحقاق هذا الحق” الفصل 21 ص 296 من ” المساءلة في مجال التعليم” ـ 2018. وقد ألزمت المادة 41 من القانون الإطار ” منظومة التدبير الداخلي لمؤسسات التربية والتكوين بما فيها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في السياق ذاته ـ أن تقوم على ” مبادئ الديمقراطية والمسؤولية والتفويض، والشفافية، والمحاسبة، والترشيد..”.
إن عضوية لجن الانتقاء الأولي، والمقابلات الانتقائية واجب مهني عظيم الشأن، ينبغي استثماره في تحقيق “التنافس الشريف” بين المترشحين كافة؛ ومسؤولية جسيمة وجب ربطها بالمحاسبة، كما ينص على ذلك دستور 2011؛ ووجب ضبط أدوارها ومهامها، وحماية أعضائها من كل أشكال ” التوجيه عن بعد”، وتأمين استقلاليتهم ـ في تقديراتهم وقراراتهم ـ عن سلطة الإدارة، وتصرفاتها المخالفة للمبادئ الدستورية، والقواعد القانونية، والمعايير الأخلاقية إن وُجدتْ؛ علما أن بعض القرارات المتعلقة بفتح باب الترشيح لشغل منصب شاغر، تشير إلى إحداث لجنة واحدة فقط تقوم “بالانتقاء الأولي للمترشحات والمترشحين وإجراء المقابلات معهم”، دون تحديد طبيعة المهام التي يمكن أن يقوم بها أعضاء هذه اللجنة، خاصة إذا علمنا أن مرحلة الانتقاء الأولي ذات طبيعة تقنية لا غير، هدفها “دراسة ملفات الترشيح” وتدقيق الوثائق والشروط المطلوبة للترشح، ومدى ملاءمتها للوظيفة المطلوبة؛ علما أن المذكرة الوزارية رقم 15 بتاريخ 8 مارس 2004 الموجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين دعت إلى إحداث ثلاث لجن هي: لجنة القيادة، ولجنة الانتقاء، ولجنة المقابلة؛ مع تحديد جملة من المعايير التي ينبغي على لجنة القيادة اعتمادها في الانتقاء الأولي للمترشحين.
ويزداد الأمر تعقيدا إذا علمنا أن لرئيس الإدارة المعنية بالمنصب الشاغر حقا في الاستعانة “بخبراء متخصصين” عند الاقتضاء (المادة 9 من المرسوم رقم 681 ـ 11 ـ 2 بتاريخ 25 نونبر 2011 “في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية”)، أو “متخصصين” فحسب دون وصلها بكلمة خبراء (في منشور رئيس الحكومة رقم 2013 ـ 7 بتاريخ 29 أبريل 2013) لا يسمح لهم وقتهم ومهامهم بالمشاركة في عمل تقني يجب أن تقوم به الإدارة المعنية بالإعلان عن المناصب الشاغرة لوحدها (المادة 6 من المرسوم المشار إليه أعلاه).
وبغض النظر عن المحمول العلمي والقيمي لاصطلاح “خبراء متخصصين”، فإن الوقائع والشهادات المستقاة من الميدان تؤكد لجوء الإدارة المعنية بالإعلان عن التباري لشغل مناصب المسؤولية، إلى “تعيين” بعض مسؤولي المؤسسات العمومية، أو ممثلي القطاعات الوزارية بالجهة أعضاء في لجن المقابلات الانتقائية، واعتبارهم خبراء متخصصين، أو متخصصين على الأقل (بتعبير منشور رئيس الحكومة رقم 2013 ـ 7 بتاريخ 29 أبريل 2013)، دون أن تكون لبعضِهم أو جلِّهم علاقة بقضايا وإشكالات التدبير الإداري للشأن التربوي جهويا وإقليميا؛ مما يطرح سؤالا جوهريا عن “القيمة المضافة” من لدن هؤلاء إلى عمل لجنة المقابلة الانتقائية، ومصداقية تقييم عمل المترشح.
ومن المعلوم أن الإدارة لا تُفصح ـ ضمن قراراتها ـ عن المعايير العامة المحددة لاختيار أعضاء اللجن؛ أو اقتراح أعضاء ملائمين للمنصب المعلن عنه، ولمواصفات المترشح في الوقت نفسه. غير أنه من الطبيعي، والمعقول جدا أن يكون أعضاء اللجنة، أعلى من المترشح من حيث الدرجة الوظيفية، والتكوين العلمي والخبرة المهنية، والمسؤوليات الإدارية السابقة والحالية المزامنة للمقابلة الانتقائية في مجال تخصصه. كما لا يعقل ـ في المقابل ـ أن يكون عضو اللجنة مرؤوسا أو رئيسا إداريا سابقا للمترشح لاحتمال محاباة المترشح، أو “تصفية حسابات” بعيدة عن غايات واهتمامات المقابلة الانتقائية، تفتح الباب “لاحتمال تثمين عمل المترشح أو تقزيمه ـ بكيفية مزاجية ـ داخل الحلبة” بقفازات رياضية ولباس رسمي أنيق”!
إن تمثيلية النساء في اللجن ـ بمعدل امراة واحدة على الأقل ـ أمر واجب، إعمالا لمبدأي المناصفة والمساواة الدستوريين من جهة، وتنفيذا لمقتضيات المرسوم والمنشور سالفي الذكر من جهة ثانية؛ غير أن الوقائع تثبت أن بعض اللجن تخلو من التمثيلية النسوية، أو ـ على الأقل ـ لا يتوفر فيها العضو من النساء على شرط “شغل أحد مناصب المسؤولية”(المادة 9).
وقد نص منشور رئيس الحكومة ـ بصيغة الوجوب ـ على “ملاءمة مواضيع المقابلة الانتقائية للمترشحات والمترشحين مع المهام والصلاحيات المرتبطة بالمنصب المراد شغله” (الفقرة 4 ـ تحديد مساطر إجراء المقابلة الانتقائية)، غير أن بعض الأعضاء أو رئيس اللجنة يذهبون مذاهب شتى ـ خارج الإطارين القانوني والنظري للمقابلة الانتقائية، وتقنيات الاختبارات السيكو تقنية ـ في محاورة المترشح، من خلال استفساره عن أمور شخصية أحيانا، أو مباراة في كرة القدم، أو حرب “لن تقع” (مع الاعتذار من المخرج المغربي سهيل بن بركة عن التصرف في عنوان شريطه السينمائي)، وما شابه ذلك من مواضيع بعيدة كل البعد عن اختصاصات المنصب المطلوب، والتصورات الشخصية للمترشحين بالنسبة للمهام التي ستسند إليهم، وسبل الرفع من أدائها” (الفقرة الرابعة من منشور رئيس الحكومة ـ تحديد مساطر إجراء المقابلة الانتقائية)؛ وإصرار بعض الأعضاء على محاورة المترشح باللغة الفرنسية نكاية في اللغتين الدستوريتين للبلاد، من جهة، ونكاية في التكوين المدرسي والجامعي للمترشح بلغة أجنبية مغايرة (الإسبانية أو الإنجليزية) طيلة مساره التكويني طبقا للهندسة المنهاجية الرسمية المعتمدة بالمنظومة التربوية المدرسية والجامعية ببلادنا؛ ودونما حاجة موضوعية، أو علمية مرتبطة بالمنصب الشاغر تستلزم المحاورة بلغة محددة بشكل مسبق، من جهة أخرى .
وتجدر الإشارة إلى أن “مشاريع التصورات الشخصية” المتعلقة بتدبير البنية الإدارية موضوع المقابلة الانتقائية، والتي يَكدّ المترشحون في إعدادها، وبسط أسنادها القانونية، وأدبياتها التربوية، لا تحظى بأي تقدير مادي في تقييم عمل المترشح؛ بل إن أعضاء اللجنة أو معظمهم ـ حسب الشهادات المتحصل عليها ـ لا يطلعون عليها بشكل مسبق قبل إجراء المقابلة الانتقائية.
وهناك أمر آخر ـ ذو صلة وثيقة باحترام أحكام الدستور الخاصة بتلقي “المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها واقتراحاتهم وتظلماتهم”(الفصل 156)؛ وتنفيذ المساطر المعتمدة في كيفيات تعيين رؤساء الأقسام والمصالح، ومبدأ “النشر الاستباقي للمعلومة” ـ يتعلق بإمكان طعن المترشح في “التقرير النهائي للجنة بالوسائل المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل” (المادة 10 من المرسوم السابق)؛ غير أن الإدارة المعنية ـ وبعيدا عن إمكان اطلاع المترشح على التقرير من عدمه ـ لا تشير من قريب أو بعيد، حين الإعلان عن المناصب الشاغرة، أو إصدار لائحة المقبولين لشغل مناصب المسؤولية، إلى تقديم الطعون، وآجالها، والجهة المكلفة بتلقيها، والتدابير الممكن اتخاذها في حالة تقديم الطعون؛ كما أن غير المنتقين من المترشحين لا يتوصلون ـ بأي صيغة تواصلية ـ بالأسباب التي حالت دون انتقائهم؛ مما يعتبر تكتما غير مشروع على حق مشروع للمترشح، وإن لم يمارسه فعليا.
وعطفا على ما سبق، ووعيا من الجميع بأن “إساءة استخدام السلطة المفوضة إلى الإدارة مَفْسَدَةٌ من المفاسد الواجب دفعُها، والحيلولةُ دون وقوعها؛ وسعيا إلى تحقيق نجاعة ” المقابلة الانتقائية”، وتجويد أدواتها، ودمقرطة تصريفها؛ فإن الإدارة ، مدعوة ـ أثناء الإعلان عن المنصب الشاغر بها، أو إجراء المقابلة الانتقائية ـ إلى التقيد بأحكام الدستور ومبادئه بوصفه “أسمى قانون”؛ وباعتباره مستندا مرجعيا لحماية مبادى النزاهة، والشفافية، والمساواة، وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وإعمال آليتي المساءلة والمحاسبة؛ وكذا القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بتدبير عمليات إسناد مناصب المسؤولية الشاغرة بها، وعلى رأسها القانون الإطار الذي نص ـ في المادة السابعة والثلاثين منه ـ على إعداد الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، واعتمادها في “إسناد المسؤوليات التربوية والعلمية والإدارية، وتقييم الأداء والترقي المهني”؛ وعهد بهذه المهمة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين.
ويستلزم السياق ذاته ضرورة تقييم آلية المقابلة الانتقائية “الوافدة ـ منذ عقدين ونيف ـ على المنظومة التربوية من قطاعات إنتاجية وخدماتية مختلفة جذريا في مجالات وطرق اشتغالها، وتدبيرها وأهدافها، عن آليات اشتغال المنظومة التربوية، ومقاصدها ذات الصلة الوثيقة بواقع وأفق التنمية البشرية المستدامة ببلادنا؛ ومدى نجاعتها في اختيار مسؤولين أكفاء، على ضوء التراجعات التدبيرية التي نشهدها ميدانيا؛ كما يستلزم تأطيرا تشريعيا للتكليف بمهام المسؤولية بكيفية مؤقتة؛ و إلزام الإدارة بتسليم النموذج الموحد للسيرة الذاتية، و “مشاريع التصورات الشخصية” أو برامج العمل والمنهجية المقترحة لتدبير البنية الإدارية الشاغرة طبقا للمادة السابعة من المرسوم رقم 681 ـ 11 ـ 2 بتاريخ 25 نونبر 2011، إلى أعضاء لجنة المقابلة الانتقائية الذين يتعين عليهم قانونيا وأخلاقيا الاطلاع عليها قبل إجراء المقابلة الانتقائية بوقت كافٍ؛ واعتبارها أرضيةً لمحاورة المترشح، وأفقاً نظريا وعمليا لتقييم تصوره، وخبراته المعرفية والمهنية ومعارفه اللغوية، وقدرته على قيادة البنية الإدارية موضوع التباري؛
ويسْتوْجب السياق نفسه التصريح ـ أثناء الإعلان عن شغور مناصب المسؤولية، أو نشر لائحة المقبولين بعد إجراء المقابلة الانتقائية ـ بالمساطر والضمانات القانونية للمترشحين، وعلى رأسها التذكير بإمكان الطعن الفوري في أشغال لجنة الانتقاء والمقابلة؛ سواء تعلق الأمر بالظروف التي مرت فيها المقابلة الانتقائية، أم بجَرْح (أو تجْريح) أعضاء اللجنة (وقد نصت عليه المادة 273 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بتَجْريح القضاة (الجريدة الرسمية عدد 5374 بتاريخ فاتح دجنبر2005 ، كما تم اعتماد هذه المنهجية من لدن علماء الحديث في ضبط الأحاديث النبوية الشريفة، وصدقية رُواتها، وأسنادها منذ قرون خَلتْ)؛ مع ترتيب آثار المسؤولية القانونية على أعضائها في سياق تكريس قيم الشفافية، والتقييم، والضبط؛ وربط المسؤولية بالمحاسبة، و”تعزيز اليقظة القانونية” التي نصت عليها المادتان 1 و26 من المرسوم المنظم لاختصاصات وزارة التربية الوطنية (الجريدة الرسمية عدد 7324 بتاريخ 8 غشت 2024)، بوصفها آلية لضمان “الأمن القانوني”؛ عبر رقمنة شكاوى المعنيين بالأمر باستثمار مكتب الضبط الرقمي، والشباك الإلكتروني لتلقي الرسائل داخل الإدارات، وغيرهما من المنصات الرقمية “ المذكورة في البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 21 ـ 26 ـ المحور الثالث ـ الصفحة 75)؛ وإقرار ” طعون القرب” عبر وضع تظلم بمقر الإدارة المعنية بالمنصب الشاغر، مع إشهاد فوري بالتوصل به؛ وتدخل سلطة الوصاية ـ في حينه ـ من أجل إنصاف المتضررين من الممارسات التمييزية الضمنية والصريحة المخالفة للقواعد الدستورية ـ إن وُجدتْ ـ أو التصرفات الإدارية المخالفة للضوابط القانونية والمهنية المنظمة للعملية برمتها، تفعيلا لمقتضيات مرسوم 2011 الذي نص في المادة العاشرة منه على الطعن في التقرير النهائي؛ و“تعزيز اليقظة القانونية” المنصوص عليها في المادة الأولى والسادسة والعشرين من المرسوم رقم 328 بتاريخ 2 غشت 2024 المنظم لاختصاصات وزارة التربية الوطنية (الجريدة الرسمية عدد 7324 بتاريخ 8 غشت 2024)؛ بالإضافة إلى التعجيل بإعداد الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات المنصوص عليها في المادة 37 من القانون الإطار وفق مقاربة تشاركية تدمج قيم الشفافية والنزاهة، والمساءلة، والمساواة بين المترشحين لشغل المناصب الشاغرة؛ وإمكان النظر في تكوين لجن مقابلة مستقلة عن الإدارة صاحبة المنصب الشاغر، وضمان استقلالية أعضائها عنها في انتقاء المترشح الأنسب للمنصب موضوع التباري.
وجدير بالذكر أن المنتقين لشغل مناصب المسؤولية يشرعون في ممارسة مهامهم مباشرة بعد توصلهم برسائل التعيين، دون أن تكون لهم معرفة ودراية كافيتان بالتدبير الإداري؛ خاصة وأنهم “قادمون” من هيئات مهنية مختلفة من حيث التكوين والأطر الوظيفية، منصوص على أسمائها ومهامها في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، أو أنظمة أساسية أخرى تخص المهندسين والمتصرفين من الأطر المشتركة بين الوزارات. ويستدعي هذا الأمر إقرار تكوين نظري قبلي، وفُرصَ تدريبٍ ميداني في مراكز التكوين والبنيات الإدارية المماثلة، أو المديريات المركزية التابعة لها؛ إعمالا للقانون الإطار الذي نص في المادة الثامنة والثلاثين منه على اعتبار ” التكوين الأساس شرطا لازما” لولوج مهن التدريس، والتكوين والتأطير، والتدبير والتفتيش بالقطاع العام”؛ وإرساء آليات التكوينين المستمر والمتخصص (المادة 39 من القانون الإطار)؛ بالإضافة إلى المصاحبة والمواكبة الميدانيتين للمسؤولين الجدد.
وعطفا على ما سبق فإن التفكير في تجاوز المطبات والاختلالات سالفة الذكر، وغيْرِها مما لم نتمكن من رصْده، وإدراجه في هذا المقال، يمثل مدخلا أساسا لتجويد حكامة المنظومة التربوية ببلادنا، وتخليق أدواتها وكيفيات تصريفها؛ وتكريس دولة الحق والقانون، وابتكار آليات مؤسّسَتية بديلة أكثر عدلا وإنصافا، تتيح لمنظومتنا التربوية تحسين مؤشر “سيادة القانون” وفعليته، من جهة، واستكمال الإصلاح التربوي، والارتقاء ـ من جهة ثانية ـ بالأداء والتنفيذ الإداريين ـ جهويا وإقليميا ومحليا ـ لمضامينه، ومستلزماته، وقيمه المستمدة من دستور بلادنا، وأحكام القانون الإطار.
(×) فاعل تربوي


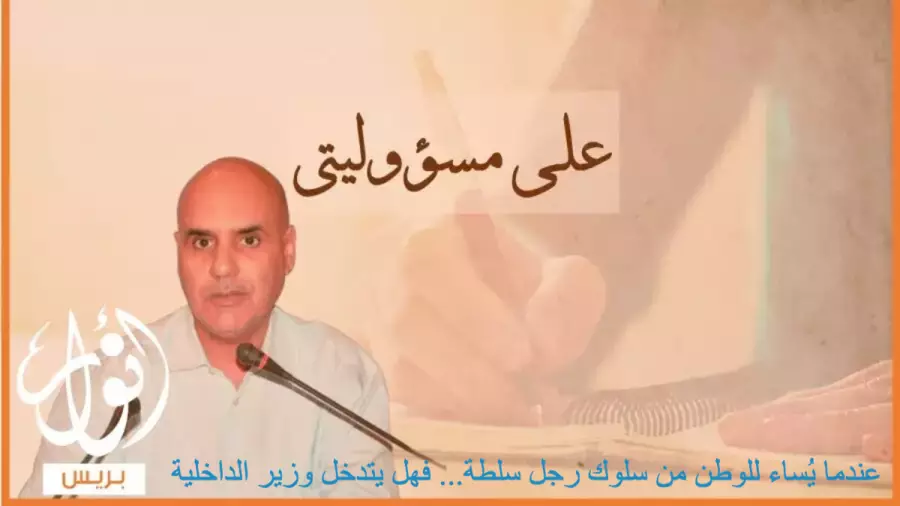




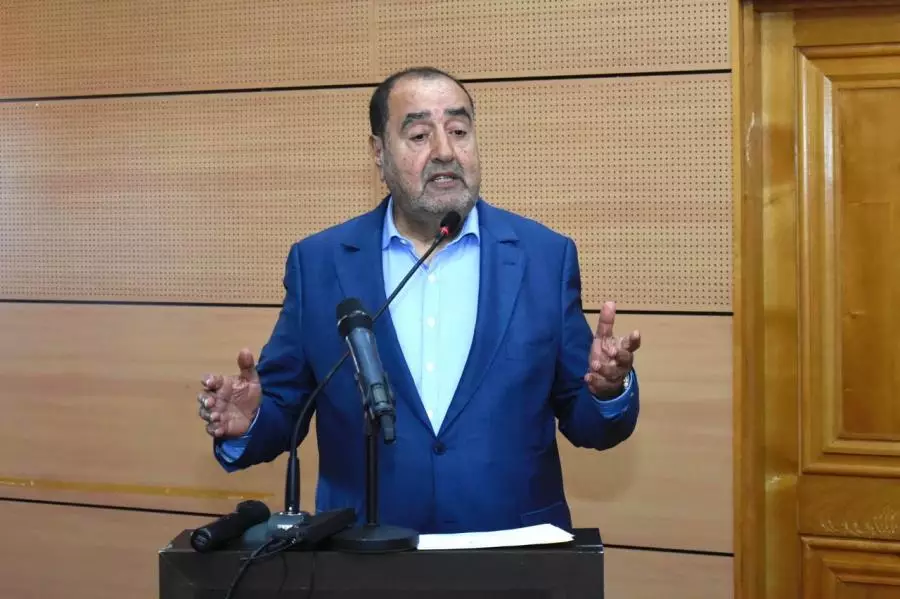




تعليقات
0