د. محمد أمحدوك (*)
تعتبر الأسرةُ أو “أَيْتْ وخَامْ” (ⴰⵢⵜ ⵓⵅⴰⵎ) أساسَ المجتمع الأمازيغيّ الزّيانيّ، وتتكون عادةً من كلّ الأفراد الّذين يعيشون في الخيمة نفسها، ويخضعون لإشراف وسلطة رئيسها “بَابْ وخَامْ” (ⴱⴰⴱ ⵓⵅⴰⵎ)، سواء كانوا (أو لم يكونوا) من نفس الدّم والسّلالة، على غرار أطفال التّبنّي، والرّعاة، والعبيد، والأغراب المقيمين في الدّار، كالرّجال المتزوّجين من نسائها مقابل التزامهم بالخدمة والعمل من أجل تطوير مواردها وتنمية محاصيلها. وبما أنّ كلّ طقسٍ أو احتفالٍ شعبيٍّ مرتبطٌ في الأسر الأمازيغيّة بمنظومة قيمٍ ومعايير متكاملةٍ، وكانت مختلف البنيات الاحتفاليّة في كثيرٍ من الأنساق الثّقافيّة مادّةً مرجعيّةً تُفهم من خلالها التّمثّلات الاجتماعيّة، بوصفها أنساقاً رمزيّةً تشتغل فيها الطّقوس بصيغٍ متباينةٍ، وعلى مستوياتٍ متعدّدةٍ، يعدّ الاحتفالُ ب “إِيْضْ نْ نَّايْرْ” (ⵉⴹ ⵏ ⵏⵏⴰⵢⵔ) في المجتمع الزّيانيّ بالأطلس المتوسّط مفتاحاً ذهبيّاً للتّغلغل إلى أعماق الهويّة المحلّية واستكناه جوهرها؛ إذ يقدّم، بشكلٍ مكثّفٍ، شعوراً خاصّاً بالذّات الفرديّة المنصهرة في جماعتها، ومدخلاً أساسيّاً لتفسير التّغيّرات السّوسيوثقافيّة والفكريّة الّتي شهدتها “قبائل إِزيَّانْ” في أزمنتها الطّويلة، مثلما يعينُ الزّيانيّين ذاتهم، بمحتوياته الفريدة، على التّعرّف على أنفسهم وعواطفهم وآمالهم، ويبرز قدرةً هائلةً على تنظيم نبضهم، وتعزيز انسجامهم.
ومن ثمّة، تستهدف هذه الدّراسة استِغْوارَ ظاهرةِ الاحتفالِ ب”إِيْضْ نْ نَّايْرْ” باعتبارها من عناصر الثّقافة الشّعبيّة الأمازيغيّة الزّيانيّة، والبحثَ في مظاهر ودلالات بعض طقوسها الاحتفاليّة ذات المرجعيّات التّاريخيّة والأسطوريّة والمجاليّة، فضلاً عن الكشف عن بعض سياقات إنتاج المعنى داخل هذا المجتمع الأمازيغيّ، وذلك عبر مساءلة هذه الطّقوس وتفكيك آليّات بنائها الثّقافيّة، استناداً إلى المنهج الوصفيّ التّحليليّ وإلى مقاربةٍ أنثروبولوجيّةٍ تنتصر لنمطٍ تفكيريٍّ علائقيٍّ يربط بين الشّكل الطّقسيّ ومنطقه التّأسيسيّ وامتداداته الثّقافيّة.
مقدّمة:
تعتبر الظّاهرة الطّقوسيّة مجالاً خصباً لمجموعةٍ من الدّراسات والأبحاث السّوسيولوجيّة والأنثروبولوجيّة الّتي تشتغل باستمرارٍ على “البحث عن المعنى”، وتحفلُ بالجوانب الدّلاليّة والرّمزيّة والوقائع الاجتماعيّة اللّامفكّر فيها؛ حيث تكتنز ضمنها الطّقوسُ الاحتفاليّةُ تاريخاً من العلاقات والمتخيّلات والخطابات والممارسات الّتي تظلّ دوماً بحاجةٍ إلى القراءة والتّرتيب والتّركيب والتّفسير. خاصّةً أنّ المجتمع الأمازيغيّ، وهو القرويّ بطبعه، يعدّ خزّاناً ثقافيّاً لنسقٍ من الممارسات الطّقوسيّة والأنشطة الرّمزيّة الّتي يتّخذها أفراده لتنظيم حياتهم الاجتماعيّة وتدبير أنشطتهم الفلاحيّة اليوميّة والتّفاوض مع واقعهم وعلاقاتهم مع الطّبيعة. وهكذا تشغلُ الطّقوسُ الموسميّةُ / الفصليّةُ جانباً كبيراً من هذه الدّيناميّات، لأنّها المنطق الّذي تنتظم به حياتهم بشكلٍ عامٍّ. فلكلّ فصلٍ(موسمٍ) من هذه الفصول (المواسم) طقوسُه وانشغالاتُه، يحيط الفلّاحون به معتقداتٍ وإيماءاتٍ رمزيّةً كثيرةً، يستهدفون من ورائها تنمية محاصيلهم الزّراعيّة ودعم تقدّم العمل في الحقول، عبر تجديد التّحالف مع عالم الموتى والأوصيّاء وأصحاب الأرض، الّذي يأتي بكلّ حياةٍ وكلّ خصوبة (1). وبالتّالي يحيلنا التّفكير في هذه الممارسات إلى جذورها التّاريخيّة الموغلة في القدم، وهي المرحلة الّتي يصطلح عليها بالمرحلة الأمنيسية (مرحلة إضفاء الحياة على الطّبيعة) (2)، أو إلى أبعادها الاجتماعيّة، ما دام الميل الطّبيعيّ للاجتماع، كما قال ابن خلدون، يجعل الإنسان يتمثّل كلّ ما هو شعبيٌّ واحتفاليٌّ وجمعيٌّ، وينغمس في كلّ ما هو شعائريٌّ وطقوسيٌّ لاستبطان ما هو روحيٌّ، وتشخيص نسقه الاجتماعيّ وإدراك تمفصلاته المتباينة. ومن ذلك طقوس الاحتفال برأس السّنة أو “إِيضْ نْ نَّايْرْ”، الّتي تعتمل في المجتمع الزّيانيّ في إطار فعاليّاتٍ طُقوسيّةٍ تزخر بمنظومةٍ رمزيّةٍ فعّالةٍ ودالّةٍ على جوانب من تاريخ هذا المجتمع العريق وخصوصيّاته الثّقافيّة والاجتماعيّة.
ويمثّل الطّقس الشّعبيّ، بهذا الصّدد، مفهوماً فارقاً لدى قبائل “إِزيَّانْ”، لأنّه لا يشكّل بالنّسبة إليهم مجرّد شعيرةٍ عابرةٍ لا معنى لها، أو احتفالاً عامّاً بلا جوهرٍ، وإنّما يعدُّ جزءاً أصيلاً وأساسيّاً من الموروث الثّقافيّ الأمازيغيّ، الّذي يعتبر نافذةً إضافيّةً للتّنشئة الاجتماعيّة بهذه الرّبوع؛ بالنّظر إلى ارتباطه بالقيم الإنسانيّة العليامن جهةٍ، وتعلّقه بمفاهيم الإثنيّة والعرق والهويّة المحلّيّة من جهةٍ أخرى. ومن ثمّ لا يوجد طقسٌ شعبيٌّ أو احتفالٌ زيانيٌّ إلّا ويرتبط بنسقٍ قيميٍّ معيّنٍ، خاصّةً أنّ القيم الاجتماعيّة والأنساق الأخلاقيّة والرّوحيّة هي أساس الاحتفالات في كلّ ربوع “تَامَازْغَا”. فمن خلالها يتمّ تثبيت مجموعةٍ من القيم والمعايير الاجتماعيّة والتّأكيد على نماذج من الأعراف، والتّقيّد بمجموعةٍ من الشّعائر، ممّا يفسّر تعلّق هذه القبيلة الأمازيغيّة، كغيرها من القبائل والكيانات الإثنيّة، بطقوسها واحتفالاتها (3). ولذلك تعدّ من المستندات الدّفينة الّتي يَستنبِط من خلالها الدّارسون المعطيات الموضّحة والمكمّلة للوثائق الأدبيّة والفنّيّة والتّاريخيّة والجغرافيّة..(4)
ولمّا كان موضوع دراستنا هو الأنساق الاحتفاليّة من حيث مظاهرُها ودلالاتُها في طقوس “إِيضْ نْ نَّايْرْ” عند “إِزيَّانْ”، فقد كان لا بدّ من رصد وفهم طبيعة هاته الاحتفالات المحليّة، وذلك بالاستناد إلى الخصوصيّات الطّبيعيّة والتّاريخيّة والثّقافيّة للمجال الزّيانيّ؛ لأنّها المسؤولة عن اشتغال البنيات الثّقافيّة الّتي تعطي الأولويّة دائماً للأرض وللعائلتين: الصّغيرة “الأسرة” (أَيْتْ وخَامْ) والكبيرة “المدشر / القبيلة” (أَسُونْ / تَاقْبِيلْتْ)، ما دامتا منبع جزءٍ كبيرٍ من أشكال التّنشئة الاجتماعيّة، وفيهما يتلقّى الفرد قيم الجماعة (من خلال أعرافٍ كثيرةٍ مثل “تِيوِيزِي” (ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ) و تَاضَا (ⵜⴰⴹⴰ) وتَايْمَاتْ (ⵜⴰⵢⵎⴰⵜ) وغيرها).
- الإشكاليّة:
مع كلّ دورة عامٍ جديدٍ تطفو إلى السّطح ببلادنا تساؤلاتٌ كثيرةٌ مرتبطةٌ بأصول ومظاهر ودلالات الاحتفال برأس السّنة الأمازيغيّة، نبلورها في إطارٍ إشكاليٍّ لصيقٍ بالمجال الزّيانيّ، ونقول: كيف يمكن من جهةٍ تفسير الطّقوس الاحتفاليّة ل”إِزيَّان” ب “إيضْ نْ نَّايْرْ”، ومن جهةٍ أخرى تمكّنها من الصّمود لمدة طويلةٍ جدّاً، دون أن تندثر أو يلفّها النّسيان، على الرّغم من الغزو المتكرّر لأراضيهم؟
وتتفرّع هذه الإشكاليّة إلى أسئلةٍ صغرى كثيرةٍ، من قبيل:
- كيف تحتفل قبائل “زَيَان” بهذه المناسبة؟
- كيف يمكن تفسير أنساق طقوسهم الاحتفاليّة بها واستمرارُها لديهم رغم تراجع الكثير من مظاهر طقوسهم الاحتفاليّة الأخرى؟
- كيف تسهم في إنتاج / إعادة إنتاج الرّموز والمعتقدات الثّقافيّة؟
- ما أبرز الوظائف الّتي تلعبها عندهم هذه الطّقوس والشّعائر الاحتفاليّة؟
- الفرضيّات:
للإجابة على أسئلة الدّراسة، يمكن الانطلاق من الفرضيّات الآتية:
- تحتفل القبائل الزّيانيّة كغيرها من القبائل الأمازيغيّة ب”إيضْ نْ نَّايْرْ” بالطّقوس والشّعائر نفسها المعروفة في شمال أفريقيا والحوض المتوسّطيّ.
- يرجع احتفال الزّيانيّين بهذه المناسبة للأسباب التّاريخيّة والميثيّة الّتي تجعل الأمازيغيّين عامّةً يحتفلون بها.
- ارتباط طقوس “إيضْ نْ نَّايْرْ” بالموسم الفلاحيّ لدى القبائل الزّيانيّة هو الدّافع الأساسيّ لإنتاج وإعادة إنتاج هذه المظاهر الاحتفاليّة المختلفة.
- الوظائف الاجتماعيّة والثّقافيّة والاقتصاديّة للأنساق الطّقوسيّة الاحتفاليّة بهذه المناسبة هي الدّافع الرّئيس لإنتاجها وإعادة إنتاجها.
- أهمّية موضوع الدّراسة:
يكتسي هذا الموضوع أهمّيةً بالغةً بالنّظر إلى:
- اشتغاله على الطّقوس الاحتفاليّة ب”إِيضْ نْ نَّايْرْ” عند الأمازيغ عامّةً، وفي بلاد إزيّان خاصّةً؛
- احتفال الأمازيغيّين الدّائم بهذه المناسبة لأنّه يذكّرهم بماضيهم العريق من جهةٍ أولى، ويؤكّد ارتباطهم بأرضهم من جهةٍ ثانيةٍ، ويعدّ عندهم من أهمّ مصادر التّنشئة الاجتماعيّة من جهةٍ ثالثةٍ؛
- أهمّية هذا الاحتفال في تحديد جوانب كثيرةٍ من مقوّمات الهويّة الأمازيغيّة للمجتمع المغربيّ.
- أهداف الدّراسة:
تتوخّى هذه الدّراسة بشكلٍ عامٍّ كشف شروط إنتاج المعنى داخل المجتمع الأمازيغيّ عامّةً، والزّيانيّ خاصّةً، عبر مساءلة طقوس الاحتفال ب “إِيضْ نْ نَّايْرْ “، وتفكيك بعض آليّات بنائها الثّقافيّ، من خلال التّركيز على أساطيرها وحكاياتها المؤسّسة، فضلاً عن الوقائع التّاريخيّة والامتدادات العلائقيّة للإنسان بالطّبيعة، الّتي تتفاعل في بوتقةٍ واحدةٍ، لتصبح أفق اشتغالٍ وبناءٍ وتركيبٍ، حسب التّحوّلات الاجتماعيّة والتّاريخيّة والاقتصاديّة في المجال الزّيانيّ. لا سيّما أنّ البنيات الشّعائريّة والرّمزيّة في كثيرٍ من هذه الأنساق تشكّل إمكاناً قرائيّاً كثيفاً لبحث التّمثّلات والتّصوّرات المجتمعيّة بشأن الوقائع والأشياء ومختلف الممارسات الواعية واللّاواعية، ومن ثمّ تكون العودة إلى هذا البناء الرّمزيّ نابعةً من الاقتناع بأنّ المجتمع الزّيانيّ، أو بالأحرى ثقافته الشّعبيّة والعالمة، نسقٌ علاميٌّ تعتمل فيه الرّموز على مستوياتٍ عديدةٍ وبصيغٍ متباينة (5) ومن ثمّ يستهدف هذه المنجز:
- الوقوف على بعض الجوانب التّاريخيّة والاجتماعيّة والثّقافيّة الزيانيّة، خصوصاً تلك المرتبطة بالاحتفال ب “إِيضْ نْ نَّايْرْ “؛
- رصد بعض التّمايزات والفروق الّتي تميّز احتفال قبائل “إِزيَّانْ” ب”إِيضْ نْ نَّايْرْ” عن غيرها من القبائل الأمازيغيّة؛
- تفسير أنساق الطّقوس الاحتفاليّة بهذه المناسبة، والتّوقّف عند سبب استمرارها بالمجتمع الزّيانيّ رغم التّراجع المحلّيّ لكثيرٍ من المظاهر الطّقوسيّة الاحتفاليّة الأخرى؛
- التّعرّف على كيفيّة إسهام هذه الطّقوس في إنتاج / إعادة إنتاج الرّموز والمعتقدات الثّقافيّة الأمازيغيّة المحلّيّة.
- منهجيّة الدّراسة:
يقتضي كلّ عملٍ بحثيٍّ، منذ ولادة فكرته إلى أن يصير بناءً قائماً متكاملاً، السّيرَ وفق مبدإٍ كلّيٍ يحكمه ويوجّهه ويسدّده. وهو ما لا يتحقّق إلّا باّتباع منهجٍ رصينٍ يلائم ويناسب الإشكال العلميّ المطروح وموضوع البحث، ومن ثمّ تبنّت هذه الدّراسة أربعة مناهج رئيسةٍ ومتكاملةٍ:
- المنهج الوصفيّ: عبر جمع المادّة البحثيّة من مظانّها وتقديمها عبر آليّة الاستقراء؛
- المنهج التّحليليّ: من خلال تحليل وثائق موضوع الدّراسة وعناصرها (تحليل المضمون)، وتفكيك ما تضمّنته من إشكالاتٍ ومفارقاتٍ؛
- المنهج المقارن: من خلال مقارنة طقوس الاحتفال ب”إيضْ نْ نَّايْرْ” بنظيرتها في مجالاتٍ جغرافيّةٍ أخرى.
- المنهج التّاريخيّ: من خلال العمل على التّتبّع الجزئيّ لبعض الطّقوس الاحتفاليّة المرتبطة بهذه المناسبة عبر الزّمن (الماضي/الحاضر).
- خطّة الدّراسة:
بالنّظر إلى أهمّية موضوع البحث، فإنّنا نعرض محاوره عبر الهندسة الآتية:
- المطلب الأوّل: المدخلُ المفهوميُّ: التّحديدُ المصطلحيُّ لبعض المداخل المفهوميّة المهيكلة للدّراسة: الطّقوس الأمازيغيّة، والاحتفال، والأسرة، والقبيلة، والتّعريفُ بقبائل “زَيَانْ” أصلاً لغويّاً، وموقعاً جغرافيّاً، ومجالاً طبيعياً، وأصولاً تاريخيّةً…
- المطلب الثّاني: “إِيضْ نْ نَّايْرْ”: بحثٌ في التّسمية والأصول الطّبيعيّة والتّاريخيّة والميثيّة والطّقوس الاحتفاليّة؛
- المطلب الثّالث: “إيضْ نْ نَّايْرْ”: جوانبُ من بعض الطّقوس الاحتفاليّة الزّيانيّة؛
- المطلب الرّابع: “إيضْ نْ نَّايْرْ”: دلالاتُ ووظائف بعض الطّقوس الاحتفاليّة عند قبائل زيان.
- اَلْمَدْخَلُ الْمَفْهُومِيُّ
للإحاطة بمجمل المداخل المفهوميّة والمصطلحيّة المؤطّرة لموضوع الدّراسة، سنحاول في البداية تحديد أبعادها المضمونيّة الرّئيسة، كما حدّدتها بعضُ المعجمات اللّغويّة وثلّةٌ من الدّراسات التّاريخيّة والأنثروبولوجيّة والسّوسيولوجيّة (الطُّقُوسُ الْأَمَازِيغِيّةُ، وَالْاِحْتِفَالُ، والْأُسْرَةُ، والقَبِيلَةُ، وقَبِيلَةُ إِزيَانْ):
- الطُّقُوسُ الْأَمَازِيغِيّةُ:
الطّقسُ في اللّغة النّظامُ والتّرتيبُ. وعند النّصارى: نظامُ الخدمة الدّينيّة وشعائرُها واحتفالاتُها (6)، ويحيل مقابلها الفرنسيّ (rite) المشتقُّ من الأصل اللّاتينيّ (ritus) إلى الاحتفالات المتعلّقة بالمعتقدات الخارقة للطّبيعة، وكذلك التّقاليدُ الاجتماعيّةُ البسيطة (7)، فضلاً عن العادات الخاصّة بمجتمعٍ معيّنٍ، مثلما يصف تكرار بعض الأفعال بصورةٍ قويّةٍ، مثل التّلاوة أو العدّ قبل القيام بأيّ عمل (8). ويدلّ، في الاصطلاح، على كلّ سلوكٍ فرديٍّ أو جماعيٍّ، يلتزمُ بمجموعةٍ من القواعد الّتي تشكّل طقوسيّته، وأبرزها التّكرار، رغم توفّره على هامشٍ من الارتجال، وعلى كلّ أنواع الاحتفالات الّتي تعكس المعتقدات؛ لكونها فعاليّاتٍ وأعمالاً تقليديّةً لها في الأغلب علاقةٌ بالدّين والسّحر، يحدّد العرفُ أسبابها وأغراضها (9). وقد يتعدّى معناه ذلك ليعبّر عن مجموع الأفعال والممارسات الّتي تخضع لقواعد نظاميّةٍ لها صفة القداسة في نفوس أصحابها، وهي ذات سلطةٍ ملزمةٍ ضابطةٍ.
ومن ثمّة تشير الطّقوس الأمازيغيّة إلى مجموع الشّعائر والاحتفالات الّتي تقام في مختلف المناطق الأمازيغيّة بشكلٍ تقليديٍّ، وتعبّر عن ديمومة الأحداث الاجتماعيّة والمعتقدات الّتي عرفتها السّاكنة، وتشير في مجملها إلى الارتباط بين الإنسان والطّبيعة، على غرار احتفالات “إيضْ نْ نَّايْرْ”، و”تَاغْنْجَا”، و”ثَافْسُوتْ” وغيرها. كما أنّ لكلّ احتفالٍ منها طقوسُهُ الخاصّةُ وموسمُه المحدّدُ، وإن كانت في الغالب ترتبط بالموسم الفلاحيّ / الزّراعي أو المناسبات المختلفة الّتي تعارف عليها الأمازيغيّون منذ القدم، وربطوها بمعطياتٍ طبيعيّةٍ أو بأحداثٍ ووقائع تاريخيّةٍ أو أسطوريّة (10).
- اَلْاِحْتِفَالُ:
الاحتفالُ، لغةً، من حفل الماء واجتماعه، ويحفلُ حفلاً وحفولاً وحفيلاً، اجتمع كاحتفلَ، وتحفّلَ تزيّنَ، والمجلس كثر أهله (11). والحفلُ الاجتماعُ والاحتشادُ والتّجمّعُ، وتزيّنُ الشّيء ووضوحُهُ. ويطلق في الاصطلاح على اجتماع النّاس واحتشادهم في أبهى زينةٍ وأجمل حلّةٍ، وظهورهم للعيان، من خلال احتفاليّتهم الشّعبيّة (12). ويعرّفه مصطفى شاكر في القاموس الّذي خصّه للمصطلحات الأنثربولوجيّة بأنّه تجمّعُ عددٍ من أفراد المجتمع، بهدف التّعبير عن وجهات نظرٍ مشتركةٍ بفعاليّاتٍ منظّمةٍ رمزيّةٍ، تؤدّى في مناسباتٍ معلومة (13).
- اَلْأُسْرَةُ:
الأسرة في اللّغة الدّرع الحصين، وأهل الرّجل وعشيرته، وتطلق على الجماعات الّتي يربطها أمرٍ مشترك (14)، كما تأتي بمعنى معيشة رجلٍ وامرأةٍ أو أكثر على أساس العلاقات الجنسيّة الّتي يقرّها المجتمع، وما يترتّب على ذلك من واجبات كرعاية الأطفال المنجبين وتربيتهم ثمّ امتيازات كلّ من الزّوجين إزاء الآخر وإزاء أقاربهم وإزاء المجتمع ككلّ (15). مثلما تحيل إلى جملة الأفراد الّذين يرتبطون معاً بروابط الزّواج والدّم والتّبنّي ويتفاعلون معا (16).
ورغم أنّها مؤسّسةٌ اجتماعيّةٌ ضاربةٌ في القدم، إلّا أنّ مفهومها ما يزال غامضاً؛ حيث تتباين تعريفاتها، وتتعدّد تصنيفاتها بين أنماطٍ مختلفةٍ: الأسرة الأبيسيّة، والأسرة الأميسيّة، والأسرة البنيويّة، والأسرة الشّرعيّة، والأسرة الطّبيعيّة، والأسرة النّوويّة أو الزّوجيّة، والأسرة الممتدّة..(17) غير أنّها تعدّ من الوجهة السّوسيواقتصاديّة الخليّة الأولى واللّبنة الأساس الّتي يتشكّل منها المجتمع الإنسانيّ، لأنّها ليست سوى صورةٍ مصغّرةٍ تعكس هويّة المجتمع وواقعه بكلّ أبعاده الإنسانيّة والاجتماعيّة والثّقافيّة والاقتصاديّة… كما أنّها ليست فقط استجابةً لضرورةٍ إنسانيّةٍ اقتضتها استمراريّة النّوع البشريّ وتعاقبه؛ وإنّما تمثّل أيضاً حتميّةً اجتماعيّةً تعكس طبيعة الإنسان الميّالة إلى الارتباط والاجتماع بالآخر، ما دام، كما هو متداولٌ: “عاجزاً بنفسه مستطيعاً بغيره”. ومن ثمّة، فهي ترتكز في تطوّرها واستمرارها على ثنائيّةٍ مركزيّةٍ يتقاسمها مقوّمان أساسيّان: مقوّمٌ إنسانيٌّ اجتماعيٌّ، ومقوّمٌ اقتصاديٌّ نفعيٌّ؛ إذ لا يمكن، من جهةٍ، أن تقوم أو تستمرّ إلّا بوجود علاقةٍ اجتماعيّةٍ وإنسانيّةٍ مميّزةٍ، يطبعها الودّ والاحترام والتّعاون والتّكافل. ويتطلّب تكوينها واستمرارها، من جهةٍ أخرى، احترام مجموعةٍ من الالتزامات والحقوق، ومراعاة بعض الضّوابط المحدّدة للعلاقات الاقتصاديّة بين أفرادها.
واستناداً إلى ذلك، سنشتغل في هذه الدّراسة على “الأسرة الممتدّة”، أي تلك الّتي لا تقتصر في بنيتها التّكوينيّة على الزّوجين والأبناء فقط، كالأسرة النّوويّة، وإنّما تنسحب على كافّة الأفراد الّذين يجمعهم داخلها العيشُ المشتركُ والتّعاونُ والتّكافلُ الاجتماعيُّ.
وتتكوّن هذه الأسرة أو “الخيمة” أو “الكانون” أو “أَلْمْسِّي” (ⴰⵍⵎⵙⵙⵉ) (ج. إيلمسّيتنْ) (ⵉⵍⵎⵙⵙⵉⵜⵏ)، في السّياق الزّيانيّ، من الزّوج والزّوجة وأبنائهما وكلّ من يعيش معهما وعلى نفقتهما، سواء كانوا أقارب أو أجانب (الأجداد، والآباء، والأمّهات، والإخوة، والأعمام، والأحفاد، فضلاً عن الأطفال المتبنّين أو المزدادين من نسائها العازبات، والرّجال المتزوّجين من نسائها مقابل التزامهم بالخدمة لدى رئيسها (إِمْحَارْسْنْ (ⵉⵎⵃⴰⵔⵙⵏ) / إِمْحُورَاسْ (ⵉⵎⵃⵓⵔⴰⵙ)، أو إِمَازَّالْنْ (ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ)، أو إِشْنْكِيطِّييْن (ⵉⵛⵏⴳⵉⵟⵟⵉⵢⵏ)، أو إِمْزَايْدْنْ (ⵉⵎⵣⴰⵢⴷⵏ)، أو إِحْرْضَانّْ (ⵉⵃⵕⴹⴰⵏⵏ) (18).
وإذا كان العرف الزّيانيّ يشترط في رئيس الأسرة أن يكون رجلاً يؤهّله لذلك سنّه ووضعيّته المادّيّة والاعتبار الّذي يحظى به لدى الرّأي العامّ؛ فإنّ رئيس الخيمة أو قائدها، مبدئيّاً، هو من يقوم بتوفير حاجياتها بعمله أو ثروته. لأنّ السّنّ أو الجنس لا يخوّلان للفرد السّلطة بالضّرورة؛ فقد تسيّر امرأةٌ شؤونها متى توفّي الزّوج، وترك أطفالاً قاصرين لا يسمح لهم صغر سنّهم بتعويضه (19). حيث تصرّح لأعضاء العائلة بنيّتها في البقاء بخيمة أبنائها لتربيتهم. وفي حالة رفض منها ذلك، تطلب تدخّل “جماعت”، الّتي تثبت لها الأمر، ما عدا إذا رأت أنّها عاجزةٌ أو غيرُ جديرةٍ بذلك. لكنّها تبقى، في كلّ الأحوال، تحت رقابة وإشراف العائلة عند الشّطط أو العجز. كما قد يتنازل الأب العجوز من تلقاء نفسه عن قيادة الخيمة لفائدة ابنه، ويفوّض له كلّ الصّلاحيّات دون الحاجة إلى أي طقسٍ احتفاليّ (20).
- اَلْقَبِيلَةُ:
تعود “القبيلة” في مضمونها الأنثروبولوجيّ إلى مصطلح المؤسّسات السّياسيّة في الحضارة الهند أوروبيّة القديمة، حيث تمثّل الشّكل الاجتماعيّ والسّياسيّ السّائد قبل ظهور المدينة والدّولة، وهو أنموذجٌ مرّت به كلّ المجتمعات البشريّة، ويمكّنها من محتوىً سياسيٍّ ووظيفيٍّ فاعلٍ، ويمنحها أدواراً تعبويّةً واستقطابيّةً. كما تعتبر من أشكال التّجمّعات البدائيّة الّتي تبلورت في عصر ما قبل التّاريخ، لذا خلعت الدّراسات الحديثة صفة البدائيّة من تلك التّجمّعات الّتي تبلورت في هذا العصر، لا سيّما عند دراستها للمجتمعات البشريّة في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبيّة؛ حيثُ يعتقد إميل بنفينيست (Emile beneveniste) (1969) أنّ القبيلة استُعيرَتْ من قاموس المؤسّسات القديمة للدّلالة على الانتساب إلى جماعةٍ بالولادة (21)، إلّا أنّ استخدامها بالمعنى الأنثروبولوجيّ بدأ مع بداية القرن التّاسع عشر محيلاً إلى التّنظيم السّياسيّ لمجتمعاتٍ موجودةٍ في حقبةٍ معيّنةٍ (بربريّةٍ) من تطوّر البشريّة (لويس هنري مورغن، (MORGAN (Lewis Henry) (1877م)، وبقيت مقترنةً بالمقاربة الوظيفيّة للمجتمعات الفاقدة للدّولة، والّتي تسمّى بشكلٍ عامٍّ “مجتمعاتٍ قبليّةً” (21)، حتّى أضحت تدلّ على مجتمعاتٍ شديدة التّنوّع من حيث طريقتُها في الحفاظ على النّظام الاجتماعيّ دون وجود سلطةٍ مركزيّةٍ (EVANS-RITCHARD, 1942) (22).
وقد قام إيزاك شابيرا (SCHAPERA ISAAC) (1956م) (23) وماكس غلوكمان (GLUCKMAN Max) (1965م)، في هذا الصّدد، بإظهار مدى استطاعة القدرات القبليّة على التّوفيق بين المؤسّسات السّياسيّة والتّشريعيّة، فساهما في انبثاق مفهوم “القبليّة” الّذي صار يدلّ، بصورةٍ تعميميّةٍ متزايدةٍ، على التّصرّفات الجماعيّة السّائدة في المجتمعات الّتي تكبح قيام الدّولة الحديثة (24). كما جعل منها كلّ من جان سرفيي (Servier Jean) (1962) ومارشال دافيد ساهلنز (SAHLINS (Marshall David)) (1968م) إحدى الحقب العامّة من تطوّر البشريّة، والّتي انطلقت من “ثورة العصر الحجريّ الحديث” لتكون مرحلةً بين الزُّمرة والدّولة (25). إذ منذ ظهور البشريّة على وجه الأرض، ظهرت معها الحاجات الفطريّة كالطّعام والشّراب والسّكن والأمن، ومن ثمّ احتاجت إلى التّعاون والتّجمّع والتّحالف بين العديد من الأسر لتحقيق المصالح ودرء المخاطر، ولذلك ظهرت القبيلةُ. ومع مرور الزّمن، بدأت تتجلّى مفاهيم القيادة والسّلطة والغلبة، وانتقل طموح إنسانها من التّفكير في الوجود إلى التّفكير في السّيطرة، ممّا تسبّب في صراعاتٍ وتحالفاتٍ جديدةٍ، لتترسّخ ويقوى نفوذُها ويتّسعُ تأثيرُها (26).
وفي جانبٍ آخر، عرّفها جان بيشلر (Baechler (J.)) بأنّها: “شكلٌ انقساميٌّ للتّنظيم الاجتماعيّ يتكوّن من أقسامٍ قاعديّةٍ، يمثّل كلٌّ منها أسرةً ممتدّةً في عمق ثلاثة أو أربعة أجيالٍ، وكلّ قسمٍ قاعديٍّ يلتحم تلقائيّاً مع قسمٍ آخر، كلّما شعر بتهديدٍ أو خطرٍ. وشيئاً فشيئاً يمكن أن تتّحد القبيلة بأسرها، أو مجموعة قبائل، في مجموعةٍ مؤقّتةٍ لمواجهة عدوٍّ خارجيٍّ” (27). ويقترب هذا التّصور من رؤية ابن خلدون؛ حيث يرى أنّ التّجمّع القبليّ في أماكن معيّنةٍ إنّما هو أمرٌ فرضته الحاجة إلى الاستمرار في الحياة؛ إذ جاء من أجل التّعاون لتحصيل القوت والضّروريّات من أجل البقاء، كما أنّ اعتماد أفرادها على الحيوانات ومنتجاتها هو الّذي أسكنهم البراري والقفار، كما وحّدت بينهم ظروف الحياة القاسية، ودعت إلى نشأة علاقاتٍ وثيقةٍ بين بعضهم بعضاً، لدفع الخطر الذّي قد يتعرّضون له وصدّ المعتدي، أو شنّ غاراتٍ على مناطق أخرى لتأمين سبل العيش وتوفيره (28).
وتجاوز عبد اللّه العروي، في سياقٍ آخر، الفكرتين الشّائعتين عن القبيلة المغربيّة: الأولى مفادها أنّ للقبائل المغربيّة الأصول الجينيالوجيّة نفسها، والفكرة الثّانية مفادها أنّ للقبيلة بعدٌ إثنيٌّ يتمثّل في العمق الأمازيغيّ، لأنّ “الحديث عن القبيلة… هو بالضّرورة حديثٌ عن شأنٍ وضع لم يسبق له أن توقّف عن التّطوّر، ثم شرحه بنظريّاتٍ متحوّلةٍ” (29). ولذلك أضحت تشتغل بالنّسبة إليه على ثلاثة محاور كبرى: أوّلاً بوصفها مؤسّسةً مرتبطةً بالفلاحة والملك الجماعيّ خارج مفهوم دولة المخزن، وثانياً تعتمد على عمقها الإثنيّ لتدبير نفسها وإعادة بناء السّيرورة التّطوّريّة الّتي تحكمها، وثالثاً أدمج المحورين في نظريةٍ للقبيلة الأمازيغيّة تقوم على العرف والسّيبة والمخزن. وبالتّالي تجاوزت مساحتَها الاجتماعيّة والاقتصاديّة إلى ما هو سياسيٌّ، وانبرت بوصفها مؤسّسةً محوريّةً في السّيرورة التّاريخيّة للمجتمع المغربي (30).
ونتيجةً لتعدّد معاني القبيلة، وتضارب بعضها أحياناً، يذهب بعض الدّارسين إلى أنّ ظاهرة “القبيلة”، بشكلٍ عامٍّ، تستعصي على التّعريف، بالنّظر إلى اختلاف مورفولوجيّاتها وأحجامها، واختلاف نوعيّة التّماسك بين مكوّناتها (31)، وإن كانت لها ملامحُ عامّةٌ تحدّدها، وسماتٌ تعرفُ بها، مثل:
- توفّر مكوّناتها الرّئيسة: المكان المحدّد، واللّغة الواحدة، والحضارة الواحدة. وإذا غاب أحد هذه العناصر، تفقد شرطاً أساسيّاً من شروط وجودها.
- سيادة مظاهر التّعاون والودّ والتّماسك الاجتماعيّ بين أفرادها، وشعورهم بالانتماء إلى المجتمع الواحد، ومن أبرز سمات هذا التّماسك والشّعور بالانتماء الاشتراكُ في الطّقوس الدّينيّة.
- ضمّها لعدّة تنظيماتٍ شكليّةٍ تعمل على تأكيد وحدتها وتماسكها الاجتماعيّ، ممّا يحافظ على كيانها واستمرار وجودها.
- بساطتها البنيويّةُ، سواء من حيث عدد السّكّان أو كثافتهم أو بالنّسبة لحركة الهجرة الدّاخليّة والخارجيّة، أو عدد المؤسّسات الاجتماعيّة.
- تأليفها لوحدةٍ اجتماعيّةٍ وسياسيّةٍ واقتصاديّةٍ متكاملةٍ تميل إلى أن تكون مجتمعاً مغلقاً على نفسه، ولا يتّصل، ثقافيّاً، اتّصالاً وثيقاً بالخارج، حتّى بالنّسبة للقبائل المجاورة، إلّا في حدودٍ ضيّقة (32).
- رابطة القرابة؛ إذ يمثّل أبناؤها مجموعةً من الأفراد المنتمين إلى أصلٍ مشتركٍ، سواء كان هذا الانتماء حقيقيّاً أو وهميّاً، ولو أنّه لا يمكن إرجاعها إلى صلة القرابة وحدها؛ إذ تضمّ تحت لوائها أولئك المنحدرون من صلبٍ واحدٍ، وهم الصّرحاء، وفيها من لا ينتمي إليها كالدّخلاء ممّن كانوا عبيداً عند القبيلة، والمستلحقين الّذين ألحقوا بها ممّن ليس منها.
- قَبِيلَةُ إِزْيَّانْ (زَيَان):
“إِزيَّان” أو “زَيَان” قبيلةٌ أمازيغيّةٌ تقع في ما يسمّى ب”ممرّ السّلاطين”، وهو موقعٌ استراتيجيٌّ يربط شرق المغرب بغربه، ويمرّ عبر المدن: فاس ومكناس ومرّاكش. و”إِزيَّانْ” (ⵉⵥⵉⵢⵢⴰⵏ) جمعٌ مفرده “أَزَايِّي” (بتفخيم الزّاي) (ⴰⵥⴰⵢⵢⵉ)، الّذي قد يكون مشتقّاًّ من جذر “إِيزي” (بتفخيم الزّاي) (ⵉⵥⵉ)، ويدلّ على المرّارة (La vésicule biliaire)، الّتي ترمزُ، عادةً، عند الأمازيغ إلى الشّجاعة والإقدام؛ إذ عُرف الزّيانيّون بأنّهم شديدو البأس، وأنّهم محاربون مرموقون (33). وقد يكون أيضاً مشتقّاً من الجذر “إِزَّايْ” (ⵉⵥⵥⴰⵢ) (ثقيل) دلالةً على قدرتهم على التّحمّل ومواجهة الصّعاب والأنفة والكبريّاء (34).
وتمتدّ هذه القبيلة جغرافيّاً من جبل تَاغَاط إلى بُوكجْدِي وأَفْلكْتُور شرقاً، حيث توجد قصورها الرّئيسة. ويشكّل المجموع بلاداً متوسّطة الغنى، تنتشر الصّخور بوضوحٍ في أجزائها العليا المكسوّة في الأغلب بغاباتٍ كثيفةٍ من أشجار الأرز، بيد أنّ الأراضي الصّالحة للزّراعة والمرويّة تنتشر ناحية قصور “أَيْتْ شَارْضْ” وأَرُوكُو وجنَان إِيمِس (جْنْ الْمَّاسْ) (ⵊⵏⵏ ⴰⵍⵎⵎⴰⵙ) إلى الشّمال لدى أيت اللّحياني، أحد فروع أيت بومزّوغ. وفي المناطق المنخفضة المجاورة للنّهر، تقع خنيفرة، المدينة الحمراء المكوّنة من منازل ذات سقوفٍ منخفضةٍ تطلّ عليها القلاع القائديّة لموحى أوحمو وأولعايدي وأقربائهما. وعلى بعد 10 كم إلى الأسفل توجد تَامْسْكُورْتْ، وهي إقامةٌ قديمةٌ لعشيرةٍ من أولاد سيدي بنّاصر أُخليت سنة 1914م، وأعيد تعميرها بالتّدريج. وأخيرا السّهول الخصبة لبُوزْقُّور وأَذْخْسَانْ ولهري من جهةٍ، ووادي الفايجة والمرتفعات المشجّرة لبُوعْرْعَار التي تزوّد السّاكنة بالعرعار والمراعي الواسعة والغنيّة، من جهةٍ أخرى (35).
وعموماً، يشكّل موقع “زَيَان” صلة وصلٍ بين شمال المغرب وجنوبه، لأنّه يقع وسط المنحدرات الأطلسيّة للأطلس المتوسّط، وهو منطقة جبليّةٌ تمتدّ من شمال دمنات، عند ثغرة تسّاوت، حيث تختلط منحدراته بمنحدرات الأطلس الكبير، ويحدّها سهل تادلا جنوباً، وتنتهي عند هضبة الظهراء العليا (36). كما أنّه يربط شرق المغرب بغربه، ويحقّق التّواصل بين أيت امكيلد وايت احند وإشقّيرن وايت إسحاق وزمّور وأيت النّظير والسّماعلة (37). وبذلك يكون المجال الزّيانيّ محاطاً بعدّة قبائل من مختلف الوجهات، فمن الشّرق تحدّه أيت امكيلد، وتحدّه من الشّمال أيت النّظير، ومن الغرب زمّور، ومن الجنوب أيت احند وإشقّيرن. ولعلّ ذلك ما جعله ذا قيمةٍ استراتيجيّةٍ مهمّةٍ في مخطّط الاحتلال الفرنسي (38).
وتجمع المصادر التّاريخيّة على أنّ “زيان” تنتمي إلى اتّحاديّة أيت أومالو (39)، إلّا أنّ ذلك كان محطّ تساؤلٍ ونقاشٍ مستفيضين، الأمر الّذي دفع سابقاً جعفر النّاصري إلى استفسار أحمد المنصوري (39) عن أصلها، وأفاد بأنّ “زيَان” هو اسم أب القبيلة الشّهيرة، الّتي عاصمتها خنيفرة، من جدّهم بُرنُس، الّذي يقال لأحد شعوبه أيت أومالو (40). ويرفع المؤرّخ أبو القاسم الزّيانيّ نسبه، ويقول: «أنا أبو القاسم بن أحمد بن علي، بن إبراهيم، بن نوح النّسّابة، بن إبراهيم، بن علي، بن الحسن، بن قاسم، بن يحيى، بن عيسى، ويحيى هذا هو أبو فخذنا، من قبيلة زيان بن نوحٍ بن فاضلٍ، بن علي، بن زيان، بن مالو (41)… بن اليسع… بن صنهاج، جد قبائل صنهاجة كلّها” (42). ويقول صاحب الاستقصا، مورداً “زَيَان” تحت اسم “ضَيَان”: «أيت أمالو من برابرة فزاز، وهم بطنٌ من صنهاجة يشتمل على أفخاذٍ كثيرةٍ، مثل ضيان وبني مكيلد… قد عمروا جبال فزاز، وملأوا قننها، وتحصّنوا بأوعارها منذ تملّك البربر المغرب قبل الإسلام بأعصارٍ طويلةٍ” (43).
وحسب أبي القاسم الزّيانيّ، اعتنقت القبيلة الإسلام أيّام الخليفة الأمويّ عبد الملك بن مروان، وهي آنذاك بفزان من أرض الصّحراء قبل أن تدخل سجلماسة (44). وأشار في السّياق ذاته إلى أن زيان فريقٌ من برابر فزاز، وبطنٌ من صنهاجة، والظّنّ أنّهم جاءوا من الصّحراء بعد شقّ قبيلة زعير العربيّة المعقليّة الطّريق من الصّحراء إلى حيث مقرّهم الحالي (45). ويستفاد من هذه الرّواية، أنّ زيان ينتمون لصنهاجة الجنوب، الّذين كانوا يجوبون الصّحراء قبل القرن الحادي عشر الميلاديّ بين واحات جنوب المغرب وبين بلاد الزّنوج (46). ويميّز البيذق، في هذا السّياق، بين نوعين من صنهاجة؛ صنهاجة القبلة، أي صنهاجة السّاكنة خلف جبال الأطلس والمتعرّضة بسبب ذلك للشّمس، وهم فرع الرّحّل، ولهم من الأفخاذ إحدى وأربعين على حساب درجاتهم في التّمييز، ويقابلها صنهاجة الظّلّ، وهم السّاكنون في الجبل المحتمون من وهج الشّمس ولفح الحر (47). ويضيف بأنّ أصل صنهاجة بالصّاد المشمّ زاياً والكاف القريب من الجيم (زناك)، ولمّا عرّبه العرب زادوا الهاء بين النّون والألف، فصار صنهاج، ثم ألحقوا بآخره هاء الجمع، فصار صنهاجة (زناكة) (48).
غير أنّ عبد الوهّاب بن منصور، في إطار إشكاليّة تقسيم الأمازيغ والبحث عن أصولهم، يقول إنّ المؤرّخين والنّسّابين بحثوا طويلاً في أرومات البربر، وتحدّثوا كثيراً عن أنسابهم، ولكنّهم لم يتّفقوا على رأيٍ واحدٍ، ولم يصلوا إلى نتيجةٍ مقنعةٍ، فقد ذهبوا في أصل البربر كلّ مذهبٍ، ولم يتركوا سلالةً من السّلالات الحاميّة والسّاميّة واليافتيّة إلّا وجعلوهم متنسلين منها، ولا يمكن لأيّ باحثٍ أن يطمئنّ إلى رأيٍ أو يثق بقولٍ؛ إذ جميع الرّوايات والنّقول يكتنفها القلق والاضطراب، وتقبل النّقض والاعتراض (49).
ورغم تضارب الآراء والرّوايات حول هذا التقسيم (البرنس والبتر)، تجمع المصادر والمراجع التّاريخيّة على أنّ زيان من صنهاجة ينتمون لقبائل أيت أومالو، هاجروا إلى مناطقهم الحالية في إطار الهجرات الكبرى لقبائل الجنوب الشّرقيّ في اتجاه الشّمال الغربيّ، إلّا أنّ المثير للانتباه هو سكوتُ مصادر العصر الوسيط عن المواطن الأصليّة لهذه القبائل، فلم تقدّم إضافاتٍ مهمّةً بهذا الشّأن؛ ذلك أنّ الجغرافيّين كالبكريّ والإدريسيّ، والإخباريّين كابن أبي زرعٍ، وحتّى المؤرّخين كابن خلدون لم يذكروا “زَيَان” في كتاباتهم إلّا بعد القرن الثّاني عشر الميلاديّ، ليس في مواطنهم الأصليّة، الصّحراء، ولكن في مقرّهم الحالي (50).
وبناءً عليه، إذا كان الزّيانيّون ينتمون إلى صنهاجة الصّحراء، فإنّهم جاءوا من الجنوب المغربيّ؛ إذ كانت الهجرة، لعوامل طبيعيّةٍ وسياسيّةٍ، ظاهرةً معروفةً في تاريخ المغرب، ولا تتمّ على مستوى الأفراد فحسب، وإنّما حتّى على مستوى القبائل والجماعات. حيثُ عملت الدّولة المرابطيّة على تشجيع هجرة قبائل صنهاجة من الجنوب إلى الشّمال من أجل توطيد حكمها (51)، بيد أنّ قبائل معقليّةً، لاسيّما زعير وبني احسن، هي الّتي فتحت الباب على مصراعيه منذ القرن 16م، لتستمرّ هذه الهجرات إلى حدود القرن الثّامن عشر الميلاديّ، فكانت كلّ قبيلةٍ حديثة العهد بالهجرة تزيح القبيلة أو القبائل الّتي هاجرت قبلها، فأزاح الزّيانيّون -المهاجرون الجدد- زعير من مواطنهم (بلاد زيان حالياً)، ودفعوا بهم في اتّجاه الغرب (52)؛ إذ قبل وصول الزّيانيّين إلى مقرّهم الحالي (خنيفرة)، تفيد بعض الدّراسات (53) أنّ زعير، وهم عربٌ رحّلٌ معقليّون، لضعف دولة المرينيّين، وقساوة الظّروف الطّبيعيّة، أتوا من الصّحراء في إطار هجرةٍ جماعيّةٍ إلى الشّمال بحثاً عن المراعي الجبليّة، وانتشروا بسرعةٍ في ملويّة (54)، ووصلوا إلى منطقة خنيفرة (هضبة أدخسان) ابتداءً من القرن السّادس عشر الميلاديّ، وانتشروا من تِيكْرِيكْرَا (Tigrigra) إلى حدود مولاي بوعزة. بينما تقدّم “بني احسن” في اتّجاه الشّمال عبر كيكو، وانتشروا في أحواز صفرو (55).
لقد كانت الهجرة، إذن، ظلّت ظاهرةً ملازمةً لقبائل المغرب؛ حيث كانت كلّ قبيلةٍ تحتلّ مجالاً جغرافيّاً تدافع عنه عند كلّ خطرٍ، وتسعى لتوسيعه وقت الشّدّة، أو لتغييره بمجالٍ أفضل. وهكذا لم يقتصر الزّيانيّون على إزاحة زعير في اتّجاه الغرب، بل أزاحوا حتّى إخوانهم (أيت عمر). إذ أورد التّقيّ العلويّ أنهم (أيت عمر) إحدى الفرق الزّيانيّة القاطنة بنجد ولماس، كانت تسكن مريرت والتّاندرا وبالجبال المشرفة عليهما ناحية منابع أمّ الرّبيع، ولكن الحروب الأهليّة وحركة الضّغط الجماعيّ الآتية من الخلف، الّتي كانت تقوم بها قبائل أخرى دفعت بها إلى الأمام، فوجّهت ضغطها على العناصر الموجودة في طليعة الزّحف المستمرّ، مثل زمّور وبني حكم الّذين كانوا يسكنون بهذا النّجد (56).
نخلص من حديث الطّرد والنّزوح إلى أنّ الزّيانيّين انتشروا في الأطلس المتوسّط بعد أن أزاحوا زعير وأيت عمر. ورغم قلّة المعلومات وشحّ الشّهادات التّاريخيّة عن استقرارهم بالجنوب المغربيّ، يعتقد محمّد بن لحسن (57) وجورج كولان (Georges colin) (58) أنّ الزّيانيين بدأوا زحفهم في اتّجاه مواقعهم الحالية منذ بداية القرن السّادس عشر الميلاديّ، واستمرّ زحفهم جماعاتٍ وأسراً وأفراداً طيلة ثلاثة قرونٍ إلى أن استقرّت الأوضاعُ خلال القرن التّاسع عشر الميلاديّ.
- “إيضْ نْ نَّايْرْ”: بَحْثٌ فِي التَّسْمِيَةِ والأُصُولِ الطَّبِيعِيَّةِ وَالتَّارِيخِيّةِ وَالْمِيثِيَّةِ وَالطُّقُوسِ الاِحْتِفَالِيَّةِ
سنحاول فيما يلي الوقوف على أهمّ الحيثيّات والجوانب التّاريخيّة والميثولوجيّة والطّبيعيّة المرتبطة بهذه المناسبة، إضافةً إلى بعض مظاهر طقوسها الاحتفاليّة:
2-1- “إيضْ نْ نَّايْرْ”: أنماط التّسمية وأهمّية الاحتفال بالمناسبة
“إِيضْ نْ نَّايْرْ” طقسٌ فلاحيٌّ أمازيغيٌّ قديمٌ يرجع صداه إلى عهودٍ غابرةٍ، يرمز إلى التّيمّن بالخصب ووفرة الزّرع، تؤدّي فيه الأسر شعائر مخصوصةً من خلال شعائر عائليّةٍ مخصوصةٍ تفاؤلاً بسنةٍ فلاحيّةٍ جيّدةٍ، وتذكيراً بأيّامٍ تاريخيّةٍ مهمّةٍ من مسار ارتباطها الطّويل بالأرض. وله مسمّيات أخرى كثيرةٌ حسب المناطق والمجالات الأمازيغيّة، لعلّ أبرزها: “رأس السّنة الأمازيغيّة أو الفلاحيّة” (59)، “ليلة ينّاير”، و”يَنَايِرَة”، و”حَاكُوز / حَاكُوزَة / تَاحَاكُوزْتْ”، و”ليلة السّنة” أو “إِيضْ نْ وسْكَّاسْ”، و”تَالْقِّيمْتْ / تَالْقِّينْتْ” أو اللّقمة، و”يوم النّصر”، و”نَّايْرْ”، و”اليَنْيِيرْ”، و”عيد يناير”، و”الينّيرْ”، و”يناير السّنة” أو “ينّايْرْ وْسْكَّاسْ”، و”تَاكّورْتْ ن وْسْكَّاسْ” أو “تابّورْتْ نْ وْسْكَّاسْ”، و”رأس السّنة” أو “إِيخْفْ وْسْكَّاسْ”، و”أَسْقَّاسْ امْقَّاسْ”… كلّ هذه المسمّيات تحيل إلى مسمّى واحدٍ هو بداية السّنة الأمازيغيّة (ليلة اليوم الأوّل من يناير) (60) ، الّتي تفصلها 12/13 يوماً عن السّنة الميلاديّة حسب التّقويم الغريغوريّ، والّتي صنّفتها منظمّة الأمم المتّحدة للتّربية والعلم والثّقافة (اليونيسكو) تراثاً لا مادّيّاً مغاربيّاً سنة 2020.
وتبدو أهمّية الاحتفال بهذه المناسبة في ترسيخ الوعي بالذّات والاعتزاز بالخصوصيّة الثّقافيّة وإعادة الاعتبار لكلّ ما يعزّز هويّتها، ويمحو عنها غبار النّسيان، حتّى تبدو ظاهرةً للعيان. كما أنّها تعبّر بجلاءٍ عن وحدة التّجربة الإنسانيّة والتّكوين النّفسيّ للشّخصيّة المغربيّة، وتعكس العمقَ التّاريخيَّ والأصالةَ الحضاريّةَ لبلادنا وغناها. ولذلك استهدفنا من خلال هذه الدّراسة التّغلغل في قلب الثّقافة الشّعبيّة الأمازيغيّة المغربيّة الزّيانيّة ودراسة بعض أشكالها الاحتفاليّة الخاصّة بهذه المناسبة، والتّي ما تنفكّ تطرح أسئلةً كثيرةً.
2-2- “إيضْ نْ نَّايْرْ”: بعض الأصول الطّبيعيّة والتّاريخيّة والميثولوجيّة
يفترضُ فهمُ وتفكيكُ أيّ فعلٍ طقوسيٍّ شرطَ العودة إلى سنده التّاريخيّ أو السّوسيومجاليّ أو الميثولوجيّ أو حكاياته المؤسّسة الّتي عملت على انوجاده وتكراره واستمراره، بما هي قواعدُ أساسيّةٌ في المتن الشّعائريّ، وما دام تطقيس الشّيء معناه جعله سلوكاً تكرارياًّ وممارسةً اعتياديّةً، يتّفق عليها أفراد المجتمع الواحد. ويحدّدون الطّرائق والغايات، ويبرّرون لها الدّوافع والمآلات (61)، فإنّ الطّقس ليس خارج السّياق الّذي ينتجه ويسري فيه، وغير منفصلٍ عن مرجعيّةٍ قبليّةٍ تحدّد اعتياديّته وتكراريّته. فما الدّواعي المجتمعيّة والتّاريخيّة نحو انوجاد هذه احتفاليّة “إِيضْ نْ نَّايْرْ”؟ وما الحكاية أو الخبر التّاريخيّ أو الميثولوجيا المؤسّسة لاحتفال الزّيانيّين والأمازيغيّين عموماً بهذه المناسبة؟
إنّ في أصول الاحتفال بهذه المناسبة خمس رواياتٍ مختلفةٍ ومتكاملةٍ؛ تربط الأولى الحدث ببعدٍ فلاحيٍّ زراعيٍّ؛ حيث يرمز في هذا المجال إلى احتفالات الفلّاحين بالأرض والزّراعة، ومنه تسمية “السّنة الفلاحيّة”، بينما ترجعه الثّانية إلى بعدٍ تاريخيٍّ محضٍ، فتربطه أوّلاً (الرّواية التّاريخيّة الأولى) بانتصار القائد الأمازيغيّ “شِيشْنَق” (شِيشُونْغ) على أحد فراعنة مصر القديمة في معركةٍ دارت رحاها على ضفاف نهر النّيل سنة 950 قبل الميلاد، وثانياً (الرّواية التّاريخيّة الثّانية) إلى الوجود الرّومانيّ في شمال إفريقيا وتأثيره ثقافيّاً وسياسيّاً واجتماعيّاً على شعوب المنطقة، وثالثاً بالتّقويم القبطيّ السّكندريّ. في حين تعلّقه الرّواية الرّابعة، وهي امتدادٌ للرّواية الأولى، بالبعد الأسطوريّ المتمثّل في “أسطورة العجوز” أو “أَرْطَّالْ نْ تْمْغَارْتْ” / “سلف العجوز”.
ولتفكيك مضامين هذه الرّوايات، علينا السّفر إلى لحظة البدء الأوّل لهذا الاحتفال، أو ما يطلق عليه في الأنثروبولوجيّة الدّينيّة “لحظة التّكوين”؛ ومن ثمّة سنعتمد بعض الجوانب الميثولوجيّة من جهةٍ، وعلى المعطيات التّاريخيّة والجغرافيّة من جهةٍ أخرى، لاستكشاف لحظة الولادة وتطوّرها عبر الأزمنة والعصور، لا سيّما أنّ الطّقوس القديمة تفقد مع مرور الزّمن معناها وغاياتها، فتتحوّل إلى مجرّد شعائر لا معنى لها، ولذلك تعمل الأسطورة على توضيح أصل الطّقس ومعناه، وتقدّم تبريراً مقنعاً للاحتفالات الّتي تتناقلها الأجيال، وبالتّالي تترابط الأسطورة والطّقس بشكلٍ وثيقٍ، فلا بقاء لأحدهما دون الآخر، فالأسطورة بحاجةٍ إلى الطّقس لضمان خلودها، والطّقس بحاجةٍ للأسطورة لتبرير وجوده والحفاظ على فعاليّته (62). والحالُ أنّ الفعاليّات الطّقوسيّة والدّيناميّات الشّعائريّة المختلفة ل”إيضْ نْ نَّايْرْ” تستند، فضلاً عن الأبعاد الميثيّة، إلى مضامين كثيرةٍ، تاريخيّةٍ وطبيعيّةٍ واجتماعيّةٍ واقتصاديّةٍ…
2-2-1- “إيضْ نْ نَّايْرْ”: الأصْلُ الفِلَاحِيُّ / الزِّرَاعيُّ
تذهب هذه الرّواية إلى أنّ “إيضْ نْ نَّايْرْ” زمنٌ مخصّصٌ للاحتفال بالأرض والفلاحة عموماً، ومناسبةٌ لمباركة الموسم الفلاحيّ الجديد والتّفاؤل بسنةٍ كلّها خيرٌ وغلّةٌ وفيرةٌ على الفلّاحين والنّاس أجمعين، ووقتٌ لضبط عمليّات السّقي والغرس؛ خاصّةً أنّه يأتي نهاية موسم الحرث ومنتصف موسم المطر، ويتزامن مع منتصف (اللّيالي الكبيرة) “اللّيالي تِيخَاتَارِينْ”، الّتي تبدأ يوم 25 دجنبر من كلّ سنةٍ، وتدوم 40 يوماً، ويوافق تقريباً أطول اللّيالي في السّنة، واليوم الّذي يفصل بين فترتين مختلفتين جويّاً من السّنة؛ حيث يتمّ الانتقال من فصلٍ باردٍ ومتقلّبٍ إلى فصلٍ معتدلٍ مستقرٍّ نسبيّاً، ممّا يعدّ إيذاناً ببدء زراعة الأرض والاستعداد لموسمٍ قادمٍ، فيشحذ الفلّاحون هممهم لإنجاح موسمهم الجديد. ولذلك يُحْيُونَ هذه المناسبة أملاً في أن تكون الطّبيعة سخيّةً معهم، فيطردون شبح الجوع والسّنين العجاف، خاصّةً أنّها تصادف نهاية مخزون المؤونة الّتي يحتفظون بها تحسّباً لفصل الشّتاء.
2-2-2- “إيضْ نْ نَّايْرْ”: الأصلُ التّاريخيُّ
للاحتفال بهذه المناسبة، كما سلف، ثلاث رواياتٍ تاريخيّةٍ (تعدّ الأولى الأكثرَ انتشاراً وتداولاً):
- الأصلُ التّاريخيُّ الأوّل: انتصار الزّعيم الأمازيغيّ “شِيشْنَق” على حاكم مصر القديمة سنة 950 ق.م
من المتداول تاريخيّاً أنّ شِيشْنَق الأوّل (أو شِيشُونْغ أو شيشْناق أو شيُوشُونْق، أو شيُوشنْغ، أو شِيشَق…) هو القائد الأمازيغيّ الّذي قهر الفراعنة، وحكمت أسرته مصر القديمة لمدّة قرنين، ووصل إلى أورشليم (القدس حالياً)، منتصراً فيها على العبرانيّين. غير أنّ أغلب الرّوايات تختلف اختلافاً كبيراً في أصله وكيفيّة وصوله لحكم بلد الأهرامات؛ فتذهب بعضها إلى أنّه من بني سويس، وأنّه صدّ هجوماً قام به الفراعنة للسّيطرة على بلاد الأمازيغ قرب مدينة تلمسان غرب الجزائر، وهزمهم شرّ هزيمةٍ، وطاردهم شرقاً حتّى استولى على بلادهم، ونصّب نفسه فرعوناً لمصر وما جاورها، ليتمّ الاحتفال بهذا النّصر العظيم. ومن ثمّ جاء اختيارُ هذه المناسبة بدايةً للتّقويم الأمازيغيّ تقديراً لهذا الحدث وإجلالًا لهذا القائد الفذّ. في حين تذهب روايةٌ ثانيةٌ إلى أنّه ينحدر من قبيلةٍ أمازيغيّةٍ ليبيّةٍ؛ حيث اشتهر بعدله وتسامحه لدرجة أنّ المصريّين لجأوا إليه ليخلّصهم من ظلم الفرعون، وقاموا بتنصيبه ملكاً عليهم. فيما تذهب روايةٌ ثالثةٌ إلى أنّه قائدٌ عسكريٌّ في جيش الفرعون، سمحت له ظروف الفوضى والاضطرابات الّتي عانت منها مصر القديمة أن يسيطر على البلاد، وينصّب نفسه حاكماً عليها. وتقول روايةٌ رابعةٌ إنّه ينحدر من قبيلة “المشاوش” اللّيبيّة الأمازيغيّة، وترعرع في بلاط الفرعون إلى أن صار كاهناً، واستطاع بحكمته أن يحشد له أتباعاً كثراً ساعدوه في الوصول إلى سدّة الحكم. وتعتقد روايةٌ خامسةٌ أنّه قائدٌ ليبيٌّ من “المشاوش” أيضاً قاد جيشاً عظيماً خلال حربه على الفراعنة، الجيران الشّرقيّين، وانتصر عليهم انتصاراً كبيراً سنة 950 ق. م، فأقام وليمةً على شرف قادته العسكريّين احتفالًا بهذا الحدث العظيم، الّذي أصبح احتفالاً سنويّاً في مختلف المناطق الأمازيغيّة (63).
غير أنّ من الباحثين من يرون أنّ هذه الرّواية تجانب الحقيقة التّاريخيّة على غرار الباحث الحسين أيت باحسين، لكون رمسيس الثّاني (الفرعون الّذي انهزم في المعركة الشّهيرة) توفّي سنة 1213 ق. م، بينما اعتلى شِيشَنق الأوّل عرش مصر القديمة سنة 950 ق.م، مورداً مصادر كثيرةً تقدّم معلوماتٍ دقيقةً حول هذا الموضوع (64). بينما يستشهد من ينتصر لصدقيّة هذا الحدث بذكر اسم هذا الملك الأمازيغيّ في الكتاب المقدّس (العهد القديم) في ملوك أول 28-14/25، باسم “شِيشَق”، وفي أخبار اليوم الثّاني، الإصحاح 12، الفقرات 01-12: “لمّا تثبّتت مملكةُ رَحُبْعَامَ وتشدّدت، ترك شريعة الرّبّ هو وكلّ إسرائيل معه. وفي السّنة الخامسة للملك رَحُبْعَامَ، صعد شيشق ملك مصر على أورشليم، لأنّهم خانوا الرّب…”. وحتّى في سفر ملوك أوّل إصحاح 11، الآية 40: “وطلب النّبيّ سليمان قتل يربعامَ، وهرب إلى مصر حيث بقي هناك إلى أن مات…” (65).
وقد تعرّف العالم على هذا الزّعيم الأمازيغيّ، الّذي يوجد مجسّمه في متحف بروكلين بالولايات المتّحدة الأمريكيّة، من خلال الباحث الأركيولوجييّ جان بيير ماري مونتي (Jean Marie Montet)، الّذي اكتشف مقبرته سنة 1940م. وتجدر الإشارة إلى أنّ كلٌّ من ليبيا والجزائر ومصر تنازعت حول هويّته وأصوله؛ حيث رفضت ليبيا ومصر في يناير 2021م نصب الجزائر تمثالٍ له في مدينة “تيزي وزّو” (66).
- الأَصْلُ التَّارِيخِيُّ الثَّانِي المُرْتَبِطُ بالْاحْتِلَالِ الرُّومَانِيِّ
يعتمد أصحاب هذه الرّواية على كون أسماء شهور التّقويم الأمازيغيّ مشتقّةً من اللّاتينيّة، ويردّون على أنّ “يناير” الّذي يعتبره الأمازيغيّون شهرهم الأوّل (“يَانْ”: واحد، و”أَيُورْ”: الشّهر، أي الشّهر الأوّل) هو في الحقيقة يانواريوس (IANVARIVS) إله البدايات عند الرّومان (67)، والاحتفال به هو استمرارٌ للاحتفال بأعياد ميلاد المسيح، فضلاً عن كون طول السّنة وعدد أيّام الشّهور هما نفسهما عند الرّومان في التّقويم اليوليانيّ (ثلاث سنواتٍ من 365 يوماً تليها سنةٌ كبيسةٌ من 366 يوماً)، مع بعض الاختلاف البسيط في شهر فبراير (فورار).
ومن الباحثين الّذين ينتصرون لهذه الرّواية محمد البشير بن عبد الله الفاسي ومحمّد العلمي محمّد عبّاسة… يقول الأوّل أثناء الحديث عن عادات بني زروال: “نعم توجد بها بعض عوائد لا مستند لها في الإسلام، ولكنّها قليلةٌ، ولعلّها من آثار المسيحيّة الّتي كانت منتشرةً في جبال غمارة زمن الفتح الإسلاميّ من ذلك الاحتفال برأس السّنة الشّمسيّة (الحكوز)، وهو المعروف عند الفرس بالنّيروز، فإنّهم يحتفلون به احتفالاً خاصّاً، يعدّون فيه الموائد ويعقدون الاجتماعات المتداولة فيما بينهم ومبادلة التّهاني. ومن المأكولات المخصّصة عندهم لذلك اليوم السّفنج محشوٌّ بحوت السّردين” (68). ويجعل الثّاني “حاكوزة” ضمن الأعياد الفلاحيّة، ويسمّيها “يَنَايِرَة”، ويردّها إلى أصلٍ رومانيٍّ: “هناك أيضاً احتفالٌ فلاحيٌّ يسمّى النّايرة، ويقام في يوم الثّالث عشر من شهر (يناير)، وهو من أصلٍ رومانيٍّ عتيقٍ. ويعتبر هذا العيد في المغرب فلاحيّاً وخاصّاً بالأطفال في نفس الوقت” (69). ويرتبط “ينّاير، حسب الثّالث، بالمجتمع الرّيفيّ، وهو ليس عنده بداية السّنة الفلاحيّة الّتي تبدأ عند اعتدال فصل الخريف، كما هو معروفٌ في النّيروز عند الأقباط والمهرجان عند الفرس، وإنّما هو الاحتفال برأس السّنة الميلاديّة، كما هو الحال عند المسيحيّين، غير أنّ المغاربة جعلوا منه احتفالاً بمحصول الخريف من مكسّراتٍ وتمرِ وفواكه مجفّفةٍ، وذلك حتّى يخالفوا النّصارى (70). في حين يؤكّد سعيد إفقيرن ومعه باحثون آخرين أنّها طقوسٌ ذات امتداداتٍ عريقةٍ، أكثر قدماً من الإسلام ومن روما وقرطاجة (71).
- الأَصْلُ التَّارِيخِيُّ الثَّالِثُ المُرْتَبِطُ بِالتَّقْوِيمِ الْقِبْطِيِّ السَّكَنْدَرِيِّ
يعتقد جان سيرفيي (Jean Servier)، في هذا الصّدد، أنّ التّقويم الأمازيغيّ ليس مشتقّاً من التّقويم اليوليانيّ، وإنّما من التّقويم القبطيّ المشتقّ من التّقويم المصريّ القديم (72).
والتّقويم القبطي (73) هو رزنامةٌ زمنيّةٌ يستخدمها الأقباط الأرثوذكس والمزارعون المصريّون، ويعتبر من أقدم التّقاويم الزّمنيّة في العالم. وقد ظهر هذا التّقويم بعد التّغييرات الّتي أدخلها بطليموس الثالث سنة 238 ق. م على التّقويم المصريّ القديم، ليعاد تطبيقه بشكلٍ كاملٍ سنة 25 ق. م على يد الإمبراطور أغسطس، ويصبح متزامناً مع التقويم اليولياني (74). وتبدو هذه الرّواية مستبعدةً، بالنّظر إلى حداثتها بالنسبة للرّواية الأولى. وقد يكون الارتباط بالأنشطة الزّراعيّة والفلاحيّة أساساً في التّقويم سبب الالتباس.
2-2-3- اَلْأَصْلُ الأُسْطُورِيُّ لِ”إيضْ نْ نَّايْرْ” (أسطورة العجوز أو سلف العجوز أو يوم العجوز)
يرتبط تاريخ السّنة الأمازيغيّة في المخيال الشّعبيّ الأمازيغيّ بأسطورة “العجوز” (أو سلف العجوز أو يوم العجوز)؛ إذ استهانت عجوزٌ بقوى الطّبيعة واغترّت بنفسها، ونسبت صمودها ضدّ الشّتاء القاسي إلى قوّتها، ولم تشكر السّماء، وشتمت “ينّاير” قائلةً: “لقد مرّت أيّامك كأنّها ربيعٌ، وها أنت ستغادر ليحلّ فورار (فبراير)، الّذي لن يصيبني فيه البرد، ولن تعرقلني فيه الثّلوج”، أو “ذَهَبَ ينّاير ذو المخاطات الجارية” (75)؛ فغضب كثيراً، وطلب من شهر فبراير (فورار) إعارته يوماً أو يوماً وليلةً كي ينتقم من هذه العجوز المغرورة، فلبّى رغبته، وتنازل له عنه/عنهما من عمره. وخرجت العجوز إلى الحقل ومعها قطيعها، وهي مطمئنّةٌ بأنّ “ينّاير” قد رحل ولن يعود قريباً، ليستدعي هذا الأخير البرد والثّلوج والرّياح القويّة، فهلكت هي وقطيعها (76). وانطلاقاً من هذه الأسطورة، أصبح شهر فبراير أقصر أشهر السّنة. وما يزال الكثير من الفلّاحين في المجالات الرّعويّة الجبليّة الأمازيغيّة يخشون هذا اليوم، ولا يقدرون فيه على الخروج للرّعي (77).
وبغضّ النّظر عن صحّة الأخبار الّتي جاءت بها هذه الرّوايات جميعها، تبقى طقوس الاحتفال ب”إيضْ نْ نَّايْرْ”، من منظور الأنثروبولوجيا، نوعاً من الطّقوس الدّوريّة الكبرى الّتي ترتبط بأساطير التّكوين، فالطّقس هو الأسطورة أو الحدث التّاريخيّ القديم، وقد تحوّل (ت) إلى سلوكٍ يستعيد الزّمن الميثولوجيّ أو الزّمن الأوّل، حسب تعبير الباحث السّوريّ فراس السّوّاح. حيث إن الأحداث التّاريخيّة الّتي وقعت ب”تَامَازْغَا” في الزّمن الغابر، تخبر بكيفيّة تشكّل الأمازيغ، وبناء هويّتهم المتميّزة، في مقابل الآخر، وهو هنا الفراعنة، وانتصروا عليه، وأثبتوا تفوّقهم، وضمنوا تميّزهم. وهذا الزّمن الأوّل تتمّ استعادته وعيشه من خلال الطّقس الدّوريّ، لأنّ الزّمن المقدّس ليس زمناً خطّيّاً يمتدّ من الماضي إلى الحاضر، بل هو زمنٌ سرمديٌّ يمكن للإنسان استعادته والدّخول فيه. وهكذا يدخل الأمازيغ في الزّمن الأوّل من أجل الاستعانة بقوّة الأصول لتجديد الحاضر وبعث الحياة في المستقبل. وبالتّالي المشاركة بطريقةٍ فاعلةٍ في إعادة صنع عالمهم وهويّتهم.
وبذلك لا نهدفُ من خلالِ التّذكير بهذه المحكيّات الميثولوجيّة والمعطيات التّاريخيّة والطّبيعيّة والثّقافيّة إبراز مدى معقوليّتها أو لا معقوليّتها، وإنّما الغرض من وراء ذلك هو الكشف عن الكيفيّة الّتي تتيح بها هذه الأخبار بناء نماذج للسّلوك الإنسانيّ، وتضفي على الوجود قيمةً ومعنىً، حيث تبرزُ القيمة الكبيرة الّتي تحوزها ضمن أنماط التّفكير الأسطوريّ والاجتماعيّ الّتي ابتدعها الإنسان لحلّ ألغاز هذا الكون، وتفسير علاقته بالطّبيعة، وكيفيّة تدبير ممكناته الاجتماعيّة والاقتصاديّة (78). لا سيّما أنّ الأسطورة، بتعبير مرسيا إلياد (Mircea Eliade)، تروي تاريخاً مقدّماً وحدثاً جرى في الزّمن البدئيّ، الزّمن الخيَاليّ، هو “زمنُ البدايات” (79)، فهي تحاولُ بلغتها الخاصّة المكثّفة بالرّموز وصفَ تجارب الإنسان في تفاعله مع الظّواهر الطّبيعيّة المختلفة، وسعيه الدّائم نحو إيجاد تفسيراتٍ وتأويلاتٍ للمسَائل الكبرى الّتي تشغل الإنسان في علاقته مع الأرض والماء، وفهم الوقائع الّتي تحدث في أروقة انشغالاته اليوميّة الاعتياديّة (80).
2-3- “إيضْ نْ نَّايْرْ”: بَعْضُ الْأَنْسَاقِ الطُّقُوسِيَّةِ الاحْتِفَالِيَّةِ
لعلّ من أبرز ما يميّز “إيضْ نْ نَّايْرْ” هو تلك العادات والتّقاليد الأمازيغيّة ذات الأبعاد الرّمزيّة الّتي تختلف من مجالٍ إلى آخر، وتعبّر عنها السّاكنة بممارسة طقوسٍ احتفاليّةٍ خاصّةٍ، ترسّختْ جذورها مع الزّمن في الثّقافة الوطنيّة حتّى أضحت اليوم ثروةً لا مادّيةً وطنيّةً مهمّةً.
2-3-1- طُقُوسُ الاحتفالِ ب”إيضْ نْ نَّايْرْ” في بعض المناطق الجزائريّة
يتفنّنُ الأمازيغ في الجزائر، كغيرهم في كلّ ربوعِ شمال إفريقيا، في الاحتفال بهذه اللّيلة تعبيراً عن تمسّكهم بالأرض والوفاء لها، وهو ما تترجمه الطّقوس المتقاطعة في مجملها حول الأرض والزّراعة؛ ففي الغرب، يكون الطّبق الرّئيس على المائدة هو “الشّرشم” المكوّن من خليطٍ من القمح والفول الجافّ والحمّص المطبوخ في ماءٍ مملّحٍ، إضافةً إلى “الثّريد” (الخبز المسقيّ بمرق اللّحم) مع الدّجاج. أمّا في مناطق الوسط، فيحضّر طبق الكسكس بلحم الدّجاج، إلى جانب “المخلط”، وهو طبقٌ مكوّنٌ من الفواكه الجافّة كالتّمر والجَوز والتّين المجفّف والحلوى… وينسحب الأمرُ ذاتُه على أمازيغ الشّرق. ويؤمل دائماً أن تكون هذه المناسبة فرصةً للتّصالح وفضّ النّزاعات العائليّة، فتقدّم الأكلة الرّئيسة في صحنٍ واحدٍ يأكل منه الجميع رمزاً للوحدة (81).
وهكذا يقوم سكّان الأوراس بتغيير الموقد التّقليديّ المتكوّن من الأحجار والرّمال، وتصرّ النّساء بأعالي قرى “بَاتْنَة” ومداشرها على استحضار العادات والتّقاليد الّتي تصاحب إحياء هذه المناسبة، ويجدن متعةً كبيرةً في إعداد طبق “الشّخشُوخَة” أو “الثّريد”، الّذي يحضّر بلحم الغنم أو البقر، وتتناوله بهذه المناسبة النّساء دون الرّجال. فيما تحضّرُ الأسر المزابيّة لهذه المناسبة في مدينة “غرداية” جنوباً منذ بداية شهر يناير، الّذي يتزامن مع نهاية موسم إنتاج التّمر، بأطباقٍ تقليديّةٍ مختلفةٍ ومتنوّعةٍ، مثل طبقَي “الشّرشم” و”الرّفيس”، تضاف إليها كمّياتٌ من السّكّر لتحليته، وطلباً لحلاوة السّنة المقبلة وصفائها.
وتستقبل الأسرُ القبائليّةُ هذه المناسبة، حسب إمكاناتها الاقتصاديّة، بنحر الأضاحي المختلفة؛ حيث يفضّل بعضها ذبح ديكٍ عن كلّ رجلٍ، ودجاجةٍ عن كلّ امرأةٍ، وديكٍ ودجاجةٍ معاً عن كلّ امرأةٍ حاملٍ، بينما لا تشترط بعض القرى نوعاً محدّداً منها، لأنّ الأهمّ في هذا السّياق القبائليّ هو إسالة الدّماء لحماية العائلة من الأمراض والعين الحسود. ومن العادات السّائدة الّتي يواظبون على القيام بها، حلقُ شعرِ المولود الّذي يبلغ سنةً من العمر، وتخصيصه بأجمل الثّياب، ووضعه داخل قصعةٍ كبيرةٍ لترمي فوقه امرأةٌ متقدّمةٌ في السّنّ مزيجاً من الحلويّات والسّكر والبيض، ممّا يُعتقد أنّه يجلب الحظّ، فتكونُ سنتهم صافيةً كحياة هذا الطّفل. ويتجوّل المحتفلون في مناطق كثيرةٍ هذه اللّيلة، وهم يرتدون أقنعةً على وجوههم، ويطلقون الأهازيج المصحوبة برقصاتٍ تقليديّةٍ ضمن كرنفالٍ سنويٍّ خاصٍّ يسمّى: “أَيْرَادْ” (82).
وتتضمّن الاحتفالات المعاصرة إلقاء محاضراتٍ وتنظيم أنشطةٍ أكاديميّةٍ مختلفةٍ تهدف إلى التّعريف بالحضارة الأمازيغيّة وتاريخها، وتناقش مكانتها في مجتمعاتهم وكلّ القضايا المتعلّقة بها (83).
2-3-2- طقوس الاحتفال ب”إيضْ نْ نَّايْرْ” بالأندلس
كانت الأسر الأندلسيّة تحتفل في عصورٍ سابقةٍ بهذه المناسبة بتناول مختلف المنتجات المحلّية من جوزِ وتينٍ وتمرٍ وزبيبٍ… رغم تحذير الفقهاء وتحريمهم لها بسبب تزامنها مع احتفالات ميلاد المسيح (84). ومن آثار ذلك ما نقله ابن قزمان الأندلسيّ من أزجالٍ في ديوانه (85):
الحلونْ يُعْجَنْ والغزلان تباعْ
يَفْرَحْ لليـــــنّيرْ من ماع قطاع
لقد ذا النّصبات أشكالاً ملاحْ
وفيـــــه باللّه للعين انشراحْ
ومن لسْ ماع أو لاد استراحْ
إلّا من يدري فالحالْ اتّساعْ
ترتيبُ الأثمارْ هو شيَّا غريبْ
اللوز والقسطالْ والتّمر العجيبْ
والجوزْ والبلّوط والتّين والزّبيبْ
تَشْتِيتاً مَنْظُـــــومْ لَفْريق اجْتِمَاعْ
2-3-3- طُقُوسُ الاحتِفَالِ ب “إيضْ نْ نَّايْرْ” في بَعْضِ المنَاطِقِ المْغْربيّة
تحيي الأسر المغربيّة في الجنوب هذه المناسبة بطقوسٍ معيّنةٍ، حيث تحرصُ على تحضير أطباق عشاءٍ خاصّةٍ، حسب المناطق، مثل طبق عصيدة “تَاكلّا” (ⵜⴰⴳⵍⵍⴰ) الّذي يحضّر بدقيق الشّعير أو الذّرة والماء والملح والزّبد والعسل، ويزيّن بالفواكه الجافّة أو البيض المسلوق، إلى جانب وجباتٍ وأطباقٍ أخرى من قبيل “أُورْكِيمْنْ” (ⵓⵔⴽⵉⵎⵏ)، وهي حساءٌ من الخضر، و”إِينُودَا”، وهي مزيجٌ من الفواكه الجافّة (لوزٌ، وجوزٌ، وزبيبٌ، وتينٌ، وفولٌ سودانيٌّ). ويضع الرّجال عِصيّاً طويلةً من القصب في المزارع والحقول، حتّى تكون غلال السّنة الفلاحيّة الجديدة جيّدةً وتنمو بسرعةٍ، فيما يقطف الأطفال، بملابسهم الجديدة، الزّهور والورود، ويضعونها عند مداخل المنازل. ويستمرُّ السّهر حتّى وقتٍ متأخّرٍ على رقصات أحواش وأنغام الرّوايس (86).
وفي اليوم الأوّل من السّنة الأمازيغيّة، تحمل النّساء قليلاً من “تاكلّا” أو “بركُوكْشْ” غير المملّح إلى مكانٍ خارج القرية، وينصرفْن دون أنْ يتكلّمن بعد وضعه في المكان المعلوم، وتسمّى هذه العمليّة “أَصِيفْضْ” (ⴰⵚⵉⴼⴹ)، أي إعطاء الجنّ نصيبه من الطّعام. وفي الصّباح الموالي، تقوم فتيات القبيلة ونساؤها بما يسمّى “أَزْكوزيوْ وسْكّاسْ” (ⴰⵣⴳⵓⵣⵉⵡ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ) (تخضير السّنة)؛ حيث يذهبْن إلى الحقول في ضواحي القرية، وهنّ يحملن على ظهورهنّ سلّات “أَزْكيوْنْ” (ⴰⵣⴳⵉⵡⵏ)، ويجمعن مختلف الأعشاب من “أَكلَاسْ” (ⴰⴳⵍⴰⵙ)، الّذي هو أعشاب الشّعير أو “تِيفرَاضِينْ” (ⵜⵉⴼⵕⴰⴹⵉⵏ)، أي سعف النّخيل، لافتتاح السّنة الجديدة بلونٍ أخضر لون الخصوبة والطّبيعة والسّلام (87).
وتحتفل بعض القبائل وسط المغرب (أيت عطّا) ببومالن دادس (إقليم تينغير) على غرار كل القبائل الأطلسيّة بهذه المناسبة بإعداد الكسكس بسبعة أنواعٍ من الخضر (88).
ولكلّ منطقةٍ من الرّيف خصوصيّاتها وعاداتها في تخليد “الحاكوز”، وتمتدّ احتفالاتها لدى بعض القبائل لأيّامٍ عديدةٍ تتخلّلها الولائم الشّعبيّة. فتتواصل في قبيلة “زرقت” ثلاثة أيامٍ، يمنع خلاها طهي القطاني. وفي صباح السّنة الجديدة، يهيّأ طبقٌ خاصٌّ، يضمّ اللّوز والجوز والزّبيب والتّين الجافّ، بينما تعمل القائمات على المنازل على تحضير وجبة كبرى في العشاء تقوم على ديكٍ بلديٍّ أو أرنبٍ. وتعمل نساء قبيلة “آيت سداث” في هذه الفترة على تحضير فطيرة باللّوز تسمّى “تانكولت” (ⵜⴰⵏⴳⵓⵍⵜ)، تقدّم للأطفال الصّغار، الّذين يضعون جزءاً منها تحت وسائدهم معتقدين أنّ حاكوزة (امرأة عجوز) ستأتي ليلاً لتأخذ نصيبها، أي يتقاسمون معها حصّتهم، حتى تباركهم ويكونوا محظوظين طيلة السّنة. كما يتم في الصباح تحضير طبق خاصٍّ بالمناسبة مليءٍ بالفواكه الجافّة، فيما تحضّر خارج المنزل أكلة “إِيبرينْ سْ إيبَاوْنْ” (الدّشيشة) بالفول، وذلك في قدرٍ تسمّى “تَانْقُوشْتْ”، وتؤخذ لتشرب بالمسجد.
ولأنّه يوم عطلةٍ، تمتنع النّساء عن العمل خارج البيت بقبيلة “آيت بونصار”. واعتادت قبيلة “تاغزوت” تحضير طبق الاسفنج بشكلٍ جماعيٍّ وتركه في “الأطباق”، حتى لا تقوم “لالة حاكوزة” بقلبه. وفي اللّيل يتمّ تحضير طبق “الحمص بالكرعين”؛ بينما تقوم نساء قبيلة كتامة بتحضير أكلة “إركمان” من جميع أنواع الحبوب والقطاني (89).
- “إيضْ نْ نَّايْرْ”: جوانب من بعض الطّقوس الاحتفاليّة الزّيانيّة
يمثّل التّراث الشّعبيّ أحد الرّوافد الأساسيّة للحفاظ على هويّة الشّعوب ومصدر اعتزازها بذاتيّتها الحضاريّة، ومنبعاً حيويّاً للإبداع المعاصر. وتزخر بلادُ زيان، في هذا الإطار، بموروثٍ شعبيٍّ مادّيٍ/لا مادّيٍ ضخمٍ وثقافةٍ شفويّةٍ متنوّعةٍ أنتجتها التّراكمات الزّمنيّة المتتابعة والحقب التّاريخيّة المتلاحقة. وقد انعكس أثر ذلك على طقوسها الاحتفاليّة ومعتقداتها الشّعبيّة وتقاليدها المتنوّعة. ولعلّ من أبرز الأمثلة الحيويّة على هذه الدّيناميّات الاجتماعيّة الّتي دأب المجتمعُ الزّيانيُّ على الاحتفاء بها والعناية بكلّ تفاصيلها، احتفاله سنويّاً ب”إِيضْ نْ نّايْرْ” وفق طقوسٍ خاصّةٍ تمارس بطرائق منظّمةٍ، وذلك من منطلق أنّ الطّقوس الشّعائريّة تمثّل الاسترجاع الجماعيّ الّذي يعيد للذّاكرة المحلّيّة أحداث ماضيها العريق؛ حيث تتوسّل بها جلب البركة واستدرار الرّحمات والتّطلّع الميمون لافتتاح موسمٍ زراعيٍّ خصبٍ. فتنتقل هذه الفعاليّات الثّقافيّة من فعل التّأمّل إلى فعل الحركة، الّتي تعتبر ترجمةً مباشرةً للمعتقد كحالةٍ ذهنيّةٍ بينهما تلازمٌ مستدامٌ، فالطّقسُ النّاتجُ عن المعتقد يعودُ ليؤثّر في المعتقد، ويزيد من قوّته وتماسكه، كما يعيد التّوازن إلى النّفس والجسد. ولذلك تأتي هذه الشّعائر المختلفة لتؤدّي حزمةً من الوظائف الاجتماعيّة والثّقافيّة والاقتصاديّة والتّاريخيّة ..(90)
فحسب التّقويم الفلاحي (91)، الّذي ينظّمون به زمنهم الزّراعيّ، ويضبطون به دوراتهم الفلاحيّة، يقيم الزّيانيّون كلّ سنةٍ (في 13 يناير الشّمسيّ) احتفالاتٍ ذات طابعٍ طقوسيّ (92)، يختتمون بها موسماً فلاحيّاً بما لذّ وطاب وتبقّى من حبوبٍ وخضراواتٍ. وحسب بعض الرّوايات الشّفويّة المستقاة من مجال الدّراسة، تهيّئ الأمّ هذه اللّيلة الكسكس من دقيق القمح أو الشّعير بالحليب وسبع خضرٍ: اليقطين أو القرع، واللّفت الأبيض، والحمّص، والجزر، والطّماطم، والخرشوف، والبص (93)، وذلك على مرق ديكٍ “بلديٍّ” أو ديكٍ روميٍّ محلّيٍّ، وقد يضاف إليه أحياناً بيضٌ مسلوقٌ بمعدّل بيضةٍ لكلّ فردٍ من أفراد الأسرة. فتضعُه في صُحْفَةٍ كبيرةٍ (تَازْلَافْت (94) (ⵜⴰⵣⵍⴰⴼⵜ))، يلتفّ حولها أفراد الأسرة جميعاً، ويعملون على أخذ اللّقيمات بأيديهم، ويعتقدُون أنّه من لم يشبع في هذه اللّيلة لن يبلغ ذلك طيلة عامه الموالي، ولذلك تحرص القائمة على الخيمة على أن يشبع كلّ أفراد الأسرة في هذه اللّيلة المباركة، كما تعمل خفيةً على دسّ الصُّحْفةِ بحبّةٍ من التّمر، ويعدّ سعيد الحظّ “أَزُوهْرِي نْ وسْكّاسْ” أو “أَسْعْدِي نْ وسْكّاسْ” من استطاع إيجادها، ممّا يترك مجال المنافسة للبحث وتناول أكبر قدرٍ من الكُسكس، ومن ثمّ تحقيق الشّبع المنشود. ولا تنس أيضاً أن تضعن لقمةً في جانب الكانون/الموقد، أو فوق الخيمة، أو في عتبتها (تَاكّورْتْ نْ وخَامْ) لأهل المكان من الجنّ تبرّكاً وتيمّناً بقدوم العام الجديد. ومن هنا جاءت تسمية “إِيضْ نْ نَّايْرْ” ب”تَالْقِّينْتْ / تَالْقِّيمْتْ” أيْ “اللُّقْمة” في هذه الرّبوع.
وفي الصّباح البَاكر، وقبيل طلوع الشّمس، تُؤخذُ اللّقيمةُ من طرف رئيس الخَيمَة (أَلْمْسِّي) لفحصها وتوقّع أحوال السّنة الفلاحيّة المقبلة (التّنبّؤ بوفاة شخصٍ أو زواجه أو حلول كارثةٍ بالدّوّار (أَسُونْ)…). بينما تنثر الأمّ/الزّوجة بعض الحبّات في الأماكن الّتي تكون مصدر الموارد الطّبيعيّة: الحقول، والمزارع، والمراعي، والاسطبلات، والحظائر، ومخازن الحبوب… معتقدةً أنّها بذلك ستتخصّب الأرض، وسيكثر الزّرع ونسل الماشية، وستعمّ البركة كلّ أرجاء القبيلة. وقد تتركُ بعض الكسكس فوق المائدة اعتقاداً منها أنّ “تَامْغَارْتْ” أو “عَجُوز يناير” تأتي في اللّيل لتأكل ما بقي، وإن لم تجد فسوف تلحق بهم الأذى والضّرر (95).
ومن نساء القبيلة من يفضّلن بهذه المناسبة وقف حياكة النّسيج وإنهاء أيّ عمليّة مرتبطةٍ بها، والحرص على تجديد المواقد وتغيير الأثافي والطّهي على نارٍ هادئةٍ. كما تظهر ملامح الفرحة على الشّيوخ وكبار السّنّ، ويتبادلون التّحايَا والتّهاني، ويعقدون في اجتماعاتٍ حميميّةٍ بالدّوّار (أَسُونْ) الأماني لموسمٍ فلاحيٍّ جديدٍ، يتعاونون فيه على الحرث والزّرع والحصاد بنظام “تِيوِيزِي” (ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ) (96). خاصّةً أنّ الإنسان الزّيانيّ يعيش في هذه الرّبوع على “الانتجاع” (التّرحال صيفاً وشتاءً)، وتصادف احتفاليّة هذه اللّيلة وجود أغلب السّاكنة في السّهل “أَزْغَارْ” (ⴰⵣⵖⴰⵔ) (97). في الوقت الّذي يقود الاحتفال في القبيلة زعيمُها “أَمْغَارْ نْ وسُونْ”، الّذي يكون قد عيّن سلفاً من “جْمَاعْتْ” صاحب الخيمة الّتي ستستضيف العشاء الرّسمي (98).
- “إيضْ نْ نَّايْرْ”: دَلَالَاتُ وَوَظَائِفُ بَعْضِ الطُّقُوسِ الاحْتِفَالِيَّةِ الزَّيَانِيَّةِ
بما أنّ الطّقوس المائيّة تعرف حضوراً قويّاً في جلّ الميثولوجيّات العالميّة؛ فقد عمل الإنسانُ عبر العصور، في سيرورته لفهم الكون، من خلال بداياته الزّراعيّة وخوضه حياة الرّعي، على تطقيس علاقته بالأرض وإحاطتها بنسقٍ من الشّعائر العجائبيّة لمواجهة الظّواهر الطّبيعيّة الّتي تحيط به، ممّا ولّد لدى مختلف شعوب الأرض طقوساً متعدّدةً استطاع بعضُها الاستمرار والصّمود (99)؛ ف”منذ أن وجدت الزّراعة، ظلّت الطّقوس تستجيب لاحتياجاتٍ ملحّةٍ، وفي ذلك يكمن طابعها الكونيّ، ومن بين الطّقوس العتيقة التّي يَجْمَعُ الإثنوغرافيّون بقاياها، تعتبر الطّقوس الزّراعيّة، بلا منازعٍ، الأكثر حيويّةً، والأقلّ تعرّضاً للتّشوّه والتّحوّل، بحيث ظلّت أكثر من غيرها مرتبطةً بالتّمثّلات والتّصوّرات نفسها” (100). وبما أنّ الإنسان، كما هو كائنٌ رمزيٌّ بتعبير إرنست كاسيرر (Ernst Cassirer)، فهو أيضاً كائن طقوسيٌّ بامتيازٍ، حيث “يؤثّث وجوده ويبني عالمه المادّي والمعنويّ، ويرسي نظام الأشياء في الطّبيعة وفي العلاقات بينه وبين الآخرين في مجموعة من الممارسات الرّمزيّة المنظّمة الّتي تكاد لا تخلو منها أفعالهم الفرديّة والجماعيّة، والّتي هي الطّقوس والممارسات الشّعائريّة (101).
ولمّا كانت هذه الطّقوس والرّموز تكتنز تاريخاً من العلاقات والمتخيّلات والخطابات والممارسات الّتي تظلّ دوماً بحاجةٍ إلى القراءة والتّرتيب والتّفسير، وكان المجتمع الزّيانيّ خزّاناً ثقافيّاً لمنظومةٍ من الممارسات الطّقوسيّة والأنشطة الرّمزيّة الّتي يتّخذها أفراده لتنظيم فعاليّاتهم الجماعيّة وتدبير حياتهم اليوميّة والتّفاوض مع واقعهم وعلاقاتهم مع الطّبيعة، وكانت الطّقوس الاحتفاليّة ب”إِيضْ نْ نَّايْرْ” حاضرةً في الممارسات الفلاحيّة باعتبارها شعائر خاصّةً يستعيدها الزّيانيّون كلّ سنةٍ، لارتباطها بمرجعيّاتٍ ميثولوجيّةٍ وبمعطياتٍ طبيعيّةٍ واقتصاديّةٍ، فضلاً عن حكاياتٍ تأسيسيّةٍ وأخبارٍ تاريخيّةٍ؛ بحيث تنتظم في نسقٍ طقوسيٍّ يزخر بالمعاني الرّمزيّة الّتي تتّصل بالسّياقات السّوسيوثّقافيّة، ممّا يستدعي مساءلتها ومقاربتها لفهم شواغل الجماعة الزّيانيّة وضميرها الجمعيّ، والكشف عمّا ينتجه المتخيّل الشّعبيّ الأمازيغيّ (الزّيانيّ) والمعطى التّاريخي من صورٍ ورموزٍ ذهنيّةٍ. لا سيّما أنّ احتفال الزّيانيّين بهذه المناسبة لا يستند إلى أيّ مرجعيّةٍ دينيّةٍ أو عرقيّةٍ واضحةٍ، وإن كان يشكّل دليلاً على متانة العلاقة الّتي تربطهم بالأرض، فيتفاءلون بسنةٍ مليئةٍ بالخير والبركات ووفرة المحصول. ومن ثمّة فهو يؤدّي عندهم وظائف نفسيّةً وروحيّةً، واجتماعيّةً، واقتصاديّةً، وثقافيّةً…
4-1- اَلْوَظَائِفُ النَّفْسِيَّةُ وَالرُّوحِيَّةُ:
يسمّي الأنثروبولوجيّون الشّعائر والطّقوس الّتي يقوم بها الإنسان للتّقرّب من الطّبيعة والسّيطرة عليها “شعائر وطقوس التّعضيد أو التّقوية”، وتتّخذ لدى المجتمعات الزّراعيّة، والأمازيغيّة الزّيانيّة ضمنها، شكل الاحتفالات أو الطّقوس الدّوريّة السّنويّة، وذلك بغرض إظهار الاحترام والتّوقير لقوى الطّبيعة وفوق الطّبيعة، وللقوى الخاصّة بالخصوبة (102). مثلما ترتبط بالأزمات والمشكلات الّتي تتعرّض لها كالمجاعات والأوبئة والجفاف. ولذلك تحاول من خلالها السّيطرةَ عليها وحلّ ألغازها؛ فتقدّسُها حيناً، وتحتفي بها حيناً آخر. وكلّ هذه الطّقوس هي ممارساتٌ روحيّة نفسيّةٌ تطهيريّةٌ يتوخّون من خلالها لتحسين صحّتهم النّفسيّة، والشّعور بالانتعاش والحيويّة، وإبعاد الطّاقة السّلبيّة، وتجري في حياتهم بصورةٍ تناقليّةٍ، وتعكس خفايا معتقداتهم الثّقافيّة والاجتماعيّة، وتكشف عن عمق صّلتهم الرّوحيّة بممارساتهم الشّعائريّة المختلفة، فضلاً عن وظائف أخرى، مثل:
- التماس الخير والسّعادة: ولذلك يتجنّب الزّيانيّون في “إِيضْ نْ نّايْرْ” النّباتات ذات الطّعم المرّ، لأنّها ترمز لمرارة العيش، ويفضّلون في المقابل تناول البيض الّذي يحيل على الغنى والرّفاهيّة والثّروة والخصوبة، ومن ثمّة لن يكون في كُسكس هذه اللّيلة فعلاً آليّاً أو تفكيراً ساذجاً مرتبطاً بتناول ما تنتجه الأنشطة الفلاحيّة بهذه الرّبوع، بل يحمل دلالاتٍ ومعانٍ عميقةً، تتمثّل في جلب الحظّ وتوفير المحصول والإكثار من الخيرات. خاصّةً أنّه يرتبط ببعض المعتقدات الأسطوريّة الشّعبيّة؛ إذ إنّ للبيضة “دورٌ هامٌّ في الأفكار الخاصّة ببداية العالم؛ لأنّ الحياة خرجت منها. وطبقاً لأسطورةٍ قديمةٍ، خرج الإله الأوّل إلى الوجود من بيضةٍ وضعت في أحراش إحدى المستنقعات”. كما تحضر في التّراث البرهمانيّ، ويقصد بها البيضة الكونيّة، أي البيضة الّتي خرج منها في فجر الأزمنة الأولى الإله الأوّل والخالق الّذي أطلقت عليه التّسميات المختلفة من بينها الجنين الذّهبيّ” (103).
- إبعاد أشباح الجوع والعين والحسد: تخصّب الأرضُ بوسائل ميثافيزيقيّةٍ كثيرة (104)، لأنّ الحياة المقدّسة عند الشّعوب الزّراعيّة لا تنفصل عن الحياة العمليّة، ومن هنا كان الذّبح وإسالة الدّماء على العتبة قرباناً للخصوبة، وطلباً للبركة والخلاص ودرءاً للأخطار والحسد (105). ولذلك يعتقد الزّيانيّون أنّ في إسالة الدّماء حمايةً للأسرة من الأمراض والعين وكلّ المخاطر طوال السّنة. ويحرصون على عدم القيام بالأشغال الشّاقّة كالرّعي والعمل في الحقول، لأنّه أوّلاً يوم عيدٍ، وثانياً خوفاً من وعيد العجوز، وثالثاً لاعتقادهم أنّ من لا يحترم هذه العادات سيصاب السّنة المقبلة باضطراباتٍ نفسيّة وسيعاني من صعوباتٍ نفسيّةٍ وماديّةٍ واجتماعيّةٍ…
- إشاعة روح التّفاؤل والأمل في المستقبل: لذلك تحرص الأسرُ الزّيانيّةُ على إشعال النّار، فلهذه الأخيرة جذورٌ دفينةٌ في النّفس البشريّة. فقد ظهرت عند الشّعوب البدائيّة الأولى كحاجةٍ طبيعيّةٍ، لكن مع مرور الزّمن، استحوذت على الإعجاب والتّمجيد، ومن ثمّة العبادة والتّقديس؛ فاستعمال النّار في هذه اللّيلة يتجاوز استعماله الطّبيعيّ المتمثّل في إشعال الحطب للطّبخ والتّدفئة، ولو أنّه حاجةٌ طبيعيّةٌ بالنّظر إلى البيئة الغابويّة للمجتمع الزّيانيّ، لأنّها إشعاعٌ ونورٌ يحلّان على العام الجديد، ويطرحان الخير والبركة والإنتاج الوفير. ولذلك تفضّل النّساء الزّيانيّات في مناطق كثيرةٍ تغيير الكوانين والأثافي والطّهي في أوانٍ جديدةٍ لوضع حدٍّ لحقبةٍ تاريخيّةٍ معيّنةٍ والسّماح لها بالتّجديد والولادة الجديدة.
وهكذا كانت القبائل الزّيانيّة تولي سنويّاً أهمّيةً عظمى لطقس تجديد العالم؛ لأنّها تعتقد بذلك أنّ العالم يصبح مولوداً جديداً وأكثر أمناً واستقراراً. ومن ثمّ تحضر أسطورة العجوز لتكرّس الرّوابط الموجودة بين الإنسان والطّبيعة، عطفاً على كلّ الأساطير المرتبطة بالخصب والطّقوس الدّوريّة، ويجري تكرار أحداثها واستعادة دورة الحياة فيها بهدف الإيحاء للطّبيعة النّباتيّة بالانبعاث بعد انقضاء الشّتاء، ودفع دورة الفصول الّتي لا غنى عنها للحياة الزّراعيّة. وما يقوم به الزّيانيّون من طقوسٍ هذه اللّيلة لا يتّخذ صفة العبادة للقوى العلويّة، بل مشاركتها فقط بالرّجوع طقسيّاً إلى زمنها الأوّل، من أجل مساعدتها على الانبعاث من جديدٍ. وبذلك يمكن فهم حرص ربّات البيوت على استبدال الأواني القديمة بأخرى جديدةٍ، وتغيير حجارة الموقد التّقليديّ، بالإضافة إلى نسج زرابي جديدةٍ، لاستقبال العام الجديد بألبسةٍ وأفرشةٍ وأوانٍ جديدةٍ، بعد أن يتمّ طلاء البيت وتزيينه والتّخلّص من كلّ شيءٍ قديمٍ.
4-2- اَلْوَظَائِفُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ:
تعطي الأشكال الثّقافيّة الّتي ينتجها المجتمع الزّيانيّ، والاحتفالات جزءٌ منها، الأولويّةَ دائماً للأسرة كمؤسّسةٍ رسميّةٍ، لأنّها منبع مختلف أشكال التّنشئة الاجتماعيّة، وفيها يتلقّى الفرد قيم الجماعة، ولعلّ هذا الرّهان على دورها كنواةٍ أساسيّةٍ (على حساب القبيلة والمجتمع) لم يكن اعتباطيّاً أبداً، فهو يخفي وراءه قيماً صلبةً وأعرافاً صارمةً تتمّ الاستكانةُ إليها لهيكلة المجتمع هيكلةً إيديولوجيّةً كاملةً، هيكلةً تنطلق أوّل الأمر – بشكلها المادّيّ- من تقسيم الأدوار الاجتماعيّة بين الجنسين، ثمّ تنتقل إلى الجانب الرّمزيّ والمتمثّل أساساً في الاحتفالات والأشعار والحكايات والأساطير وغير ذلك (106). حيث ترتبط النّساء عموماً في المتخيّل الشّعبيّ المغربيّ بالحضور المكثّف من قلب العديد من الممارسات الطّقوسيّة الّتي تعتمل في المجتمع، سواء الطّقوس الفلاحيّة أو الدّينيّة أو السّحريّة أو الضّرائحيّة، وهو في الحقيقة له ما يبرّره واقعيّاً، بالنّظر إلى حجم الاستبعاد الجماعيّ والخطابات النّمطيّة الّتي تلاحقهن (107)، ففي سجلّ “القداسة” يحتكر الرّجال البركة، بينما تقذف المرأة في مقامات ممارسة ما يناقضها كالسّحر والطّقوس الوثنيّة (108).
وتشكّل الأنشطة الفلاحيّة جوهر الأعمال الّتي تنشغل بها المرأة الأمازيغيّة الزّيانيّة، فهي تمارس الرّعي، وتسقي الزّرع، وتشارك في الحرث وجمع المحصول وتخزينه، كما أنّها تعدّ الوجبات في الاحتفالات والمواسم الفلاحيّة، إلى جانب، وهذا هو الأهمّ، العلاقة الوظيفيّة الّتي تربطها بالأرض، بحيث تشكّل الخصوبة الدّليل الرّمزيّ لهذه العلاقة المرأة / الولادة (الأرض / الإنبات). هذا التّشابه الوظيفيّ، تمّ تمثّله وتصوّره ذهنيّاً، فصار متخيّلاً اجتماعيّاً، أي تمثّلات الأفراد والفئات الاجتماعيّة (109). ولذلك ترتكز احتفالات “إِيضْ نْ نَّايْرْ” على ربّات البيوت؛ فهنّ اللّواتي يحرصن على تحضير كمّيّةٍ كافيةٍ من الكسكس، حتّى يتسنّى لكلّ فردٍ من الأسرة أخذ كفايته من الأكل (أي يشبع)، لأنّ العادة جرت بأنّ وفرة الطّعام في هذه اللّيلة يساعد على أن تكون السّنة مباركةً ومملوءةً بالخيرات. وهنّ أيضاً اللّاتي يتّصلن بالعوالم الميتافيزيقية الأخرى، وتقدّم لهنّ القرابين ونصيبها من طعام اللّيلة (اللّقمة/”تَالْقّينْتْ”).
كما تعدّ هذه المناسبة اجتماعيّاً عيداً خاصّاً يلتقي فيه كلّ أفراد الأسرة من أجل:
- تجديد العهد وتطوير ديناميّات التّواصل التّفاعليّ لشبكة العلاقات الاجتماعيّة؛
- تكريس أعراف التّكافل الاجتماعيّ خصوصاً نظام “تَاوِيزَا” (ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ) و”تَاضَا” (ⵜⴰⴹⴰ)، و”تَايْمَاتْ (ⵜⴰⵢⵎⴰⵜ)، وإبراز إبراز صور التآزر الاجتماعيّ من خلال تجميع الصّدقات وتوزيعها على المحتاجين؛
- تبادل الزّيارات العائليّة للتّأكيد على صلة الأرحام والقرابة، وإقامة الصّلح وإنهاء الخصومات والنّزاعات بين أفراد الأسرة/القبيلة؛
- ضمان التّوازن الاجتماعيّ بين الفرد والجماعة، وتأكيد الارتباط الوثيق بين الأجيال، مع الحرص على تأمين تبعيّة الأجيال اللّاحقة للأجيال السّابقة.
4-3- اَلْوَظَائِفُ الْاِقْتِصَادِيَّةُ:
ترتبط أغلب الطّقوس الفلاحيّة بالمجتمع المغربيّ، وضمنها المجتمع القبلّيّ الزّيانيّ، بالمواسم الاحتفاليّة، سواء مع بداية السّنة الفلاحيّة أو أثناء الرّبيع أو عند نهاية الحصاد، لتجديد العلاقة مع الطّبيعة وإخصاب عطاءاتها (110). وذلك على غرار كلّ المجتمعات التّقليديّة الّتي تقوم على اقتصاد الكفاف في تدبير ممكناتها المعيشيّة، وتعتمد بشكلٍ كبيرٍ على الفلاحة، وتحتلّ داخلها الأنشطةُ الزّراعيّةُ مكانةً مهمّةً في أشغال حياتها اليوميّة القرويّة، وقد جعل هذا الحضور المكثّف للفلاحة الفعلَ الزّراعيَّ، بما هو فعلٌ إنسانيٌّ، وهو فعلٌ طقوسيٌّ ورمزيٌّ، أي مجالٌ خصبٌ لمجموعةٍ من الممارسات و”الأفعال المتكرّرة والمقنّنة، الّتي غالباً ما تكون احتفاليّةً وذات طابعٍ شفويٍّ أو حركيٍّ وذات صبغةٍ رمزيّةٍ تؤدّي وظائف جماعيّةً تشبع حاجيات كامنةً في حياة الأفراد والمجتمعات” (111). ويستند الزّيانيّون، بهذا الصّدد، إلى “إيضْ نْ نَّايْرْ” لضبط السّقي والغرس؛ إذ يشكّل إعلاناً عن نهاية موسم الحرث وانتصاف شهر الأمطار. ويأملون في الحصول على إنتاجٍ فلاحيٍّ وزراعيٍّ متنوّعٍ ووفيرٍ. وما طبخ الكسكس بسبع خضرٍ في هذه اللّيلة إلّا دلالةٌ على التنّوّع والغنى المرجوّين في محاصيل السّنة القادمة وتفاؤلٌ بالغنى والخير الكثير. كما يحيل منع إعارة الأشياء والنّسيج والحياكة وإخراج الآلات من البيت إلى فتح آفاق تنمية مواردهم الاقتصاديّة، لأنّهم يعتقدون أنّ في مثل هذه الممارسات مدعاةٌ للحاجة والفقر.
4-1-اَلْوَظَائِفُ الثّقَافِيَّةُ والسِّيَاسِيَّةُ:
تذكّر هذه المناسبة الأمازيغيّين (الزّيانيّين) بماضيهم العريق وانتصاراتهم التّاريخيّة الّتي بصمت سيرورتهم عبر العصور (غزو الملك شِيشْنق لمصر القديمة). ومن ثمّ فهي إرثٌ تاريخيٌّ للذّاكرة الجمعيّة الأمازيغيّة وتجديدٌ للعهد بذكرى النّصر على الأعداء. وإضافةً إلى ذلك، فهي تعمل على:
- إثبات الهويّة الأمازيغيّة وجذورها الثّقافيّة بطقوسها وعاداتها، وتأكيد الارتباط الوثيق بين الأجيال (تناول لقيمات الكسكس من صحفةٍ واحدةٍ، والاحتفال الجماعيّ بالمناسبة)؛
- تجذير ثقافة القيم الكونيّة لضمان مستقبل السّلم والأمن بين البشر.
- ترسيخ الثّقافة المدنيّة؛ إذ تعدّ هذه الاحتفاليّة من الاحتفالات القليلة الّتي تقام بعيدا عن فضاءات الأضرحة والمساجد والزّوايا وغيرها من الفضاءات ذات الوظائف التّعدّديّة: إنّه احتفالٌ مدنيٌّ بامتيازٍ.
وتكتسي الاحتفالات بهذه المناسبة أبعاداً أخرى مهمّةً، خاصّةً في السّنين الأخيرة؛ حيث تعرف نقاشاً حادّاً حول تفعيل الطّابع الرّسميّ للأمازيغيّة؛ إذ في الوقت الّذي كانت فيه بعض الجهات الّتي ترى في بروز أيّ رمزٍ ثقافيٍّ أمازيغيٍّ تبخيساً لرموز الثّقافة العربيّة والإسلاميّة، وتَعُدُّ الاحتفال بهذه المناسبة مجرّد ابتكارٍ لمضايقة رأس السّنة الهجريّة، يحتفل العالم الأمازيغيّ بهذه المناسبة منذ الماضي البعيد، وحتّى بالمناسبتين دون أن يخلق ذلك أيّ إشكالٍ أو مضايقةٍ. وقد كان الاحتفال الرّسميُّ برأس السّنة الأمازيغيّة، قبل ترسيمه في ماي 2023، مطلباً واقعيّاً وديموقراطيّاً، حيث يدخل في إطار استعادة الرّموز الثّقافيّة والحضاريّة الأمازيغيّة.
ونافلة القول، إنّ الاحتفال في المجتمع الزّيانيّ يعدّ مفتاحاً ذهبيّاً للتّغلغل إلى قلب الهويّة المحليّة، لكونه يقدّم، بشكلٍ مكثّفٍ، إحساساً بالذّات الفرديّة ومدخلاً لفهم التّغيّرات الفكريّة والثّقافيّة للجماعة / القبيلة، كما أنّه يشجّع الزّيانيّين ذاتهم، من خلال محتوياته الفريدة، على التّعرف على أنفسهم وعواطفهم وتطلّعاتهم. وبذلك فإنّ المحتوى الثّقافي ل”إِيضْ نْ نّايْرْ” يبرز قدرةً هائلةً على تنظيم نبض هذا المجتمع وتعزيز انسجام فئاته المختلفة (112)، ويعمل على تجاوز مجال الجماليّات إلى إحداث التّوازن بين الإنسان والطّبيعة، وتمرير العديد من المحتويات الثّقافيّة والاجتماعيّة من الأجيال السّابقة إلى الأجيال اللّاحقة. وهو ما جعله يحافظ على استمراريّته وإعادة إنتاجه رغم الزّحف الثّقافيّ العولميّ.
خاتمة:
يبدو ممّا سبق أنّ الطّقس الشّعبيّ مفهومٌ مفارقٌ لدى القبائل الأمازيغيّة الزّيانيّة، فهو لا يمثّل لديهم مجرّد شعيرةٍ عابرةٍ لا معنى لها، أو احتفالٍ عامٍّ بغير جوهرٍ؛ وإنّما هو جزءٌ رئيسٌ من موروثها الثّقافيّ. ولذلك، يشقّ وجود طقوسٍ شعبيّةٍ أو احتفالاتٍ زيانيّةٍ غير مستندةٍ إلى أنساقٍ قيميّةٍ محدّدةٍ، لأنّ التّوجيهات الرّوحيّة والأخلاقيّة والقيم الاجتماعيّة هي جوهرها وأسّها المتين؛ كما إنّها من الوسائط الأساسيّة الّتي يتمّ عبرها تكريس القيم الأمازيغيّة والتّأكيد على النّماذج العرفيّة المختلفة، ممّا يزيد من تعلّقهم وارتباطهم بطقوسهم واحتفالاتهم الشّعبيّة.
ولمّا كانت الغاية من مساءلة عموم الطّقوس الاحتفاليّة هي البحث عن الكيفيّات الّتي يتفاوض بها الإنسان مع واقعه المجتمعيّ، ويدبّر بها حياته اليوميّة، والّتي تعكس في الحقيقة نظرته إلى الحياة والكون، فإنّ العودة إلى تفكيك طقوس الاحتفال ب “إِيضْ نْ نّايْرْ” داخل الممارسات الثّقافيّة الزّيانيّة يراد منه فهم السّند التّاريخيّ والحكاية الميثولوجيّة التّأسيسيّة الّتي عملت على اختلاقه، ومن ثمّ ضمان استمراريّة بقائه على قيد التّشغيل والاشتغال وأداء الوظائف والأدوار داخل المجتمع الأمازيغي (113).
وقد مكّنتنا هذه العودة من الكشف عن الأهمّيّة الكبيرة الّتي تؤدّيها الأسطورة في حياة الزّيانيّين، فهي تحمل معانٍ ودلالاتٍ رمزيّةً قويّةً ترتبط بحدثٍ جرى في الزّمن الأوّل، لذلك تتمّ استعادته في الزّمن الرّاهن من أجل تدبير العوائق الطّبيعيّة الّتي تعيق العلاقة الحميمة بين الإنسان والأرض، والّتي يشكّل الماء أساسها الوجوديّ وقوّتها الحيويّة. ولذلك تظهر عمليّة تطقيس في احتفاليّة “إِيضْ نْ نّايْرْ” حجم الخوف من الأزمات والجوائح ومخاطر الطبيعة الّذي يعتري أهالي زيان (114).
ويمكن أيضاً، اعتبار هذا الاحتفال من الطّقوس الّتي تمثّل التّراكم الثّقافي والاعتقاديّ، الّذي عرفه الإنسان الأمازيغيّ منذ العصر القديم، والّذي اندمجت فيه المعتقدات الطّوطميّة والدّينيّة بالتّقاليد والعادات الاجتماعيّة؛ حيث تحضر طقوس “الأكل” القائمة على المنتوجات الزّراعيّة المحليّة هي الممثّل الرّئيسيّ، وتعبّر عن ذلك النّظام السّوسيوثقافيّ المرتبط اقتصاديّاً بالموسم الفلاحيّ والزّراعيّ، الّذي يعتمد إقامة الاحتفال طلباً لبركة السّنة الفلاحيّة، ودرءاً للشّرور، واتّقاءً من القوى الطّبيعيّة، خاصّةً أنّ هذا الاحتفال يأتي وسط أربعينيّة “اللّيالي” الباردة والحاسمة في الموسم الفلاحيّ ونموّ المحاصيل الزّراعيّة.
وفي الختام، نقدّم النّتائج الآتية:
- “إِيضْ نْ نَّايْرْ” في بلاد زيان جزءٌ من تراثها التّليد، والاحتفال به هو إعادة قراءةٍ لتاريخها.
- الممارسات والطّقوس والشّعائر الّتي تصاحب هذا الاحتفال ترجمةٌ وأداءٌ للمعتقدات الشّعبيّة الّتي تفسّرها الأسطورة والطّبيعة والتّاريخ في المنطقة.
- “إِيضْ نْ نَّايْرْ” في بلاد زيان تقليدٌ مرتبطٌ بالطّبيعة والموسم الفلاحيّ، لأنّ الإنسان الزّيانيّ محبٌّ لأرضه وطبيعته، ويقوم بهذه الطّقوس والشّعائر لاستعطاف القوى الطّبيعيّة لترضى عنه، فتقدّم له عاماً جديداً حافلاً بالخيرات والبركة والإنتاج الوفير.
- “إِيضْ نْ نَّايْرْ” جزءٌ من الشّعائر والعادات الاحتفاليّة المرتبطة بالموسم الزّراعيّ والفلاحيّ في كلّ ربوع “تَامَازْغَا” الّتي ربطت الإنسانيّ بالطّبيعيّ.
- الأصلان الطّبيعيّ والميثافيزيقيّ لهذه المناسبة، وإن كانا متباعدين ومتنافرين، إلّا أنّهما وجهان لحقيقةٍ واحدة، لأنّ التّكوين الأوّل للزّيانيّين مرتبطٌ بالخصب الدّوريّ للأرض والانبعاث الجديد للفصول، الّذي لولاه لما كان لهم أن يستمرّوا في هذه الرّبوع عبر الزّمن؛ إذ الأرض هي الأمّ الحاضنة، والّتي تخرج منها كلّ الخيرات الّتي تسمح بتأبيد وجودهم. لهذا تحتلّ الأرض مساحةً واسعةً في الطّقوس الّتي تقام في هذه الاحتفاليّة السّنويّة تمجيداً لهذه الأمّ واعترافاً بخيراتها، وطلباً للخصب والرّخاء والغلّة الوفيرة، ومحاولةً لتجنّب غضبها الّذي يأتي في شكل جفافٍ وجدبٍ وأوبئة (115). وهو ما يفسّر ارتكازها على الأمّهات في إعداد وأداء شعائرها المختلفة.
- الاحتفال ب “إِيضْ نْ نَّايْرْ” يعكس المشهد الثّقافيّ الحيويّ العريق للهويّة الأمازيغيّة، ويكشف عن عمق صلات التّرابط والتّلاحم في شبكة العلاقات الاجتماعيّة للمجتمع الزّيانيّ، كما يحمل طابع التّطهير والتّجديد لهذا المجتمع في شكله المتجذّر والمتأصّل تاريخيّاً.
- الاحتفال بالسّنة الأمازيغيّة الجديدة يعدّ من بين أساليب النّضال الأمازيغيّ الّذي يتوخّى إقرار الحقوق الأمازيغيّة، فرديّاً وجماعيّاً، لأنّه أحد الرّموز الأساسيّة الّتي استثمرها المناضلون الأمازيغيّون لإبراز هويّتهم وثقافتهم العريقة.
البيبليوغرافيا
- باللغة العربية
- إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط. 2، ج. 2، 1972.
- ابن صنيتان محمّد، السّعوديّ السّياسيّ والقبيلة، الشّبكة العربيّة للأبحاث والنّشر، بيروت، ط: 1، 2008.
- ابن قزمان أبو بكر القرطبي، ديوان أبن قزمان القرطبي، تحقيق وتصدير فيديريكو كورينتي، تقديم محمود علي مكي، المجلس الأعلى للثقافة، المكتبة العربية، القاهرة، 1995.
- ابن كرعي حليمة، تحديد بعض المفاهيم المتصلة بالعرف، الأعراف بالبادية المغربيّة، منشورات مجموعة البحث في تاريخ البوادي المغربيّة، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 1، مطبعة السّلام، الرّباط، 2004.
- أديوان محمد، الثّقافة الشّعبيّة المغربيّة، الذّاكرة، المجال والمجتمع، مطبعة سلمى، الرّباط، 2002م.
- أسبينيون روبير، أعراف قبائل زيان: مساهمةٌ في دراسة القانون العرفيّ الأمازيغيّ المغربيّ، ترجمة محمد أوراغ، تنسيق: أحمد الشهبي، منشورات المعهد الملكيّ للثّقافة الأمازيغيّة، مركز التّرجمة والتّوثيق والنّشر والتّواصل، مطبعة المعارف الجديدة، الرّباط، 2007.
- إفقيرن سعيد، “هكذا يحتفل جبالة بالعيد الأمازيغي”، جريدة تاويزا، العدد 2957.
- أقبوش إدريس، جوانب من السياسة الاستعمارية الفرنسية بمنطقة زيان من التّمهيد إلى التّطويع، مغرب التّنوّع: مباحث في التّاريخ والتّراث، كتاب جماعي من تنسيق عبد العلي المتليني، وجواد التّباعي، ومولاي الزهيد علوي، مركز رؤى للدراسات والأبحاث، ط. 1، مطبعة وراقة بلال، فاس المغرب، 2021.
- أهمان سعيد، السّنة الأمازيغيّة.. القصّة الكاملة للمناسبة وخلفيّاتها، موقع “TELQUEL” عربي، الخميس 11 يناير 2018م، على الساعة 8:30 (تمت زيارة الموقع يوم 26 دجنبر 2023 على الساعة 45: 10).
- بن لحسن محمّد، نظرية المقاومة من خلال مخطوطة كباء العنبر من عظماء زيان وأطلس البربر، دراسة تنظيرية مع توثيق النص، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في التاريخ المعاصر، جامعة القاضي عياض كلية الآداب بني ملال، تحت إشراف لحسن أغزادي، السنة الجامعية 1997.
- بن منصور عبد الوهاب، قبائل المغرب، المطبعة الملكية، الرباط، الجزء الأول، 1968.
- بورقيّة رحمة، الدّولة والسّلطة والمجتمع: دراسةٌ في الثّبت والمتحوّل في علاقة السّلطة بالقبائل في المغرب، ط: 1، دار الطليعة، بيروت، 1991م.
- بوطالب محمد نجيب، سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربي، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بيروت، ط: 1، 2002.
- بوطقوقة مبارك، “”يناير”: الأمازيغ: طقوس وأساطير”، السفير العربي، موقع: https://assafirarabi.com/ar/3985/2015/01/21/””يناير”: الأمازيغ: طقوس وأساطير” (25/12/2023,18:30).).
- البيذق، أبو بكر بن علي الصنهاجي، المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، دار المنصور، الرباط، 1971.
- بيل ألفريد، بعض طقوس الاستمطار إبان الجفاف لدى المغاربيّين، ترجمة خالد طحطح، منشورات الزّمن، الرّباط، 2016.
- التّباعي جواد، جوانب من الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسّياسيّة والعسكريّة بمنطقة زيان خلال فترة الحماية 1912 – 1956، أطروحة جامعيّة نوقشت بكليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة سايس، جامعة سيدي محمد بن عبد اللّه.
- التوفيق أحمد، “أيت أمالو”، معلمة المغرب، مطابع سلا، الجزء الثاني، 1989.
- جبلي علي، القبيلة والمجتمع: قراءةٌ في أدوار القبيلة السّعوديّة المعاصرة وتأثيرها الدّاخليّ، مركز الفكر الاستراتيجيّ للدّراسات، أوراقٌ سياسيّةٌ، 42، (fikercenter.com)، وقد تمت زيارة الموقع وتحميل الدّراسة يوم الأربعاء 11 شتنبر 2024.
- الخشاب مصطفى، علم الاجتماع، عالم الكتب، القاهرة، 1985.
- دو فوكو شارل، التّعرّف على المغرب 1883 – 1884، ترجمة المختار بلعربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط: 1، 1999.
- دوتي إدموند، السّحر والدّين في شمال إفريقيا، الإصدار 3، ترجمة فريد الزّاهي، منشورات المعهد العلميّ، 2019م.
- ديب فرج اللّه صالح، حول أطروحة كمال صليبي: التّوراة في اللّغة والتّاريخ والثّقافة الشعبيّة، دار الحداثة، بيروت، ط: 1، 1989.
- رشوان حسن عبد الحميد، دور المتغيّرات الاجتماعيّة في الطّبّ والأمراض، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندريّة، مصر، 1983.
- رقاد الجيلالي، فتيسي فاتح، الطقوس الأمازيغية لبوعفيف “أمغار وقروش”: بحث في رمزية الاحتفال الكرنفالي بين التقنّع والمساخر، مجلة روافد للدراسات والأبحاث العلمية في العلوم الاجتماعية والإنسانية، المجلد 07، ع: 2، جوان 2023م.
- الركيك محند، السنة الأمازيغية 2072 بين الحقيقة التّاريخية والأركيولوجية والعلمية وحقد أشباه باحثين متنطّعين يناصبون العداء لكلّ ما هو أمازيغي، جريدة هسبريس الالكترونية، 26 يناير 2022، 03: 18. (تمّت زيارة الموقع 25 دجنبر 2023م على الساعة 19:35).
- الزّاهي نور الدّين، المقدّس والمجتمع، إفريقيا الشّرق، الدّار البيضاء، المغرب، 2011.
- زيدان عبد الباقي، الأسرة والطّفولة، ط: 4، مكتبة النّهضة العربيّة، القاهرة، مصر، 1980.
- الزياني، أبو القاسم، الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا، تحقيق عبد الكريم الفيلالي، مطبعة فضالة، المحمدية، 1967.
- السّلاوي الناصري أحمد بن خالد، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، الجزء التاسع، تحقيق وتعليق أحمد النّاصري، منشورات وزارة الثّقافة والاتصال، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2001.
- شاكر سليم مصطفى، قاموس الأنثروبولوجيا، جامعة الكويت، الكويت، ط: 1، 1981.
- الشربيني لطفي، شرح المصطلحات النّفسيّة، دار النّهضة العربية، بيروت، ط: 1، 2001.
- طلبة نور الدين عثمان، نورة بعيو، الأنساق الكرنفالية في الطقوس الشعبية الأمازيغية، مجلة إشكالات في اللغة والأدب، جامعة تامنغست، الجزائر، المجلد: 11، ع: 2، 2022م.
- عبّاسة محمد، “الجذور الحقيقيّة لحفل النّاير أو اليَنْيْر مستاّة من كتاب “الموشّحات والأزجال وأثرها في شعر التّروبادور”، ينظر الموقع الالكتروني: http://archive.org/details/Mouwachahat. (تمت زيارة الموقع يوم 05/12/2023 على الساعة: 18:35).
- عربوش مصطفى، من تاريخ منطقة إقليم تادلة وبني ملال، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1989.
- العشماوي مرفت، دورة الحياة: دراسةٌ للعادات والتّقاليد الشّعبيّة، دار المعرفة الجامعيّة، مصر، 2011م.
- العطري عبد الرحيم، بركة الأولياء: بحثٌ في المقدّس الضّرائحيّ، شركة النّشر والتّوزيع المدارس، الدّار البيضاء، المغرب، 2014م.
- العطري عبد الرّحيم، هشام كموني، “تاغنجا أو تسليت ن ونزار” طقوس الاستمطار في المجتمع القرويّ، مجلّة أنثروبولوجيا، مجلد 08، ع. 01، 2022.
- العلمي أحمد، “صفحات من مقاومة قبائل زيان للاستعمار الفرنسي، مقاومة موحى أوحمو”، ضمن ندوة المقاومة المسلحة والحركة الوطنية للأطلس المتوسط 1907-1956، خنيفرة أيام 11-12-13 نونبر 1999، منشورات المندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير، مطبعة بني إزناسن، سلا، 2001.
- العلمي محمد، حاكوزة، مجلّة التّراث الشّعبيّ، ع. 1، 1978م.
- العلوي التقي، “أصول المغاربة، القسم البربري اتحادية زيان”، مجلة البحث العلمي، ع. 24، 1975.
- عيساوي عبد الرحمان، سيكولوجيّة الخرافة، دار النّهضة العربيّة، بيروت، د. ط، 1984م.
- الغامدي سعيد فالح، البناء القبلي والتّحضّر في المملكة العربيّة السّعوديّة، المكتب الجامعيّ الحديث، الإسكندريّة، ط: 5، 1990.
- الفاسي الفهري محمد البشير بن عبد الله، قبيلة بني زروال: مظاهر حياتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، مطبوعات المركز الجامعي للبحث العلمي، الرباط، 1962.
- فرحات المصطفى، طقوس وعادات أهل ابزو، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغيّة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ط: 1، 2007.
- الفيروز آبادي، القاموس المحيط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط: 3، ج: 3، 1979م.
- قرقوري إدريس، الطقوس والشعائر الاحتفالية في النّصّ المسرحيّ الجزائريّ (Programme national de recherche culture et civilisation, PNR, 25, édition DGRSDT CRASC.)، 2014.
- قرورو عقيلة، “الاحتفاليّة الأمازيغيّة يناير بين الأداء الطّقوسيّ والوظيفة الاجتماعيّة: مقاربة في ميثولوجية الاحتفال الشعبيّ الأمازيغي”، مجلّة قبس للدّراسات الإنسانيّة والاجتماعيّة، مجلّد 08، العدد 01.
- القصير عبد القادر، الأسرة المتغيّرة في مجتمع المدينة العربيّة: دراسةٌ ميدانيّةٌ في علم الاجتماع الحضريّ والأسريّ، دار النّهضة العربيّة للطّباعة والنّشر، بيروت، ط: 1، 1999م.
- كنّون سعيد، الجبل الأمازيغيّ أيت أومالو وبلاد زيان: “المجال والإنسان والتّاريخ”، تعريب: محمد بوكبّوط، منشورات الزّمن، سلسلة ضفاف، التّوزيع: سبريس، العدد 18، نونبر 2014م.
- المحواشي منصف، الطّقوس وجبروت الرّموز: قراءةٌ في الوظائف والدّلالات ضمن مجتمعٍ متحوّلٍ، مجلّة إنسانيّات الجزائريّة، ع. 49، يوليوز – شتنبر 2010.
- مرسيا إلياد، مظاهر الأسطورة، ترجمة نهاد خياطة، دار كنعان للدّراسات والنّشر، دمشق، سوريا، 1991م، ص: 10.
- مصطفى شاكر سالم، قاموس الأنثروبولوجيا، جامعة الكويت، ط: 1، 1981م.
- المنصوري أحمد، كباء العنبر من عظماء زيان وأطلس البربر، تحقيق محمد بن لحسن، تقديم مصطفى الكثيري، منشورات المندوبية السّامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التّحرير، مطبعة الكرام، الرّباط، ط: 1، 2004.
- باللغة الأجنبية
- Ben Lahcen, Mohamed, Moha Ouhammou Zayani, l’âme de la résistance marocaine à la pénétration militaire française dans le moyen atlas (1908 – 1921), Imp. Info –Print, Fès, Maroc, 2000.
- BENVENISTE (E.), le vocabulaire des institutions indo-européennes, Editions de Minuit, Paris,
- Cazeneuve (Jean), Sociologie du rite, PUF, Paris, 1972.
- Colin, George, “origine arabe des grands mouvements de population berbère dans le Moyen Atlas”, Hespéris, TXXV, 1938.
- EVANS-RITCHARD (E.E.), The Nuer. Oxford, Clarendon Press, 1940, (trad.fr. Les Nwer, Paris, Gallimard, 1968).
- GLUCKMAN (Max), Politics, law and Rintal in Tribal Society, Chicago, 1965.
- Laroui Abdellah, Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain 1830 – 1912, Edition La découverte, Paris, 1977.
- Loubignac, Victorien, Etude sur le dialecte berbère des Zaïans et Ait Sgougou, publication de l’institut des hautes études marocaine, Paris, E. Leroux, première partie, 1924.
- MORGAN (Lewis Henry), Ancient Society, New York, Solt (trad.fr. La société archaïque, Paris, Anthropos, 1971.
- SAHLINS (Marshall David), Tribesmen, Englewood Cliffs, New Jersey. Prentice Hall, 1968.
- SCHAPERA (Isaac), Government and Politics in Tribal Society, Londres, Watts, 1958.
- Servier, Jean, Les portes de l’année, Rites et Symboles, L’Algérie dans la tradition méditerranéenne, Paris, Robert Laffont, 1962.
- [1]– Jean Servier, Les portes de l’année, Rites et Symboles, L’Algérie dans la tradition méditerranéenne, Paris, Robert Laffont, 1962, p. 315.
- [1] – المصطفى فرحات، طقوس وعادات أهل ابزو، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغيّة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ط: 1، 2007، ص: 23.
- [1]– نور الدين عثمان طلبة، نورة بعيو، الأنساق الكرنفالية في الطقوس الشعبية الأمازيغية، مجلة إشكالات في اللغة والأدب، جامعة تامنغست، الجزائر، المجلد: 11، ع: 2، 2022م، ص: 69.
- [1]– حليمة بن كرعي، تحديد بعض المفاهيم المتصلة بالعرف، الأعراف بالبادية المغربيّة، منشورات مجموعة البحث في تاريخ البوادي المغربيّة، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 1، مطبعة السّلام، الرّباط، 2004، ص: 7.
- [1]- عبد الرّحيم العطري، هشام كموني، “تاغنجا أو تسليت ن ونزار” طقوس الاستمطار في المجتمع القرويّ، مجلّة أنثروبولوجيا، مجلد 08، ع. 01، 2022، ص: 12.
- [1]- إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط. 2، ج. 2، 1972، ص: 561.
- [1]- Cazeneuve (J.), Sociologie du rite, PUF, Paris, 1972, pp. 12-13.
- [1]- لطفي الشربيني، شرح المصطلحات النّفسيّة، دار النّهضة العربية، بيروت، ط: 1، 2001، ص: 319.
- [1]- مصطفى شاكر سليم، قاموس الأنثروبولوجيا، جامعة الكويت، الكويت، ط: 1، 1981، ص: 893.
- [1]– رقاد الجيلالي، فتيسي فاتح، الطقوس الأمازيغية لبوعفيف “أمغار وقروش”: بحث في رمزية الاحتفال الكرنفالي بين التقنّع والمساخر، مجلة روافد للدراسات والأبحاث العلمية في العلوم الاجتماعية والإنسانية، المجلد 07، ع: 2، جوان 2023م.ص: 814 – 815.
- [1]– الفيروز آبادي، القاموس المحيط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط: 3، 1979م، ج: 3، ص:347.
- [1]– إدريس قرقوري، الطقوس والشعائر الاحتفالية في النّصّ المسرحيّ الجزائريّ (Programme national de recherche culture et civilisation, PNR, 25, édition DGRSDT CRASC.)، 2014، ص: 21.
- [1]– مصطفى شاكر سالم، قاموس الأنثروبولوجيا، جامعة الكويت، ط: 1، 1981م، ص: 161.
- [1]– مصطفى الخشاب، علم الاجتماع، عالم الكتب، القاهرة، 1985، ص: 54.
- [1]– حسن عبد الحميد رشوان، دور المتغيّرات الاجتماعيّة في الطّبّ والأمراض، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندريّة، مصر، 1983، ص: 179.
- [1]– عبد الباقي زيدان، الأسرة والطّفولة، ط: 4، مكتبة النّهضة العربيّة، القاهرة، مصر، 1980، ص: 06.
- [1]– عبد القادر القصير، الأسرة المتغيّرة في مجتمع المدينة العربيّة: دراسةٌ ميدانيّةٌ في علم الاجتماع الحضريّ والأسريّ، دار النّهضة العربيّة للطّباعة والنّشر، بيروت، ط: 1، 1999م، ص: 33 وما بعدها.
- [1]– روبير أسبينيون، أعراف قبائل زيان، م. س، ص: 77.
- [1]– سعيد كنّون، الجبل الأمازيغي أيت أومالو وبلاد زيان: “المجال والإنسان والتاريخ”، م. س، ص. 80.
- [1]– م. ن.
- [1]- BENVENISTE (E.), le vocabulaire des institutions indo-européennes, Editions de Minuit, 1969, Paris.
- [1]- MORGAN (L.), Ancient Society, New York, Solt (trad.fr. La société archaïque, Paris, Anthropos, 1971.
- [1]- EVANS-RITCHARD (E.E.), The Nuer. Oxford, Clarendon Press, 1940, (trad.fr. Les Nwer, Paris, Gallimard, 1968).
- [1]- SCHAPERA (I.), Government and Politics in Tribal Society, Londres, Watts, 1958.
- [1]- GLUCKMAN (M.), Politics, law and Rintal in Tribal Society, Chicago, 1965.
- [1]- SAHLINS (M.), Tribesmen, Englewood Cliffs, New Jersey. Prentice Hall, 1968.
- [1]– علي جبلي، القبيلة والمجتمع: قراءةٌ في أدوار القبيلة السّعوديّة المعاصرة وتأثيرها الدّاخليّ، مركز الفكر الاستراتيجيّ للدّراسات، أوراقٌ سياسيّةٌ، 42، (www.fikercenter.com)
- [1]– محمد نجيب بوطالب، سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربي، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بيروت، ط: 1، 2002، ص: 55 – 56.
- [1]– سعيد فالح الغامدي، البناء القبلي والتّحضّر في المملكة العربيّة السّعوديّة، المكتب الجامعيّ الحديث، الإسكندريّة، ط: 5، 1990، ص: 8.
- [1]- Abdellah Laroui, Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain 1830 – 1912, Edition La découverte, Paris, 1977.
- [1]- Idem, p. 170.
- [1]– محمّد بن صنيتان، السّعوديّ السّياسيّ والقبيلة، الشّبكة العربيّة للأبحاث والنّشر، بيروت، ط: 1، 2008، ص: 32.
- [1]– سعيد فالح الغامدي، البناء القبلي والتّحضّر في المملكة العربيّة السّعوديّة، م. س، ص: 10.
- [1]– روبير أسبينيون، روبير أسبينيون (قائد الشّؤون الحربيّة الإسلاميّة، مدير المركز الإسلاميّ للتّوثيق والنّشر بالإقامة العامّة الفرنسيّة بالمغرب)، أعراف قبائل زيان: مساهمةٌ في دراسة القانون العرفيّ الأمازيغيّ المغربيّ، ترجمة محمد أوراغ، تنسيق: أحمد الشهبي، منشورات المعهد الملكيّ للثّقافة الأمازيغيّة، مركز التّرجمة والتّوثيق والنّشر والتّواصل، مطبعة المعارف الجديدة، الرّباط، 2007، ص: 16.
- [1]– Victorien Loubignac, Etude sur le dialecte berbère des Zaïans et Ait Sgougou, publication de l’institut des hautes études marocaine, Paris, E. Leroux, première partie, 1924, p: 4.
- [1]– سعيد كنّون، الجبل الأمازيغيّ أيت أومالو وبلاد زيان: “المجال والإنسان والتّاريخ”، تعريب: محمد بوكبّوط، منشورات الزّمن، سلسلة ضفاف، التّوزيع: سبريس، العدد 18، نونبر 2014م، ص.ص. 17-18.
- [1]– شارل دو فوكو، التّعرّف على المغرب 1883 – 1884، ترجمة المختار بلعربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط: 1، 1999، ص.ص: 132-133.
- [1]- Mohamed ben Lahcen, Moha Ouhammou Zayani, l’âme de la résistance marocaine à la pénétration militaire française dans le moyen atlas (1908 – 1921), Imp. Info –Print, Fès, Maroc, 2000, p. 13.
- [1]– إدريس أقبوش، جوانب من السياسة الاستعمارية الفرنسية بمنطقة زيان من التّمهيد إلى التّطويع، مغرب التّنوّع: مباحث في التّاريخ والتّراث، كتاب جماعي من تنسيق عبد العلي المتليني، وجواد التّباعي، ومولاي الزهيد علوي، مركز رؤى للدراسات والأبحاث، ط. 1، مطبعة وراقة بلال، فاس المغرب، 2021، ص. ص: 114-116.
- [1]– أيت أومالو: كلمة أمازيغية تعني الظل، وقد تعني السفح الظليل، ونتحدث عن سكان “أومالو” مقابل سكان “أسمر” أو السفح المشمس، أحمد التوفيق، “أيت أمالو”، معلمة المغرب، مطابع سلا، الجزء الثاني، 1989، ص، 648.
- [1]– هو أحمد بن قاسم بن محمد المنصوري أصلا، المكناسيّ دارا وإقرارا، الزياني منشئا، ولد بقرية خنيفرة ببلاد زيان حوالي سنة 1897م، وتوفّي سنة 1965م (ينظر أحمد المنصوري، كباء العنبر من عظماء زيان وأطلس البربر، تحقيق محمد بن لحسن، تقديم مصطفى الكثيري، منشورات المندوبية السّامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التّحرير، مطبعة الكرام، الرّباط، ط: 1، 2004، ص: 17.
- [1]– أحمد المنصوري، كباء العنبر من عظماء زيان وأطلس البربر، م. س، ص: 75.
- [1]– مالو هي أومالو وأمالو، فالكلمة أمازيغية الأصل، وعندما أدخلت إلى اللغة العربية، اختلفت كتابتها من باحث لآخر.
- [1]– أبو القاسم الزياني، الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا، تحقيق عبد الكريم الفيلالي، مطبعة فضالة، المحمدية، 1967، ص: 548.
- [1]– أحمد بن خالد السّلاوي الناصري، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، الجزء التاسع، تحقيق وتعليق أحمد النّاصري، منشورات وزارة الثّقافة والاتصال، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2001، ص: 199.
- [1]– أبو القاسم الزياني، الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برّاً وبحراً، م. س، ص: 548.
- [1]– م. ن، ص: 34.
- [1]– محمّد بن لحسن، نظرية المقاومة من خلال مخطوطة كباء العنبر من عظماء زيان وأطلس البربر، دراسة تنظيرية مع توثيق النص، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في التاريخ المعاصر، جامعة القاضي عياض كلية الآداب بني ملال، تحت إشراف لحسن أغزادي، السنة الجامعية 1997، ص: 59.
- [1]– أبو بكر بن علي الصنهاجي البيذق، المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، دار المنصور، الرباط، 1971، ص: 53.
- [1]– م. ن، ص: 34.
- [1]– عبد الوهاب بن منصور، قبائل المغرب، المطبعة الملكية، الرباط، ج. 1، 1968، ص: 265.
- [1]– محمد بن لحسن، نظرية المقاومة من خلال مخطوطة كباء العنبر من عظماء زيان وأطلس البربر، م. س، ص: 58-59.
- [1]– أحمد المنصوري، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، م. س، ص،72.
- [1]– العلمي (أحمد)، “صفحات من مقاومة قبائل زيان للاستعمار الفرنسي، مقاومة موحى أوحمو”، ضمن ندوة المقاومة المسلحة والحركة الوطنية للأطلس المتوسط 1907-1956، خنيفرة أيام 11-12-13 نونبر 1999، منشورات المندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير، مطبعة بني إزناسن، سلا، 2001، ص: 89.
- [1]– Colin (George), “origine arabe des grands mouvements de population berbère dans le Moyen Atlas”, Hespéris, TXXV, 1938, p, 267.
- [1]– Ibid, p. 265.
- [1]– Ibid, p. 266.
- [1]– العلوي التقي، “أصول المغاربة، القسم البربري اتحادية زيان”، مجلة البحث العلمي، ع. 24، 1975، ص: 78-79.
- [1]– محمد بن لحسن، نظرية المقاومة من خلال مخطوطة كباء العنبر من عظماء زيان وأطلس البربر، م. س، ص، 69.
- [1]– Colin (Georges), “origine arabe des grands mouvements de population berbère dans le Moyen Atlas”, op. cit, p, 267.
- [1]– تقويم فلاحي لأنّه يرتبط بالفلاحة وبهدف تنظيم الأعمال الزّراعيّة؛ إذ أبدع الأمازيغ طريقةً خاصّةً بهم لضبط تسلسل ومراحل التّطوّر المستمرّ للدّورات الفلاحيّة.
- [1]– يناير: الشهر الأول بالأمازيغيّة (يانْ أَيُورْ ⵢⴰⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ)، وهو في الوقت ذاته إله البدايات عن الرّومان.
- [1]– عبد الرحيم العطري، بركة الأولياء: بحثٌ في المقدّس الضّرائحيّ، شركة النّشر والتّوزيع المدارس، الدّار البيضاء، المغرب، 2014م، ص: 27.
- [1]– مبارك بوطقوقة، “”يناير”: الأمازيغ: طقوس وأساطير”، السفير العربي، موقع: https://assafirarabi.com/ar/3985/2015/01/21/””يناير”: الأمازيغ: طقوس وأساطير” (25/12/2023,18:30).).
- [1]- تنظر تفاصيل أكثر على الموقع: https://www.chellala.org/wp/?p=511 (تمّت زيارة الموقع 26 دجنبر 2023م على الساعة 18:00).
- [1]– سعيد أهمان، السّنة الأمازيغيّة.. القصّة الكاملة للمناسبة وخلفيّاتها، موقع “TELQUEL” عربي، الخميس 11 يناير 2018م.
- [1]– محند الركيك، السنة الأمازيغية 2072 بين الحقيقة التّاريخية والأركيولوجية والعلمية وحقد أشباه باحثين متنطّعين يناصبون العداء لكلّ ما هو أمازيغي، جريدة هسبريس الالكترونية، 26 يناير 2022، 03: 18.
- [1]– م. ن.
- [1]- يناير أو (Ianiarius) يانياريوس الروماني، شهر الإله جانوس أو يانوس (Janus) إله المداخل في ميثولوجيا رومانية، ويرمز للتجديد. يُصوّر على شكل إنسان له وجهان: وجه ينظر إلى الخلف، رامزاً للماضي، أي لما مضى، ووجه ينظر إلى الأمام، رامزاً للمستقبل. فكان أول أشهر السنة عند الرومان، يناير، مناسبةً لتخليد فكرة “البداية” المتجددة التي اعتُبر هذا “الإله” رمزا لها. يعتور هذه النظرية الغربية السائدة ضعفان أساسيان وهما: الضعف الأول أنها لا تاخذ بعين الاعتبار المعنى الحرفي للفظ “يناير” في اللاتينية والعائلة اللغوية التي تنتمي إليها اللاتينية أي الهندو أوروپية. فلفظة (iānuārius) في اللاتينية تتكون من مورفيمين (وحَدَتيْن صوتيَّتيْن دالَّتيْن)، وهما: (iānu) “يانو” و (ārius) “ياريوس”. “يانو” أو “يانوس”، حسب زعمهم، هي اسم الإله “يانوس”، و”ياريو” هو “الشهر”. لكن إذا حذفنا اللاحقة “وس” في “يانوس”، وهي لاحقة تدل في اللاتينية على إعراب الرفع، سيكون الحاصل هو “يان” التي تعني في معظم الهندو أوروپية “واحد”. من ذلك مثلا أن العدد “واحد” في الهندو أوروپية الأصلية (w)ein- وفي النرويجية القديمة (einn) وفي الإنجليزية القديمة (ān) وفي الجرمانية القديمة العالية(ein). وعليه فإن المعنى الأصلي ل (iān) “يان” هو “واحد”، حتى ولو اكتسبت هذه اللفظة في فترة لاحقة معنى “اسم إله البدايات”.
- الوجه الثاني للضعف في هذه النظرية الغربية أن لفظة (ārius) اللاتينية حسب زعمهم لم تكن تعني “شهر” أصلا لأن اللفظة الدالة على معنى “شهر” في اللاتينية هي (īdūs) أو (mēnsis) التي أصلها في الهندو أوروپية (mēns). فماذا تعني لفظة (ārius) إذن؟ إذا حذفنا من (ārius) اللاحقة الدالة على إعراب الرفع في اللاتينية تبقى لنا (āri) لتدقيق معنى هذه اللفظة، علينا أن نحفر في تاريخها الذي يعود إلى لغة إنسان إيغود، أي اللغة الأمازيغية القديمة، لغة الإنسان العاقل الأول. فعندما تدرس أصل هذه اللفظة في الأمازيغية، تجد أنها تجمع بين الأصل المبني على الحقيقة والفرع المبني على المجاز. فالمادة “ير(ⵢⵔ)، تلهج بأشكال مختلفة ك “ئيور” (ⵉⵢⵓⵔ) و”أيّور” (ⴰⵢⵢⵓⵔ) و”ؤير” (ⵓⵢⵔ) (في لهجة غدامس) تعني “القمر” و”الشهر القمري” كليهما. أما إذا بحثت عن هذا الأصل في اللغة الهندو أوروپية الأصلية، فإنك ستجد المادة يير yr تعني “سنة” و”موسم” لا تفيد معنى “القمر” أو أي شيء مما كان يستدل به الإنسان البدائي على الزمان. من هذا الأصل جاءت (year) الإنجليزية وهورا (hora) اليونانية التي تعني أي جزء من السنة بما فيها الشهر، وأي جزء من اليوم بما فيها الساعة منها (hour) الإنجليزية و (heure) الفرنسية، ومنها أيضا (jahr) بالألمانية و”شهر” بالعربية، و(jaru) بالسلاڤونية، وغير ذلك كثير مما تمدنا بها المعاجم الإتيمولوجية. المعنى الأقدم للفظ اللاتيني (ārius) إذن هو “القمر” وليس “الشهر”. فإذا أضفناه إلى “يان” التي تعني “واحد” في الهندو أوروپية والأمازيغية كليهما، يصبح معنى (iānuārius) هو “القمر الأول”. وهذا ينسجم مع المعطى التاريخي الذي اكتشفه مكتشف التقويم الأمازيغي القديم وهو المترجم الهولندي بوڭرت نوكو ڤان دين (1997 (Berber Literary Traditions of the Sous) الذي جمع معطيات هذا التقويم من تراث التوارڭ ووثائق أخرى. (محمد الحلوي، التقويم الأمازيغي أصل التقويم الجورجي، جريدة هسبريس الالكترونية: ((https://www.hespress.com/AC-404813.html) تمت زيارة الموقع يوم 25/11/2022 على الساعة: 18:35).
- [1]- الفاسي الفهري محمد البشير بن عبد الله، قبيلة بني زروال: مظاهر حياتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، مطبوعات المركز الجامعي للبحث العلمي، الرباط، 1962، ص: 14.
- [1]- العلمي محمد، حاكوزة، مجلّة التّراث الشّعبيّ، ع. 1، 1978م، ص. 35.
- [1]- محمد عبّاسة، مستغانم، 2012، ص: 153 وما بعدها الجذور الحقيقيّة لحفل النّاير أو اليَنْيْر مستلّة من كتاب “الموشّحات والأزجال وأثرها في شعر التّروبادور”، (ابن قزمان، الدّيوان، زجل، ص: 72)، ينظر الموقع الالكتروني: http://archive.org/details/Mouwachahat.(تمت زيارة الموقع يوم 05/12/2023 على الساعة: 18:35).
- [1]- سعيد إفقيرن، “هكذا يحتفل جبالة بالعيد الأمازيغي”، جريدة تاويزا، العدد 2957، ص. 11.
- [1]- https://aljarida24.ma/p/actualites/60012/. (تمت زيارة الموقع يوم 12/05/2022 على الساعة الرابعة مساء)
- [1]– تقويم يبدأ من سنة 284م، وهي السنة التي شهدت تعذيب وقتل الأقباط المسيحيين من طرف الإمبراطور الروماني DIOCLETIANVS، ويسميها القبطيون “سنة الشهداء”. ينظر مبارك بلقاسم، ما هي الشهور الأمازيغية؟ وكيف اخترعت السنة الأمازيغية والهجرية؟، موقع هسبريس .
- [1]– منظمة المجتمع العلمي العربي على الموقع الإلكتروني: https://arsco.org/
- [1]– مقولة زيانيّة متداولة في هذه المناسبة.
- [1]- ينظر الموقع: https://www.raialyoum.com/
- [1]– رواية شفوية متداولة كثيرا في الأطلس المتوسط استقاها الباحث من مجال البحث.
- [1]– عبد الرحيم العطري، هشام كموني، “تاغنجا” أو “تِيسليت ن ونزار”: طُقوسُ الاستمطار في المجتمع القرويّ، م. س، ص: 16.
- [1]– إلياد مرسيا، مظاهر الأسطورة، ترجمة نهاد خياطة، دار كنعان للدّراسات والنّشر، دمشق، سوريا، 1991م، ص: 10.
- [1]- عبد الرّحيم العطري، هشام كموني، “تاغنجا” أو “تسليت ن ونزار”: طُقوسُ الاستمطار في المجتمع القرويّ، م. س، ص: 16.
- [1]- https://www.alarabiya.net/north
- [1]- ينظر موقع العربية على الشبكة العنكبوتية https://www.alarabiya.net/north
- [1]– م. ن.
- [1]– محمد عبّاسة، مستغانم، الجذور الحقيقيّة لحفل النّاير أو اليَنْيْر مستلّة من كتاب “الموشّحات والأزجال وأثرها في شعر التّروبادور”، 2012، ص: 153، وما بعدها (ينظر الموقع الالكتروني: http://archive.org/details/Mouwachahat (تمت زيارة الموقع يوم: 05/12/2023 على السّاعة: 18:35).
- [1]- أبو بكر بن قزمان القرطبيّ، ديوان ابن قزمان القرطبيّ، تحقيق وتصدير فيديريكو كورينتي، تقديم محمود علي مكّي، المجلس الأعلى للثّقافة، المكتبة العربيّة، القاهرة، 1995، ص: 72.
- [1]- ينظر الموقع: أحداث سوس (تمت زيارة الموقع يوم 25 دجنبر 2023 على الساعة 45: 12).
- [1]– سعيد أهمان، السّنة الأمازيغيّة… القصّة الكاملة للمناسبة وخلفيّاتها، موقع “TELQUEL” عربي، الخميس 11 يناير 2018م،.
- [1]- ينظر الموقع: https://elmalikamag
- [1]– شريف أدرداك، رئيس جمعية أمازيغ صنهاجة الريف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، موقع المغرب 24
- [1]- عقيلة قرورو، “الاحتفاليّة الأمازيغيّة يناير بين الأداء الطّقوسيّ والوظيفة الاجتماعيّة: مقاربة في ميثولوجية الاحتفال الشّعبيّ الأمازيغيّ”، مجلّة قبس للدّراسات الإنسانيّة والاجتماعيّة، مجلّد 08، العدد 01، ص. ص. 1009 -1010.
- [1]- تقومٌ شمسيٌّ يرتبط بالتّعاقب المنتظم للفصول والتّغيّرات المستمرّة الّتي تشهدها الطّبيعة بفعل دوران الأرض حول الشّمس الّذي تنتج عنه تغيّرات الطّقس وأحوال الجوّ. وقد رصد الإنسان هذه التّحوّلات منذ القدم، وقام بضبطها في رزناماتٍ خاصّةٍ مختلفةٍ، بعد اكتشافه للزّراعة والانتقال من مرحلة القطيف والصّيد (سعيد إفقيرن، “هكذا يحتفل جبالة بالعيد الأمازيغي”، م. س، ص: 11).
- [1]– تختلف المصادر بين ليلة أو ليالي الاحتفال وبداية السّنة الأمازيغيّة، ولا توجد تواريخ مضبوطةٌ لدى فقهاء علم المواقيت أو لدى كبار الفلّاحين والمسنّين المهتمّين بأزمنة السّنة الفلاحيّة الأمازيغيّة والمحافظين على العادات والتّقاليد الّتي تستلزمها هذه الأزمنة. كان الأمازيغ يحتفلون بهذه المناسبة حسب التّقويم اليوليانيّ، ولمّا دخل فرنسا المغرب والجزائر، وطبّقت التّقويم الغريغوريّ لأول مرّةٍ، لاحظ السّكان المحليّون أنّ أوّل يناير الجديد قد تقدّم ب 12 يوماً. وكان ذلك في يوم 19 دجنبر من التقويم القديم؛ لذا لم يحتفلوا حسب التّقويم الجديد الّذي عرف حذف عشرة أيام سنة 1582م، بل انتظروا حتّى يوم 12 يناير وكانت الفرصة مواتيةً لمخالفة المستعمر والتّبرّك بيوم 12 وهو مولد النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم. ويحتفل المغاربة بهذه المناسبة يوم 13 يناير، لأنّه في الوقت الّذي بدأوا يطبّقون فيه التّقويم الجديد، كان التّقويم القديم قد تأخّر ب 13 يوماً، وذلك ابتداء من شهر مارس 1900م.
- [1]- روايةٌ شفويّةٌ للسّيّد واعراب لحسن (100 سنةٍ) من قبيلة أيت شارض، جواد التّباعي، جوانب من الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسّياسيّة والعسكريّة بمنطقة زيان خلال فترة الحماية 1912 – 1956، أطروحة جامعيّة نوقشت بكليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة سايس، جامعة سيدي محمد بن عبد اللّه، ص: 180.
- [1]– وعاءٍ خزفيٍّ كبيرٍ يتّخذ للأكل.
- [1]- مصطفى عربوش، من تاريخ منطقة إقليم تادلة وبني ملال، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1989، ص. ص: 237 – 238.
- [1]– محمد أديوان، الثّقافة الشّعبيّة المغربيّة، الذّاكرة، المجال والمجتمع، مطبعة سلمى، الرّباط، 2002م، ص: 105.
- [1]- حوار مع الفاعل الاجتماعي الحسين أكضى منشور في موقع مملكتنا (تمت زيارة الموقع يوم الاثنين 12 دجنبر 2023).
- [1]- م. ن.
- [1]– ألفريد بيل، بعض طقوس الاستمطار إبان الجفاف لدى المغاربيّين، ترجمة خالد طحطح، منشورات الزّمن، الرّباط، 2016، ص: 50.
- [1]– إدموند دوتي، السّحر والدّين في شمال إفريقيا، الإصدار 3، ترجمة فريد الزّاهي، منشورات المعهد العلميّ، 2019م، ص: 319.
- [1]– منصف المحواشي، الطّقوس وجبروت الرّموز: قراءةٌ في الوظائف والدّلالات ضمن مجتمعٍ متحوّلٍ، مجلّة إنسانيّات الجزائريّة، ع. 49، يوليوز – شتنبر 2010، ص: 15.
- [1]– مرفت العشماوي، دورة الحياة: دراسةٌ للعادات والتّقاليد الشّعبيّة، دار المعرفة الجامعيّة، مصر، 2011م، ص: 30.
- [1]– شيلدريك، روبيرت، إطلاق سراح العلم ، دار الديوان، 1 يناير 2020، ص. 68.
- [1]– عبد الرحمان عيساوي، سيكولوجيّة الخرافة، دار النّهضة العربيّة، بيروت، د. ط، 1984م، ص: 82.
- [1]– فرج اللّه صالح ديب، حول أطروحة كمال صليبي: التّوراة في اللّغة والتّاريخ والثّقافة الشعبيّة، دار الحداثة، بيروت، ط: 1، 1989، ص: 86.
- [1]– نور الدين عثمان طلبة، نورة بعيو، “الأنساق الكرنفاليّة في الطّقوس الشّعبيّة الأمازيغيّة”، م. س، ص: 70.
- [1]- عبد الرحيم العطري، هشام كموني، “تاغنجا أو “”تسليت ن ونزار”: طقوس الاستمطار في المجتمع القروي، م. س، ص: 19.
- [1]– رحمة بورقيّة، الدّولة والسّلطة والمجتمع: دراسةٌ في الثّبت والمتحوّل في علاقة السّلطة بالقبائل في المغرب، ط: 1، دار الطليعة، بيروت، 1991م، ص: 42.
- [1]– عبد الرحيم العطري، هشام كموني، “تاغنجا أو “”تسليت ن ونزار”: طقوس الاستمطار في المجتمع القروي، م. س، ص: 19.
- [1]– نور الدّين الزّاهي، المقدّس والمجتمع، إفريقيا الشّرق، الدّار البيضاء، المغرب، 2011، ص: 84.
- [1]- عبد الرحيم العطري، هشام كموني، “تاغنجا أو “”تسليت ن ونزار”: طقوس الاستمطار في المجتمع القروي، م. س، ص: 17.
- [1]- نور الدين عثمان طلبة، نورة بعيو، “الأنساق الكرنفاليّة في الطّقوس الشّعبيّة الأمازيغيّة”، م. س، ص: 83.
- [1]- عبد الرحيم العطري، هشام كموني، “تاغنجا أو “”تسليت ن ونزار”: طقوس الاستمطار في المجتمع القروي، م. س، ص. ص: 23 – 24.
- [1]- م. ن، ص: 24.
- [1]- مبارك بوطقوقة، “”يناير”: الأمازيغ: طقوس وأساطير”، السفير العربي، موقع: https://assafirarabi.com/ar/3985/2015/01/21/””يناير”: الأمازيغ: طقوس وأساطير” (25/12/2023,18:30).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) أستاذ جامعي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية وجدة، باحث في الدّراسات الأمازيغيّة، وفي اللّسانيّات التطبيقية وعلوم التربية، من أعماله: “معجم المعاني أمازيغي عربي”، “التواصل في المنظومة التربوية في المغرب”، “النظرية الحقلية والصناعة المعجمية الموضوعاتية”..












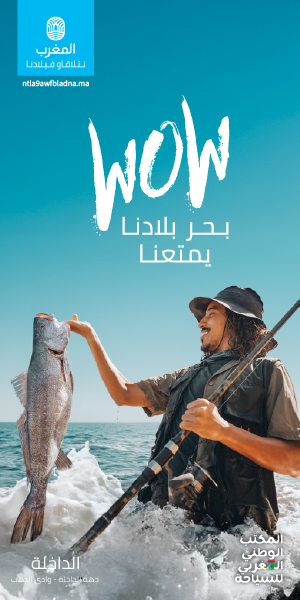
تعليقات
0