نظم “مركز روافد للأبحاث والفنون والإعلام”، في خنيفرة، مساء الأربعاء 19 مارس 2025، ندوة علمية، بشراكة مع المجلس العلمي المحلي، وتنسيق مع المركز الثقافي أبو القاسم الزياني، في موضوع “جوانب من تاريخ المراكز الدينية بالمجال الزياني”، والتي افتتحت بكلمة المركز، تقدم بها ذ. م. إدريس أشهبون، مبرزة دلالات الندوة انطلاقا من الأهمية التي لعبته المراكز الدينية في دراسة تاريخ المغرب الديني، الاجتماعي، الاقتصادي والسياسي، فيما لم يفت رئيس المركز، ذ. حميد ركاطة، استعراض أرضية الندوة المبرزة لأهمية التعريف بالتراث المحلي وإبراز أصالته وضرورة دراسة قضاياه في أبعادها المادية واللامادية كمنطلق لدراسة قضايا التاريخ الوطني.
من جهته، أكد رئيس المجلس العلمي المحلي، ذ. عباس أدعوش، في مداخلته، على أهمية الزوايا الدينية باعتبارها “مرجعا أساسيا للسلم الداخلي للإنسان والتوازن في حياته”، مشددا على ضرورة إيلائها الاهتمام اللائق بمكانتها، وأبرز بالتالي أن المراكز الدينية، بما فيها الزوايا والمساجد والأضرحة، “ليست مجرد فضاءات للعبادة، بل تعد معالم تاريخية وروحية تؤدي أدوارا جوهرية في حياة الأفراد والمجتمعات”، فيما تناول المتدخل مفهوم “المراكز الدينية” من حيث دلالاته اللغوية والفكرية، وانطلاقا من استحضاره كون الله خلق الكون وجعل الشمس مركزا له، أكد أن “الإنسان يحتاج إلى مركز يحفظ له استقراره الروحي والنفسي”.
ومن خلال وقوفه عند الدور الذي تضطلع به المؤسسات الدينية عبر العصور، أشار المتحدث ذ. أدعوش لواقع المجتمعات الغربية، التي “أدى سوء تدبيرها للعلاقة مع الدين إلى حالة من التيه الروحي، ما انعكس على الأفراد في شكل اضطرابات نفسية واجتماعية”، حيث استشهد في ذلك بأعمال عالم الاجتماع البولندي، زيجمونت باومان، الذي تناول في “سوائله” ما يعانيه الإنسان من “فقدان القيم الثابتة”، وكذلك بأفكار عالم الأحياء الفرنسي، ألكسيس كاريل، الذي سلط الضوء في كتابه “الإنسان ذلك المجهول”، وبصورة اجتماعية علمية، على “انعكاسات غياب البعد الروحي في حياة الإنسان”، وعلى ظروف الشخص المادي والشخص الروحي.
واستعرض ذ. عباس أدعوش الغنى الذي يتميز به إقليم خنيفرة في ما يتعلق بالمراكز الدينية، مشيرا إلى تأثير “طبيعته الجبلية في نشأة التصوف، حيث كانت الجبال فضاءً ملائما للخلوة والتأمل والسلوك الروحي”، و”الإنسان الأمازيغي فيها احتضن الإسلام عبر ممارسات دينية مترسخة”، من بينها تحمل تكاليف الإمام وفق ما يُعرف بـ “الشرط”، قبل تركيز المتدخل على الدور البارز للزاوية الدلائية، التي “شكلت مركزا دينيا وعلميا، منذ عهد مؤسسها محمد أبي بكر الدلائي، وقد استقطبت علماء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي”، إلى جانب مساهمتها في نشر المعرفة واضطلاعها بمهام الإحسان وتقديم الدعم للمحتاجين والزوار.
أما الباحث في التاريخ المحلي، ذ. لحسن رهوان، فانطلق في ورقته من ما شهدته منطقة زيان عبر تاريخها الطويل من إشعاع ديني وعلمي كبير، وما استقطبته من شيوخ التصوف لتشكل بذلك “مراكز دينية بارزة ظلت منارات للعلم والإصلاح”، وفي هذا السياق سلط ذ. لحسن رهوان الضوء على واحدة من الزوايا الدينية التي لم تحظَ بالاهتمام الكافي في الدراسات التاريخية، وهي الزاوية التستاوتية، التي أسسها الشيخ محمد بن امبارك الزعري التستاوتي في منطقة حد بوحسوسن، والذي يعود نسبه، حسب المتدخل، إلى ملوية، ويرتبط نسبه الشريف بشجرة النبي، ما أكسبه “مكانة روحية خاصة في الأوساط العلمية والدينية”.
وارتباطا بمداخلته، استعرض ذ. رهوان ما شكلته الزاوية التستاوتية من “محطة مركزية لطالبي العلم والمعرفة، حيث قدمت لهم الإيواء والإطعام، إلى جانب لعبها أدوارا اجتماعية بارزة في الوساطة والتحكيم بين الأفراد والقبائل”، إضافة إلى “الدعوة إلى الجهاد في فترات تعرض المنطقة لأطماع خارجية”، وكيف كانت هذه الزاوية “مقصدا للعلماء والفقهاء من المغرب والمشرق، حيث ازدهرت بفضل ما كانت توفره من بيئة علمية متكاملة، وقد ضمت مسجدا وخزانة علمية ثرية”، فضلا عن مرافق أخرى متكاملة، وتشير الروايات، يقول المتدخل، إلى أن “مدرستها القرآنية كانت تحتضن أكثر من ألف طالب، قبل أن تتعرض للهدم تحت ذريعة تهالك جدرانها”.
واعتمد الباحث ذ. لحسن رهوان، في عرضه، على شهادات عدد من المؤرخين والباحثين والعلماء، مستعرضا بعض “الكرامات التي اشتهر بها الشيخ التستاوتي، مما عزز مكانته الروحية بين أتباعه وتنظيمه لأمور الرعية”، كما لم يفُته التأكيد على “أهمية العمل على انتشال هذه الزاوية من وضعية التهميش والإهمال التي تعاني منها”، داعيا، في اختتام مداخلته، عموم الباحثين في التاريخ المحلي والزوايا الدينية إلى “تعميق البحث في شخصية الشيخ محمد بن مبارك التستاوتي”، وتقوية المرافعة من أجل “إعادة الاعتبار لها نظرا لدورها التاريخي الكبير في نشر العلم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في المنطقة“.
وبدوره، تطرق الباحث ذ. محسن أبعلي إلى البعد التاريخي للحركة الدينية في العاصمة الزيانية، مدينة خنيفرة، وأثرها في الحياة الأخلاقية والاجتماعية، وما شهدته هذه المدينة عبر التاريخ من منارات للعبادة والتعليم والتأثير المجتمعي، وفي تحليله لطبيعة العلاقة بين الدين والتدين، أوضح الباحث أن الخلط بينهما أمر مستحيل، مشيرا إلى أن “التدين يرتبط بالاجتهادات البشرية القابلة للتغيير، في حين أن الدين يبقى ثابتا لا يتبدل”، ومن هذا المنطلق، تناول موضوع تعلق قبائل زيان العميق بالدين الإسلامي، مع نقده لبعض الكتابات الكولونيالية التي حاولت التشكيك في قوة المراكز الدينية بالمنطقة، مثل كتابات فرنسوا بيرجي في كتابه عن موحى وحمو الزياني.
ومن بين المحاور التي تناولها الباحث ذ. محسين، استعراضه لأهم المراكز الدينية التي لعبت أدواراً محورية في خنيفرة، ومنها المسجد الأعظم (الجامع الكبير)، الذي يعود تاريخ بنائه إلى سنة 1887 م، في عهد موحى وحمو الزياني، حيث استلهم تصميمه من معالم مدينة فاس، كما تطرق إلى مسجد البيضاوي، الذي شكل مركزاً دينياً بارزاً، والزاوية التيجانية، التي تعد من أشهر الزوايا في المنطقة والتي يُرجح أن يكون بناؤها قد تم على يد تجار قدموا من فاس، إضافة إلى ذلك، تناول الباحث وجود زوايا ومراكز دينية أخرى بالمدينة، مثل مسجد الزيتونة، والزاوية الدرقاوية، والزاوية الناصرية في تمسكورت التي لا تزال تحتفظ بقيمتها الدينية والتاريخية.
كما أشار المتدخل إلى عدد من الأضرحة التي تنتشر في خنيفرة وتحمل أسماء شخصيات دينية معروفة، مثل سيدي وعياط، وسيدي بوتزكاغت، وسيدي محمد والحسن، وسيدي بوقنادل، وسيدي عبد الكريم الناصري، وقد شكلت هذه الأضرحة “محطات روحية لها أهميتها في الذاكرة المحلية والتاريخ الديني للمدينة”، ومن الجوانب الأخرى التي أثارها الباحث، المصادر التاريخية التي تناولت التواجد اليهودي في خنيفرة، والتي “تعكس ملامح التعايش الديني الذي طبع تاريخ المنطقة”، كما استعرض أهمية الكتاتيب القرآنية في تنشئة الأجيال، قبل أن يتوقف عند ذكر مجموعة من الأعلام والشخصيات الدينية التي تركت بصمتها في المشهد الديني المحلي.












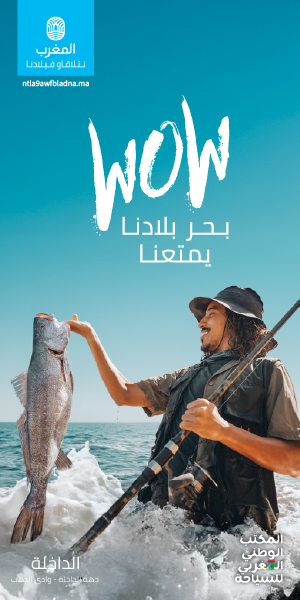
تعليقات
0