أحمد بيضي
احتضنت مدينة خنيفرة، يومي الجمعة والسبت 9 و10 ماي 2025، ندوة وطنية تحت عنوان “خنيفرة الحاضرة الأطلسية بين مفعولات التاريخ ورهانات التنمية والإقلاع الترابي”، نظمتها “مؤسسة روح أجدير الأطلس” بقاعة المحاضرات التابعة لجماعة خنيفرة، وعرفت مشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين، وقد جرى افتتاحها بحضور عامل الإقليم، إلى جانب شخصيات مدنية وعسكرية، وفاعلين جمعويين، وطلبة جامعيين ومهتمين بالشأن المحلي، واستهلت أشغال هذه الندوة بكلمات افتتاحية من طرف أعضاء المؤسسة المنظمة ورئيس جماعة خنيفرة، كما اختتمت الجلسات العلمية بنقاشات كما بتوصيات صيغت انطلاقا من مداخلات المشاركين وتفاعل الحضور مع محاور الندوة.
لماذا الندوة العلمية؟
في كلمته الافتتاحية، شدد ذ. محمد ياسين على المكانة المحورية التي تحتلها مدينة خنيفرة ضمن خريطة الحواضر المغربية، معتبرا المدينة المغربية اليوم أصبحت حاضنة حقيقية للطاقات المجتمعية المتنوعة، مما يجعل من تطورها الديمغرافي والوظيفي مسألة ذات أولوية تستدعي تفكيرا عميقا، كما أكد أن الذاكرة التاريخية لهوية خنيفرة، وما تزخر به من رموز علمية وفنية وثقافية، جعلت منها عبر العصور مجالا للتلاقي والتلاقح الثقافي، وأضاف أن موقع المدينة الإيكولوجي، باعتبارها صلة وصل طبيعية بين الهضبة (أزغار) والجبال (أدرار)، إلى جانب تراثها المادي واللامادي ونسقها العمراني الفريد، يمنحها مؤهلات ثقافية وحضارية.
وفي السياق ذاته، أوضحت ذة. فاطمة أكنوز أن اختيار مدينة خنيفرة، الحاضرة الأطلسية، موضوعا للندوة الوطنية لم يكن اعتباطيا، بل يأتي في إطار سعي أكاديمي وثقافي لتشخيص تاريخها العريق، وثقافتها الأصيلة، والوقوف عند مقوماتها الإيكولوجية، بهدف جعل هذه الخصوصيات رافعة للتنمية ومحركا للإقلاع الترابي، فيما وقفت عند الرهانات الكبرى المرتبطة بتأهيل المجال لتشدد على ضرورة العمل على تثمين ذاكرة المدينة وإنماء حاضرها، بما يؤهلها لأن تكون مدينة منفتحة بما يسمح بفهم آليات التفاعل بين الموروث التقليدي للمدينة ومتطلبات الامتداد العمراني الحديث، في أفق تعزيز الاستثمار الثقافي والتسويق الترابي لموروثها المادي واللامادي.
كما أكد د. حوسى أزارو على أهمية استقراء تطور مدينة خنيفرة، واستجلاء رمزيتها التاريخية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن جاذبيتها السياحية، وذكر بالدور المركزي الذي لعبته المدينة باعتبارها معبرا للملوك والسلاطين بين فاس ومراكش، وموطنا للمقاومة والعلم، فيما أشار إلى أن البحث الأكاديمي مدعو اليوم إلى الانخراط العميق في تفكيك الذاكرة الجماعية للحاضرة الزيانية، من خلال تتبع تحولات المجال والعمران والمجتمع، واعتبر أن الثقافة هي جوهر الإنسان وعمق وجوده الحضاري، ولا يمكن تصور مدينة تنشد التنمية دون اهتمام علمي عميق بثقافتها، وشدد على أن التأهيل ينبغي أن يشمل أيضا الروح الثقافية والعلمية للمدينة.
مفهوم المدينة، دور الجامعة والتطور العمراني
في مداخلته: “المدينة كرمز للتعايش والابتكار”، تناول د. عبد المجيد باعكريم مفهوم المدينة من زاوية فلسفية، موضحا أبعادها اللغوية كفضاء للإقامة والاستقرار، ومبرزا نشأتها التاريخية مع الانتقال من الطبيعة المتوحشة إلى الزراعة، وقد اعتبر المدينة رمزا للتعايش والابتكار بما لم يكن مألوفا في المجتمعات القديمة، فيما ربط بين الإنسان ككائن طبيعي والعالم كحقيقة لا توجد إلا ضمن عوالم ممكنة يصوغها العقل، كما قارن بين الفلسفة اليونانية والفكر الحديث، مستعرضا مفهوم “الكوسموس” كنظام متناغم، يتم فيه انسجام الإنسان مع محيطه، بينما توقف عند الصراع بين العقل والجسد، بوصفه صراعا دائما في مسار بناء المدينة كامتداد للتوازن بين الفكر والمادة.
في مساهمته الموسومة بـ”أثر البنيات التحتية الجامعية في تطوير المدن الصغرى والمتوسطة: حالة خنيفرة”، شدد د. عبد الرحمن حداد من جهته على أهمية تبني مقاربة مندمجة متعددة التخصصات في التفكير في المجال والتراب، معتبرا أن أي سياسة تنموية ناجعة لا بد أن تنطلق من رؤية شمولية تراعي الأبعاد المجالية والبشرية والاقتصادية والسياسية، حيث ركز المتدخل على دور الجامعة كمحرك أساسي في تنمية المدن الصغرى والمتوسطة، متسائلا عن سبل توطين البنيات الجامعية داخل هذه الفضاءات، وكيفية تحويلها إلى مراكز قائمة الذات، مؤكدا أن الوحدة الجامعية يمكن أن تصبح رافعة حقيقية لتنمية المدينة، إذا تم توظيفها ضمن رؤية استراتيجية مندمجة.
أما د. عبد المالك بن صالح فانطلق في ورقته المعنونة بـ”التطور العمراني بخنيفرة”، من استعراض مظاهر الثابت والمتحول في عمران مدينة خنيفرة، مبرزا دلالاتها التاريخية من خلال مجموعة من المعالم الحضرية التي تعكس التحولات المجالية والاجتماعية التي شهدتها التجمعات السكانية بالمنطقة، ومسلطًا الضوء على واقع التوسع العمراني ورهاناته، كما توقف عند تنوع تفسيرات أصل تسمية المدينة، ومتحدثًا عن قنطرة المولى إسماعيل وعن إشكالية تأسيس المدينة سنة 1868، والعلاقات التي نسجها القائد موحى وحمو الزياني مع تجار وصناع فاس، عقب لقائه بالسلطان الحسن الأول، وختم مداخلته بتجليات المتغير العمراني بين سنتي 1912 و1956.
التراث الأمازيغي، الجيوبارك والإمكانات البيئية
في مداخلته المعنونة “من التراث الأمازيغي إلى التنمية الذاتية المستدامة: خنيفرة نموذجا”، أبرز د. مراد أميل الأهمية المحورية التي تكتسيها خنيفرة باعتبارها حاملة لتراث أمازيغي غني ومتنوع، يمكن أن يشكل ركيزة أساسية لنموذج تنموي ذاتي ومستدام، ويؤهلها لتكون نموذجا للتنمية القائمة على الخصوصيات المحلية، كما توقف عند التحديات البنيوية التي تواجه المدينة، من هشاشة اجتماعية وضعف في الولوج إلى التعليم، إلى آثار التغير المناخي وسوء استغلال الثروات الغابوية، وفي المقابل، دعا إلى اعتماد مقاربة تجديدية تقوم على تثمين الموارد المحلية، وتطوير السياحة البيئية، والفلاحة العضوية، ودعم الاقتصاد التضامني.
في مداخلته حول “الجيوبارك العالمي لليونسكو كرافعة للتنمية الترابية: حالة مگون”، أبرز د. إدريس أشتيل أهمية توظيف التراث الجيولوجي في مشاريع تنموية مندمجة تجمع بين حماية البيئة، التربية، والتنشيط الثقافي والسياحي، وأوضح أن الجيوبارك، كتصنيف عالمي، يمثل أداة فعالة لتثمين الموروث الطبيعي ودعم التنمية المحلية، خصوصا بالمناطق الهشة، فيما أبرز الإمكانيات الكبيرة التي يتيحها جيوبارك مگون، من خلال مشاريع مهيكلة تشمل متحف الماء، الحرم الجامعي، قاعة متعددة الوسائط، ومركب سوسيو-ثقافي، إلى جانب استثمار المواقع الطبيعية والمائية، ودعا إلى إشراك الشباب والطلبة في خلق مشاريع ميدانية تربط بين المعرفة والتنمية.
وفي مداخلته حول “الإمكانات البيئية ودورها في التنمية الترابية المستدامة: خنيفرة نموذجا”، أبرز د. محمد عادل إيشو التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه إقليم خنيفرة، ورغم هذه الإكراهات، أشار إلى توفر المنطقة على رصيد طبيعي وجيولوجي مهم، يمكن توظيفه في دعم تنمية مندمجة، من خلال تثمين المواقع السياحية والبيئية كالشلالات، الأقواس الطبيعية، والمتاحف المحلية، خاصة متحف الجيولوجيا بأزيلال الذي يشكل مركزا لجذب الزوار ومجالا لتفعيل السياحة البيئية، كما دعا إلى تقوية دور الجمعيات البيئية وتمويلها، وتحفيز المشاريع الصغرى في السياحة والثقافة، من أجل إرساء نموذج تنموي مرتكز على خصوصيات المجال المحلي.
الأرشيف، التمدين، التحولات، المحاكم العرفية، السنة الأمازيغية والوثائقيات
في مداخلته الافتتاحية للجلسة الثالثة، قدم د. محمد بوكبوط قراءة أرشيفية دقيقة حول “تأسيس خنيفرة وتطورها من خلال الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي”، متحدثا عما توصل إليه من وثائق نادرة ضمن أرشيف فرنسي رسمي، حيث تمكّن من جمع أكثر من 2070 صورة لمستندات تتعلق بخنيفرة ومنطقة زيان، شملت هذه الوثائق مراسلات وتقارير رسمية بين السلطات الفرنسية المركزية ومصالحها بخنيفرة والأطلس المتوسط، تناولت مواضيع تاريخية حيوية، من معركة لهري والقائد موحى وحمو الزياني، إلى التفاعلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين فرنسا وأعيان زيان، كما كشفت أخرى عن معطيات مهمة تخص الإنسان والمجال والثقافة.
في مداخلة مشتركة مع د. عبدالله الحجوي، قدم ذ. سعيد كمتي ورقة علمية حول “حالة بلاد زيان في التمدين بين الرعي والزراعة”، ركزت على تحليل تحولات المجال من منظور سوسيولوجي وجغرافي، مستعرضا أنشطة الرعي والزراعة باعتبارها محركات أساسية في تشكل المجتمع المحلي، متوقفا عند إشكالية الهامش والهامشية، ومظاهر التمدين والقبلية، وموقع بلاد زيان ضمن التقسيمات المجالية والتحولات الحضرية، كما ناقش التمدين كظاهرة استثنائية في سياقات سوسيو-اقتصادية، وتوزع الساكنة بين الجبل والهضبة، ضمن بنية ترابية غير متوازنة، قبل توقفه عند إكراهات التمدين من خلال قراءة نقدية للتقطيعات المجالية والتيارات الجغرافية.
في مداخلة علمية، تناول د. إدريس أقبوش موضوع “التحولات السكانية في خنيفرة: من النشأة إلى الوقت الحاضر”، مركزا على الدينامية الديمغرافية باعتبارها مفتاحا لفهم الإقلاع الترابي والتنمية المحلية، وقد انطلق من الجذور التاريخية لتأسيس خنيفرة، متوقفًا عند الدور الذي لعبه موحى وحمو الزياني في تعمير المدينة، كما استعرض ما وثقته البعثات الأجنبية وأبحاث السلطات الاستعمارية الفرنسية، فيما تميزت المداخلة بعرض إحصائيات سكانية تعكس تحولات التركيبة البشرية، مع التركيز على توزيع السكان، وتاريخ التجارة والنشاط الاقتصادي بالمنطقة، فضلا عن قضايا الشيخوخة مقابل الشباب، والزواج مقابل العزوبة، باعتبارها مؤشرات دالة على التحولات السكانية.
وضمن مداخلة د. حنان أقشيبل بعنوان “قضايا مختارة من سجلات المحاكم العرفية المحلية”، استندت إلى نماذج من الوثائق التي وثّقت جوانب من الحياة الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة خنيفرة، انطلقت فيها المتدخلة من خصائص اللوح والخشب وأعراف تجارة القطران، متناولة أعراف الديون بين كبار التجار، كما وردت في سجلات المحاكم العرفية خلال أربعينيات القرن الماضي، فيما سلطت الضوء على فترة نهضة النشاط التجاري في المنطقة، والتي عرفت استقطاب تجار من مناطق مختلفة، خاصة مدينة فاس، دون أن يفوت المتدخلة الدعوة إلى تثمين التراث الوثائقي العرفي، عبر رقمنة السجلات العرفية وفتح أرشيفات المحاكم في وجه الباحثين.
في مداخلة بعنوان “دلالات ووظائف الأنساق الطقوسية المرتبطة باحتفالات إيض ن نّاير عند قبائل زيان”، استعرض د. محمد أمحدوك البعد الرمزي والوظيفي لاحتفال السنة الأمازيغية، فيما أبرز أن الطقوس المرتبطة بها تشكل ظاهرة سوسيو-ثقافية متعددة الأبعاد، تستدعي القراءة من زوايا اللسانيات، والجغرافيات الثقافية، والدراسات الأنثروبولوجية والسوسيولوجية، لما تحمله من هوية وموروث عريق، كما أشار إلى ما تحمله هذه الاحتفالات من تقويمات وأسماء وأعراف، وما نسج حولها من روايات وأساطير ومعتقدات قديمة، مذكّرا بالاعتراف الرسمي بها كمناسبة وطنية بعد إقرارها في المغرب كعيد مؤدى عنه، وبالاهتمام الدولي الذي حظيت به من خلال اليونسكو.
في مداخلة مشتركة مع ذ. عبد الحق التباعي، تناول د. جواد التباعي موضوع: “مساهمة وثائقيات التلفزيون العمومي بالمغرب في الصناعة الثقافية لمدينة خنيفرة”، مشيرا إلى مساهمة برنامج “أمودو” كنموذج في استعراض ذاكرة المنطقة ومكوناتها الثقافية والطبيعية والإنسانية، عبر مواضيع تناولت المرأة، والمواقع الطبيعية والثروات المائية، والصناعات الثقافية، مدينة فزاز الأثرية، الزاوية الدلائية، موقع إغرم أوسار، مياه أم الربيع، معاناة السكان والحوامل أثناء التساقطات الثلجية، المغارات والكهوف، المدارس الجماعاتية، أجدير كرمز للذاكرة الأمازيغية، تمدرس الفتاة القروية، الأسواق الأسبوعية، التدفئة، طقوس الزواج، صناعة الزرابي والخيام.
الخطاب الفكاهي، إدماج الشباب، البحث الجامعي، البناء الثقافي والثروات التراثية
من جانبه، اختار د. محمد الحيا المشاركة في الندوة بورقة حول “الخطاب الفكاهي في الأطلس المتوسط من خلال تجربة لحسن أزايي”، تناول فيها مسار الفنان الكوميدي الراحل لحسن أزايي باعتباره نموذجا فريدا للمسرح الأمازيغي الشعبي الذي نشأ خارج أسوار المؤسسات الرسمية، مبرزا تمكن هذا الفنان الاستثنائي، بلغته الساخرة وحضوره الفطري، تحويل الحلقة والأسواق الأسبوعية إلى خشبة مسرح يتفاعل فيها مع جمهور عريض، فيما توقف المتدخل عند بعض من أقوال أزايي وحكمه الشعبية، وكيف كان ينشر الضحك في القرى والحواضر على حد سواء، مؤكدا أن هذا الفنان لم ينل حظه من التقدير الإعلامي والتوثيقي.
خلال الجلسة، تناول د. سعيد أصفاح من جهته موضوع “الإدماج الاقتصادي للشباب”، مشددا على ضرورة جعله أولوية وطنية، فيما توقف عند التحولات التي يعرفها مفهوم “الشباب”، بين التبعية العائلية والسعي نحو الاستقلال، وسط تحديات مالية ومهنية حادة، كما سلط الضوء على معضلة فئة واسعة من الشباب غير المتوفرين على شهادات، مما يضعف فرصهم في بناء حياة مستقلة واستقرار اقتصادي، وأشار إلى مبادرات الدولة في هذا المجال، مثل برامج التشغيل الذاتي و”مقاولتي” والمبادرة الوطنية، داعيا إلى إدماج مواد في الفكر المقاولاتي ضمن المناهج التعليمية، وتأهيل الشباب لتبني مشاريع ذاتية تضمن لهم الاندماج الفعلي في النسيج الاقتصادي.
في ورقة علمية مشتركة مع د. سيدي محمد الكتاني، قدّم د. الحو عبيبي مداخلة تناول فيها موضوع “مساهمة البحث الجامعي بكليات الآداب والعلوم الإنسانية بالمغرب في دراسة تاريخ مدينة خنيفرة وأحوازها (1963-2024)”، استعرض من خلالها المتدخل حصيلة الإنتاج العلمي المرتبط بالمدينة، مبرزا غنى الأبحاث الجامعية وتنوعها من حيث الرؤى والمقاربات، حيث شملت مجالات متعددة كالتاريخ الاجتماعي، والمقاومة، والحياة الاقتصادية والثقافية لقبائل زيان، وتوقف عند أبرز الكتابات التاريخية التي أرخت لمقاومة المنطقة وساكنتها، مشيرا إلى أهمية هذه الأبحاث في توثيق الذاكرة المحلية، كما دعا إلى فتح آفاق جديدة للبحث الجامعي في هذا المجال.
في إطار نفس الندوة، قدّم د. حوسى أزارو مداخلة بعنوان “البناء الثقافي للمجال بحاضرة خنيفرة بين مفعولات التاريخ والممارسات السوسيومجالية للساكنة”، ساعيا من خلالها إلى تفكيك مسار تشكل المجال الحضري بالمدينة، واستجلاء دور البعد الثقافي في صياغة ملامح التحضر، منطلقا من أسئلة جوهرية حول معنى التحضر وأبعاده، وتحوله من القرية إلى المدينة، ومن النمط العسكري إلى النمط الإداري، ومن الخيمة إلى السكن المنظم، فيما أثار خلفيات الكتابات التاريخية الأبحاث المنجزة حول المقاومة، وتطرق إلى التهيئة الحضرية، والهجرات، وظاهرة البناء العشوائي، والتناقض بين المدينة الهشة والمدينة المنظمة لفهم ديناميات التحول المجالي والاجتماعي بخنيفرة.
من جانبها، ساهمت الطالبة الباحثة خديجة بيطار في أشغال الندوة بمداخلة بعنوان “بعض الثروات اللامادية ومعالم الحضور الرمزي والانتشار الثقافي بخنيفرة”، أبرزت من خلالها الغنى الثقافي والرمزي الذي تزخر به المدينة، رغم ما تعرفه من تحولات وعصرنة، مبرزة تنوع مظاهر هذا التراث في خنيفرة، من حرف تقليدية وتقاليد يدوية إلى زرابي أمازيغية مشحونة بالرموز والدلالات، كما توقّفت عند غزل الصوف وحياكة النسيج والفنون الشعبية، فيما تناولت دلالات الوشم كأقدم تعبير جمالي وهوياتي، والحكاية الأمازيغية كخزان شفاهي، إضافة إلى دور الزوايا والأضرحة والمعتقدات الشعبية، وختمت بالإشارة إلى شخصية موحى وحمو الزياني كرمز للمقاومة.
رئاسة الجلسات، التقارير والاختتام
شهدت الجلسات العلمية الأربع للندوة الوطنية رئاسة كل من الأساتذة المصطفى تودي، مولاي هاشم جرموني، أحمد حميد، وحوسى جبور، بينما أُسندت مهمة إعداد التقارير للأستاذات نوال خلوفي، فدوى أملال، فطومة المنصوري، والأستاذ معتصم حمداوي، الذين ساهموا في توثيق مضامين المداخلات والنقاشات، دون أن يفوت ذ. محمد ياسين اختتام الحدث بالتأكيد على انفتاح المؤسسة على مختلف الكفاءات الوطنية والمحلية، ما يستوجب التسلح بروح الانتماء والمواطنة، فيما أشار إلى أن مدينة خنيفرة تزخر بثروات وإمكانات كبيرة، رغم ما تعترضها من معيقات يمكن تجاوزها بالإرادة الجماعية، معتبرا التوصيات التي خلصت إليها الندوة دعامة أساسية للترافع المؤسساتي والمدني.
توصيات خارطة الطريق
في أعقاب الندوة صدرت مجموعة من التوصيات، منها أساسا التأكيد على ضرورة اضطلاع المجالس المنتخبة بدور محوري في بلورة رؤية عمرانية عادلة، تنطلق من تصميم شمولي للتأهيل الترابي يأخذ بعين الاعتبار التفاوتات المجالية، ويستحضر العدالة الاجتماعية في توزيع المشاريع والخدمات، واعتبر تأهيل الأحياء الهامشية وغير المهيكلة أولوية قصوى، عبر توفير الخدمات الأساسية والبنيات التحتية اللازمة، إلى جانب تهيئة المدينة العتيقة بما يحفظ طابعها المعماري الأصيل، وتطوير الفضاءات العمومية المشتركة لتكون أكثر جاذبية وانسجاما مع المعطيات الإيكولوجية والثقافية والعمرانية للمدينة.
في السياق ذاته، ركزت التوصيات على ضرورة تحسين البنية التحتية وتعزيز الربط المجالي والرقمي بين خنيفرة وباقي الجماعات الترابية، سواء على المستوى الإقليمي أو الجهوي أو الوطني، وتم التأكيد على تحديث نظم النقل الحضري بما يراعي البعد البيئي، وتوفير خدمات عمومية ذات جودة تستجيب لحاجيات الساكنة، وتؤسس لمدينة دامجة، مستدامة ومتضامنة، كما دعت إلى اعتماد تخطيط عمراني تشاركي يراعي الخصوصيات المعمارية والبيئية للمنطقة، ولأن التنمية المستدامة لا تنفصل عن البعد البيئي، فقد شددت التوصيات على أهمية حماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية من غابات وأنهار وجبال.
وبينما دعت إلى تشجيع السياحة البيئية والفلاحة المستدامة باعتبارهما رافعتين اقتصاديتين واعدتين، تم التأكيد على تفعيل التربية البيئية من خلال برامج التعليم والتكوين ومبادرات المجتمع المدني، وعلى مستوى التراث والهوية، تم التأكيد على ضرورة حماية وتثمين التراث المادي واللامادي، خصوصاً الأمازيغي والعرفي، والعمل على رقمنة هذا الموروث الثقافي والمعماري وجعله رافعة للتنمية السياحية والتعليمية، كما دُعي إلى دعم الصناعات الثقافية والفنية والاقتصاد التضامني، وتشجيع الابتكار من خلال إحداث حاضنات محلية للمشاريع، وتعزيز سلاسل الإنتاج المرتبطة بالصناعات التقليدية والمنتجات الفلاحية والزربية الأطلسية، في انسجام مع خصوصيات المدينة.
الحكامة الجيدة والتدبير التشاركي حازا بدورهما موقعاً مركزياً في توصيات الندوة، حيث تم التنبيه إلى أهمية تقوية قدرات الجماعة الترابية في مجالات التخطيط والتتبع والتقييم، مع إشراك فعلي وواسع للمجتمع المدني والساكنة المحلية في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية، كما نُوه بأهمية إبرام شراكات استراتيجية مع الجامعات والمؤسسات الوطنية والدولية، قصد خلق دينامية علمية وتنموية مستدامة، فيما أوصت الندوة بربط التكوين المهني بحاجيات الاقتصاد المحلي، مع ضرورة إحداث نواة جامعية متعددة التخصصات قادرة على استيعاب الطلبة والطالبات من الإقليم والمناطق المجاورة.
وشددت التوصيات بالتالي على أهمية دعم البحث العلمي في مجالات الجغرافيا، الجيولوجيا، الفلاحة، والبيئة، إلى جانب إحداث برامج تربوية ترتبط بالتراث والبيئة الجبلية، بما يعزز الانتماء ويعمق الوعي البيئي والثقافي لدى الأجيال القادمة، وعلى العموم تؤشر هذه التوصيات، مجتمعة، على تحول مفاهيمي في مقاربة التنمية بخنيفرة، نحو تصور شمولي يزاوج بين العدالة المجالية، وتأهيل البنيات، وتثمين الهوية، وتحفيز الاقتصاد المحلي، في أفق بلورة نموذج تنموي متجدد ومتوازن، يجعل من الإنسان محوره ومن المجال رافعة لإقلاع حقيقي يعيد للمدينة مكانتها التاريخية والحضارية.




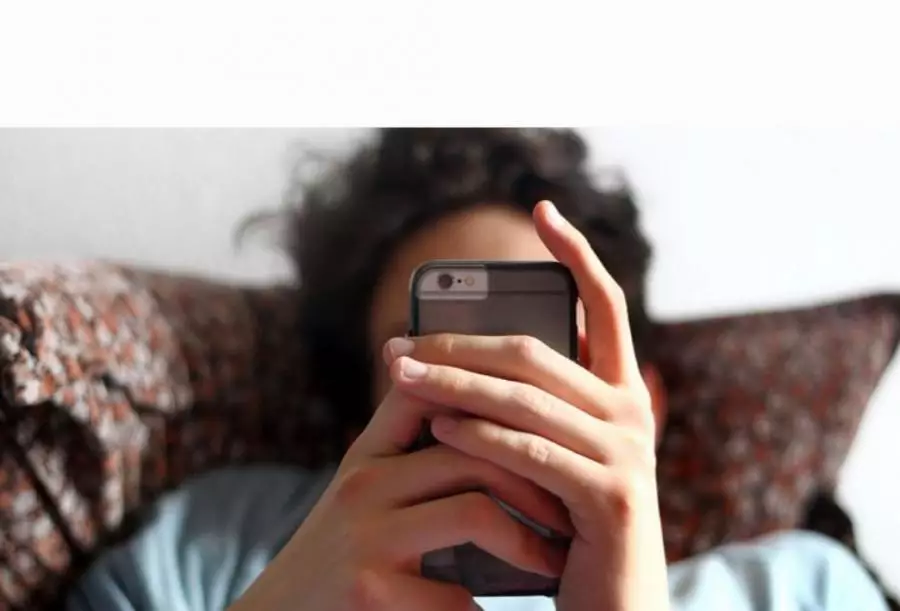







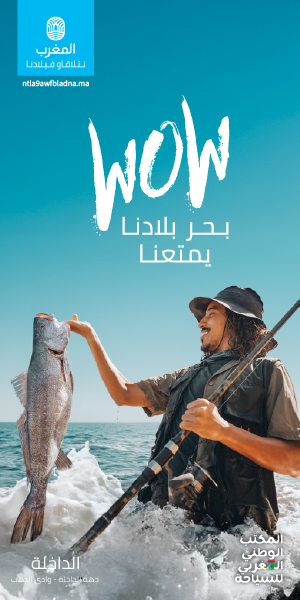
تعليقات
0