أجرى الحوار: محمد عياش (°)
من الصدف المدهشة أن يظل هذا الحوار المفعم بفورة البدايات الواعدة والذي مرّ على إجرائه مع د. محمد أمنصور (°°) ما يقارب ستة وعشرين عاما (أواخر 1992)، طي الكتمان، ولصيقا بي دون أن يتجاوز دائرة الاندساس أو الاعتقال ضمن محتويات أرشيفي المرتحل معي أينما انتقلت …كأن قدر هذا الحوار ألا يحظى بالخروج إلى فضاء النشر الإلكتروني إلا بعد ربع قرن شهدت خلالها تجربة محمد أمنصور الإبداعية والنقدية والتربوية العديد من التطورات…
فبعد أيام قليلة من إجراء الحوار آنئذ، أعدت كتابته بخط يدي وأرسلته إلى إحدى الجرائد الوطنية واسعة الانتشار قصد نشره…داومت أياما عديدة على تتبع كل الأعداد والملاحق عسى أن أعثر على أثر لهذا الحوار في إحدى الصفحات الداخلية أو في الصفحة الأخيرة من الجريدة (لم يكن مطمحي يتجاوز هذا السقف لأن الظفر بمساحة في إحدى صفحات الملحق الثقافي بهذا الحوار أو بغيره كان يشكل فتحا ملحميا مبينا)، لكن دون جدوى ..فما كان مني إلا أن قررت الاحتفاظ به لنفسي دونما تفكير في مصيره القريب والبعيد …
ربما كنت أشعر وأحدس أن هذا الحوار العفوي والصادق والشفاف سيغدو ذا قيمة استثنائية يوما ما، فحرصت على الاعتناء به أشد ما يكون الاعتناء، وعدم التفريط فيه أيا كانت المشوشات والإكراهات والمثبطات…وبالفعل، ما إن خصصت “جمعية الأنصار للثقافة”، بخنيفرة، أحد مهرجاناتها للاحتفاء بتجربة محمد أمنصور حتى تذكرت هذا الحوار، وما يمكن أن يكون له، وأن يحوزه من مزايا توثيقية وتنويرية وتقويمية للتجربة الأدبية عند هذا الباحث الأصيل والكاتب ذي القدر الجليل…
وهكذا، وبدون أي تلكؤ غير مشروع وغير مبرر ، بادرت إلى إخراجه من الأرشيف من أجل تقديمه هدية رمزية مفاجئة لأمنصور عبر إحيائه وتقاسمه أوّلا ، ثم من أجل ترهينه وإدماجه في السياق الاحتفائي بتجربته لفهم بعض الجوانب من رهان وسيرورة الكتابة لديه وهي تترنح بين خفقة البداية وبين انسياب آثارها المخاتلة في ما انتهت إليه رحلة البحث والكتابة عنده من تراكم كمي ونوعي ثانيا …أملي الخالص أن أكون بهذا الصنيع المتواضع قد ساهمت -ولو رمزيا – في إماطة اللثام عن خصوصية التجربة الأدبية في تجلياتها الخصيبة وأبعادها الرحيبة عند الباحث والكاتب محمد أمنصور.
محمد عياش
س : ماذا تعني الكتابة بالنسبة إليك في واقع غامض، ممزق، منمط، استهلاكي، ومليء بالانكسارات والخيبات؟
ج : لنقل :إنها احتجاج أخير في مسلسل الاحتجاجات التي يمارسها المغلوب على أمره طيلة مسيرته الملآى بالأشواك والأسلاك الشائكة، أو لنقل: إنها الصيغة الوحيدة المتبقية لرؤية الجمال أو تخيله، أو إنعاشه في الذات والواقع .ثم لنقل : إنها آخر الثورات التي ينجزها إنسان القرن العشرين لتأكيد أن العالم لا يتغير، وإنما أشكال الموت وحدها تتغير.. وبهذا المعنى ، فإن الكتابة هي أرقى أشكال الموت ؛ لأنك عندما تكتب فأنت تقر بأنك ميّت بكل المعاني : ميت كوجود اجتماعي ، أو ميت كمشروع فيزيقي، أو ميت كفرضيّة تستعصي على التحقق في واقع عنيد .وبين حدّي ماض ومستقبل لا ملامح لهما.
س: ما موقع الكتابة السردية من خارطة الكتابات الأدبية عندك؟، وما ممكناتها لسبر أغوار الكائن ومحيطه واستشراف آفاقهما الشاسعة؟
ج: أعتقد أن السرد هو آخر قلعة لانهيار الأدب في المغرب .وأقول الانهيار لأنني من االذين يعتقدون بأن نهضة ادب الفقهاء في ما قبل هذا القرن كانت أقوى من نهضتنا الحالية !..فرغم انعدام وقلة وسائل الاتصال العصرية من جرائد وإذاعات وتلفزيون …فقد أبدعوا وتواصلوا وأسّسوا مدارس أو ما يشبه المدارس، بينما نحن في زمن الإمكانيات نزدهر – للأسف- أشكال التحايل على الأدب والأدباء، في حين أن الأدب باق على قواعده لا يطير أو يفصح عن ذاته – رغم الضجيج – إلا في ما ندر.
إن المنشور كثير، لكن الحقيقي والقوي والأصيل نادر للغاية، وبهذا المعنى، فإن الكتابة السردية في المغرب بدأت وماتزال تحاول أن تنقذ ما يمكن إنقاذه، وفي هذا المجال فهي تخطو خطوات جادة لكنها متواضعة إذا ما قورنت بمثيلاتها في المشرق (مصر، سوريا، لبنان والعراق…)، غير أنّ هذه النظرة الحذرة لا تمنعنا من الالتفات إلى مشروع التجريب الذي بدأت ملامحه وبذوره تلوح وتورق هنا وهناك.
وفي هذا الصدد ، فقد أنجزت بحثا اكاديميا تحت إشراف الدكتور حسن المنيعي المحترم يحمل عنوان “استراتيجيات التجريب في الرواية المغربية المعاصرة “، واعتقد أن المتتبع لما ينشر قد اطلع على التقرير الذي قدمته أمام الللجنة العلمية، وأعتقد أن النتائج التي توصلت إليها – على تواضعها – تؤشر إلى أن مستقبل الكتابة السردية بالمغرب ( الروائية بالخصوص) سيكون حافلا بالمفاجآت، وهي مؤشرات تثبتها المعطيات التكوينية لسيرورة السرد في المغرب الذي ما يزال في طور التكون، لكن في اتجاه تراكم وتطور نوعي لا يمكن التغاضي عنهما في جميع الأحوال.
س: تجربتك الإبداعية في مجال الكتابة السردية، القصة القصيرة تحديدا، ليست بالقصيرة جدا حيث تقترن ببداية الثمانينيات، وبالتالي، فهي تسمح لك بامتلاك تصور يمكن القول إنه جدير بأن يؤخذ في الاعتبار كشهادة إبداعية، من هذا المنطلق، ما وجهة نظرك في عوائق هذه الكتابة في إطار علاقتها بالمنابر الإعلامية؟
ج :أرى انك تشير هنا من طرف خفي إلى بيان القصة التجريبية الذي نشرته في الصحف الوطنية هذه الأيام ( العلم – الميثاق الوطني – أنوال – الاتحاد الاشتراكي) ، ولن أكرر ما قلته، لكن يهمني أن أؤكد بأن الأمر في المغرب يتعلق ب “اختلاط جيلي”، وأشدّد على هذه الصيغة ….وهو مشكل طرح في مصر، وغيرها من البلاد العربية التي عرفت نهوضا أدبيا منذ بدايات هذا القرن ( القرن 20).
وكلنا يذكر أو يستطيع أن يستذكر ما جسده صلاح عبد الصبور في شعره بخصوص علاقته هو وجيله بجيل الرواد ( العقاد، طه حسين، توفيق الحكيم…)، فهذه القامات الشامخة بقدر ما استطاعت أن تؤسس المشروع الثقافي الوطني في مصر ما لبثت – بعد اكتمال تجاربها – أن تحولت إلى عوائق، ليس بالنسبة إلى نفسها أو بالنسبة للمشروع الثقافي المصري في حد ذاته، بل بالنسبة إلى الجيل الذي جاء بعدها والذي يليه ….
وفي المغرب ،هناك تمويه كبير بخصوص الحدود القائمة بين الأجيال .بل هناك احتقار مبطّن لمنطق التفكير “الجيلي”. والحال إنه منطق موضوعي يفرض نفسه بقوة الأشياء . إنّ قصر التجربة الحداثية في الإبداع القصصي والروائي قد لا يسمح بالحديث عن أجيال. وفي المقابل، هناك إمكانية استخدام معيار العشريّات: جيل السبعينيات، الثمانينيات، التسعينيات… لكن هذا المعيار لا يمكن قبوله على المدى البعيد.
وفي الأحوال كلها ، فإن مفهوم الجيل مفهوم نقدي، فني، زمني، وهو إمكانية نظرية في الوعي بالتيارات والمذاهب التي هي الآن قيد التبلور. وإذا كان عليّ أن أقول شيئا عن تجربتي الإبداعية في مجال الكتابة السردية، فإنني – وبدون تواضع كاذب – أقول : لم أبدأ بعد . وكل ما نشرته من قصص فصيرة طيلة المدة الفاصلة بين غشت 1991 ونهاية 1992، بعد تردد دام عشر سنوات، ليس إلا خطاطات أولية ..وربما كان الرهان الحقيقي عندي يبدأ من تلك اللحظة التي سأنشر فيها روايتي البكر “صهيل تحت الحصار” التي لا أعرف كيف سيكون مآلها في زمن مؤامرات الصمت الكبرى، وفي مقدمتها ما يسميه الصديق الروحي مولانا أحمد المديني “إطلاق نار الصمت” كظاهرة تميز ثقافتنا الوطنية تجاه كل جديد يحبو أو يقتحم !!!
س: تراوح بين الإبداع من خلال كتابة القصة القصيرة، وبين التنظير من خلال نقد الرواية ونقد النقد، أي ّالكفتين أرجح لديك ؟ ولماذا؟
ج: المسألة في الحقيقة بالنسبة إليّ في الجوهر هي مسألة تمثّل في المرحلة الأولى، ثم مرحلة العطاء والمساهمة في حدود الإمكان في المراحل اللاحقة، فقد بدأت بمحاولات متواضعة لفهم واستيعاب الكائن /الموجود، أي معرفة مرتكزات ومكونات ما أسميه دائما ب “مؤسسة الأدب” بالمغرب، وهي مؤسسة قيد التكوّن. وبهذا المعنى، حاولت من خلال نقد النقد أن أستوعب المتن الإبداعي السّبعيني من خلال مباشرة نصوصه، ومن خلال الوعي النقدي الذي واكبه، أي إنه كان استيعابا مزدوجا للوعي الأدبي والنقدي لمرحلة تأسيسية مهمة من تاريخ الثقافة الوطنية.
من هنا كان ما تسميه أنت بنوع من المغالاة “نقد النقد”. وفي أثناء ذلك، كان الهوس الدائم بالسرد، بالرواية والقصة القصيرة، أو لنقل بالحكي عموما، أما بخصوص: كيف أزاوج بين الإبداع والتنظير؟، فأعتقد أن هذا التقليد في المغرب صار الآن متداولا ومشروعا. وربما كان السبب فيه أنّ الأرضيات التي تنهض عليها “مؤسسة الأدب” لم تنجز بعد بالشكل الذي يطمئن فيه المبدع أو الناقد أو الباحث الأكاديمي إلى مجال واحد ومحدد دون غيره .
إننا ما نزال نؤسس كل شيء .وحصاد الموت، موت الأجيال الرائدة لم يبدأ بعد (أطال الله في عمر الجميع). وإذن، فإن الأوراق ماتزال شبه مختلطة، لهذا فإن كل واحد يحاول – الآن – أن يسمّي تجربته. والتسمية تتخذ صيغ بحوث أكاديمية أو بيانات تنظيرية …وهذا ليس عيبا، لكنها مرحلة تؤشر إلى المخاض الكبير الذي تعرفه ولادات المؤسسة الأدبية بالمغرب، إنه إذا كان لي يوما أن أختار “جبهة ” ثقافية وحيدة للكتابة فإنها ستكون بدون تردد “الحكي بوجهيه: القصة القصيرة والرواية”.
ففي البدء كان الحكي، وفي النهاية لا يبقى سوى الحكي، فهو الذاكرة، وهو اللاشعور، وهو الغضب، وهو الفعل، وهو تجميع عناصر العالم، وهو متعة أن نعيش أو نحيا، وهو كيف نرى، ومن أين، ومتى؟؟، وهو ماذا نرى، وماذا يعلق بذاكرتنا؟، وهو كيف نتكلم، وماذا علينا أن نقول؟ وهو السفر، وترتيب علاقاتنا الغامضة مع الآخرين والمؤسسات والأفكار وكل ثغراتنا في العالم، إنه، باختصار “إله الأجناس الأدبية”، وقلب نظرية الأدب، هذا إذا تمادينا في تكريس نرجسيّة متخيلنا مع التغاضي عن وقع مثل هذا الكلام على من يعبد آلهة أخرى …
س : “أدب الشباب” تسمية تثير جدلا صاخبا، بما لها من هموم مطامح، وما عليها من مؤاخذات وانتقادات في شبه غياب اهتمام ملموس وفعال برصد هذه التجربة من طرف من ينتظر منهم أداء هذا الدور/ الواجب الثقافي …ما موقفك الخاص من واقع هذه التجربة أولا؟ وكيف يمكن الخروج من هذا المأزق ثانيا؟
ج : أعتقد أن هذه التسمية غير دقيقة رغم أن المبدع يضطر إلى تبنيها لأنها لا تنطوي على حمولة اصطلاحية، أو مدلول نقدي وجمالي بعينه، فهي تحتكم إلى عمر الكاتب الفعلي = شاب !!، بينما في وعينا النقدي الحالي نقول – جميعا – وفي شبه تواطؤ جماعي بموت المؤلّف .. فكيف – إذن – يكون النص الذي يبدعه مؤلف شاب لا يعرّف إلاّ بعمر صاحبه؟!، هذه مفارقة تثير غير قليل من السخرية. إن النص نص، والأدب أدب، والأصيل أصيل كما أن الزائف زائف ..ولو يخرج النقد المغربي من / عن الوباء الذي يشلّ حركيّته، وأعني به “سياسة الإفلاس الأخلاقي” فإن القوة الإبداعية – مع الاعتذار لمناهضي الميتافيزيقا عن صيغة الإبداع …- ستكون هي المعيار الوحيد للحكم.
فالنص الجيد يبقى نصا جيّدا وأصيلا وحقيقيا سواء أكتبه طفل أم شيخ أم شابّ. وأقول : “سياسة الإفلاس الأخلاقي” لأنني أعزو غياب ما سمّيته بالاهتمام الملموس والفعال برصيد التجارب الجديدة إلى هيمنة الروح اللاأخلاقية في أوساط أدبائنا ونقادنا، وهذا ما يجعل الكتابة النقدية لا تحتكم إلى النصوص رغم الادعاءات المتكررة حول مسألة (موت المؤلف)، أو ما يسمى حاليا في الغرب ب “نظرية لا مرجعية المؤلف” في مقابل “‘الاستقلال الدلالي للنص”.. بل تحتكم إلى مختلف أشكال الزبونية، وتكتيكات بورصة قيم المقاهي التي صارت تطبخ أحكامنا النقدية بين حدي القهوة السوداء وألسنة وآذان السجائر النميمية !!!
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، هناك غياب ممارسة دقيقة لمفهوم “المقالة الأدبية” في كتابات نقادنا، المقالة كفنّ وكجنس خطابي قائم بذاته، مما يرسخ تشوّشا في علاقة النقد بالأدب، فالدراسة “شبه الأكاديمية” صارت تغزو بقواعدها وهواجسها المرجعية جنس المقالة الأدبية مما ولد كتابة “نقدية هجينة ” سِمتها المركزية “اللاّمقروئية”. وكل هذا صار يحدث في الصحف السيارة بملاحقها وأبوابها اليومية، والنتيجة “نقد مُؤكدم” و”عجمة اصطلاحية” و”إرهاب جديد” يوجه سهام (التجهيل) إلى نحر الكتاب المبدعين أنفسهم .
فالمبدع الذي لم يتخرج من الجامعة لم يعد ممكنا له أن يفهم ما يكتب عنه من نقد مؤكدَم !!! هذه فضيحة وليست حداثة في خطاب النقد المغربي، إنّ هذا الضرب من الخطابات يعزّز العلاقات خارج النصية لأصحابه، ويكرّس مزيدا من العزلة والنخبوية العمياء للمثقفين …إنه يمارس التّعالم، لكنه – وهذا هو المطلوب منه – يصنع “رأيا عاما أدبيا”.. لا يصنع من النص أو الكتاب حدثا .. لا يخاطب متوسّطي الثقافة من الناس …لا يحرّض أحدا على القراءة ..لا يعرّف بالنص نفسه، وإنما يعرّف بعضلات صاحبه الذي يرضى لنفسه أن يكون من المتسابقين في حلبة الملاكمة” المرجعية” ! إنهم ملاكمون من نوع غريب وليسوا نقادا، وإذن، فهو حوار الصم البكم بين الناقد والأديب، وبين المقالة النقدية وبين القارئ ..
والخلاصة لا إمكانية أولا مجال لتبلور “رأي عام أدبي” في المغرب كما هو الحال في مصر ولبنان وفرنسا، في سياق اغتيال ممارسة ( المقالة الأدبية) ، وفي سياق غياب مفهوم الواجب لدى النقاد واستمرارهم في ممارسة – عن وعي – سياسة الإفلاس الأخلاقي !!
والخروج من هذا المأزق يبدأ من إعادة الاعتبار لشخص المؤلف أوّلا، والاعتراف بأسطوريّة كينونته وأبعادها الميتافزيقية في تفاعلها مع بقية الأبعاد، ثم إعادة الاعتبار إلى جنس المقالة الأدبية وتخليصها من رواسب الدراسة الأكاديمية دون إغفال الاحتكام إلى جودة النصوص، وإحياء مفهوم النقد الأدبي التقويمي الذي يراهن على حكم القيمة (هذا جيد وهذا رديء ..هذا صالح وهذا فاسد ..) ثانيا، وكل هذا يتم لصالح البحث الأكاديمي الذي تصان حرمته بعيدا من الاستهلاك العمومي، لأن مآله الصحيح هو الجامعة والكتاب كامتداد لها ..
وبدون العمل الدؤوب على تدقيق الحدود بين هذه العناصر، وبدون تجاوز الحسابات التقليدية بين “الكبار” وبين “الصغار”، وبدون التطلع الجماعي إلى خدمة مؤسسة الأدب المغربية من موقع الفعل الموضوعي ، فلا ثمار نوعية ستبقى لنا بعد عام ألفين من كل ضجيج وغبار هذه الأيام …إن المشكل لم يعد في التراكم ..هذه أكذوبة …المشكل في الكيف والنوعية ..ومن يريد أن يراكم فليفعل ذلك ضمن دائرة الجيّد والنوعي ؛ لأن الوقت غير الوقت، والكل بدأ يفهم .
س: هل يمكننا الحديث عن وجود ملامح تجريبية في كتابات الأدباء الشباب التي تعرف طريقها إلى النشر في السنوات الأخيرة؟
ج: بدون شك …إنها تفزع النقاد ذوي المراجع الجاهزة !! وإذ يعجزون عن مقاربتها فهم يوهمون بأنهم يتجاهلونها أو لا يعترفون بها، والحال أن التجديد وتثوير الخطاب الأدبي والطلائعية وغير ذلك من الشعارات تجد مسكنها ومنبعها في رحم تلك الكتابات الشاردة هنا وهناك، في منابر الإعلام الثقافية الوطنية ..وإذا كان لي أن أختزل عنوان مَن وما يكتبه من يسمون بالأدباء الشباب فإنني سأقول : إنه القول الفصل لأباطرة العطالة، أسياد الزمن المغربي الجديد ..زمن التيه والسؤال في كل اتجاه ..فهل من منكِر جديد؟؟؟.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

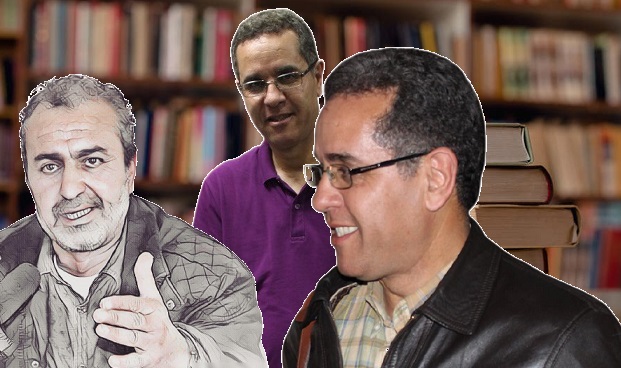


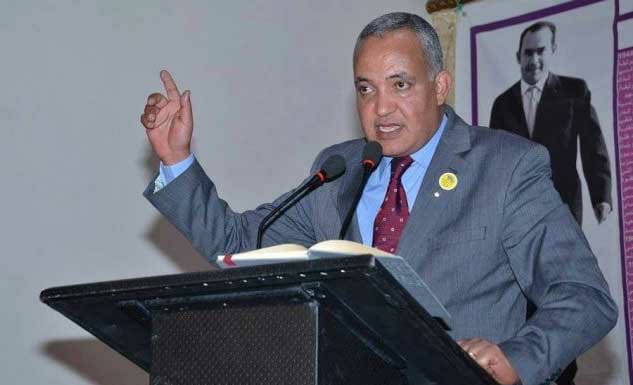


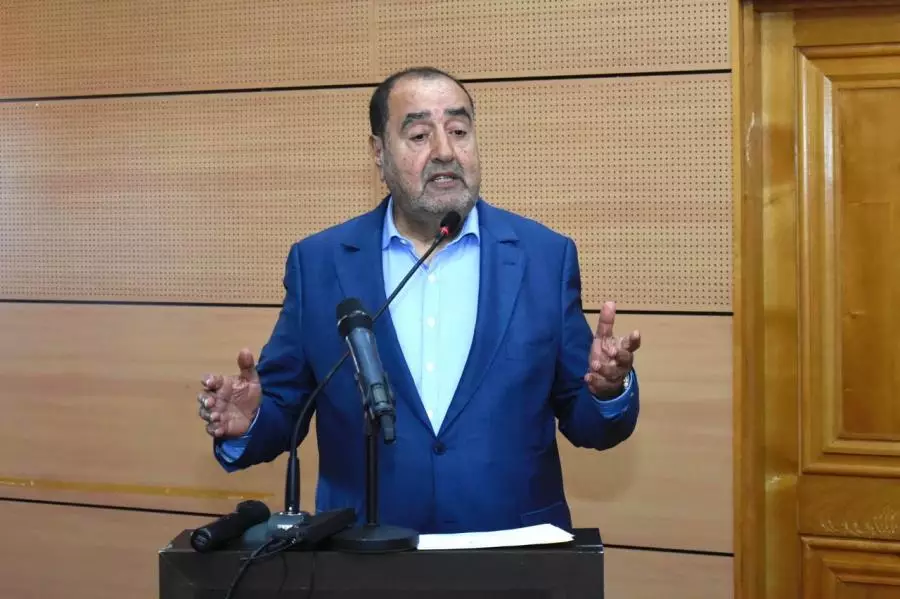




تعليقات
0