الغنبوري والقرقري يطرحان رؤية متكاملة لتحويل المحيط الأطلسي إلى رافعة للتنمية والاستقرار في إفريقيا
في سياق دولي متغير، وفي ظل تنامي الحاجة إلى نماذج تعاون بديلة داخل القارة الإفريقية، تطرح دراسة صادرة عن مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، بعنوان “المبادرة الأطلسية المغربية: فرص اقتصادية وتحولات جيواستراتيجية”، رؤية استراتيجية شاملة، تهدف إلى تحويل المحيط الأطلسي إلى فضاء للتنمية المشتركة والاستقرار الإقليمي، وذلك من خلال مبادرة أطلقها الملك محمد السادس، وتتبناها المملكة المغربية كإطار جديد للتعاون جنوب–جنوب.
الدراسة، التي أنجزها الباحثان علي الغنبوري ومشيج القرقري، تفكك أبعاد المبادرة وتفاصيلها، وتعتبرها أكثر من مجرد مقترح سياسي أو تحالف اقتصادي، بل تصور مهيكل لإعادة هندسة العلاقات الإفريقية البينية، وتنشيط التكامل القاري عبر واجهة الأطلسي، بما يضمن اندماجًا فعّالًا للدول الساحلية وغير الساحلية على حد سواء، وهي تقدم تحليلًا رصينًا لفرصة تاريخية أمام القارة الإفريقية لإعادة تشكيل موقعها في النظام العالمي، عبر مبادرة تقودها الرباط، وتقوم على مبادئ التكامل الإقليمي، السيادة الاقتصادية، والشراكة الجماعية. إنها خارطة طريق لنهضة إفريقية جديدة تبدأ من الأطلسي.
رؤية جيوسياسية شاملة
ترى الدراسة أن المحيط الأطلسي الإفريقي ظل لسنوات فضاء مهمّشًا في السياسات العمومية، رغم غناه الطبيعي والجغرافي والديمغرافي. غير أن التحديات الجديدة التي تواجه إفريقيا – من صراعات إقليمية، واختلالات سلاسل الإمداد، وأزمات الطاقة والغذاء – تستدعي نموذجًا جديدًا للتعاون، يكون قائمًا على التكامل لا التنافس، والتضامن لا الوصاية.
وتسعى المبادرة إلى تجاوز منطق التكتلات التقليدية، عبر بناء شبكات موانئ وممرات تنموية جديدة، تربط دول غرب إفريقيا والساحل بالمحيط الأطلسي، ما يتيح لها الولوج إلى الأسواق العالمية، وتقليص تبعيتها للمعابر القديمة التي أضحت مهددة أمنياً ومكلفة لوجستيًا.
الثروات موجودة… ولكنها غير مفعّلة
تُبرز الدراسة أن الفضاء الأطلسي الإفريقي يزخر بإمكانات اقتصادية هائلة، تشمل:
-
احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي (نيجيريا، موريتانيا، السنغال)،
-
معادن حيوية مثل البوكسيت والفوسفاط والتيتانيوم،
-
طاقات متجددة متوفرة على مدار العام،
-
أسواق سكانية يتجاوز حجمها 700 مليون نسمة.
لكن المفارقة، بحسب الباحثين، تكمن في ضعف استغلال هذه الموارد، بسبب غياب بنى تحتية متكاملة، واعتماد شبه كلي على تصدير المواد الخام، ما يحد من قدرة هذه الدول على خلق سلاسل إنتاج محلية ورفع القيمة المضافة.
المغرب كقاطرة
تسلط الدراسة الضوء على دور المغرب كمحرك رئيسي للمبادرة، بفضل جاهزيته اللوجستية والمؤسساتية، وتجربته في التعاون جنوب–جنوب. وتمثل مشاريع مثل ميناء طنجة المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي، وخط أنبوب الغاز مع نيجيريا، واستثمارات الفوسفاط والأسمدة في غرب إفريقيا، نماذج ملموسة لهذه الرؤية.
كما يشكّل الاستقرار السياسي للمملكة، ونهجها في نقل التجربة التنموية إلى شركائها الأفارقة، أحد العوامل الحاسمة في بناء ثقة إقليمية متنامية حول دور المغرب الوسيط والمحفّز للاندماج الأطلسي.
موانئ وممرات تكاملية
تعتبر الدراسة أن البنية المينائية هي الدعامة المادية للمبادرة. وتتناول بالتفصيل محاور الربط التالية:
-
المغرب: من طنجة إلى الداخلة، شبكة موانئ عصرية ولوجستية.
-
موريتانيا: نواكشوط ونواذيبو كممرات ربط شمال-غرب القارة.
-
المحور البحري داكار – لاغوس – لواندا – والفيس باي: كخط أطلسي رئيسي بين غرب وجنوب إفريقيا.
وترى الدراسة أن الربط البحري ليس فقط أداة للنقل، بل محور لتوحيد الأسواق، وتحفيز الصناعات التحويلية، وجذب الاستثمارات، وبناء سلاسل إنتاج مشترك.
دول الساحل: شراكة لا وصاية
تشدد الورقة على أن المبادرة تولي أهمية خاصة لدول الساحل، التي تعاني من هشاشة جيو-اقتصادية نتيجة غياب المنافذ البحرية، إذ تمثل المبادرة بالنسبة لها فرصة لـ:
-
كسر العزلة الجغرافية،
-
تحسين القدرة التصديرية،
-
خفض كلفة التوريد والاستيراد،
-
التحرر من تحكم بعض المعابر التقليدية غير الآمنة.
وتقترح المبادرة إنشاء ممرات تربط هذه الدول مباشرة بالموانئ الأطلسية المغربية، ما من شأنه خلق أثر مضاعف تنموي وأمني في الوقت نفسه.
التوصيات: من المبادرة إلى المؤسسات
في ختام الدراسة، يدعو الباحثان إلى ضرورة:
-
دعم البنيات التحتية العابرة للحدود،
-
إنشاء هيئات أطلسية إقليمية لمواكبة التنسيق،
-
تأمين التمويل عبر شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية،
-
تعزيز إشراك المجتمع المدني والأطر التقنية المحلية.
كما يؤكدان أن نجاح هذه المبادرة يتطلب إرادة سياسية قوية، وأدوات تنفيذ مرنة، وآليات تتبع دقيقة، حتى لا تلقى المصير ذاته الذي عرفته بعض مشاريع التكامل الإفريقي السابقة.












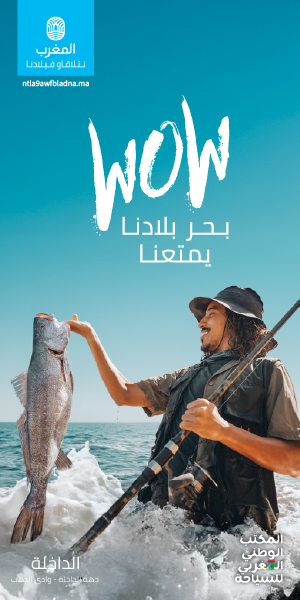
تعليقات
0